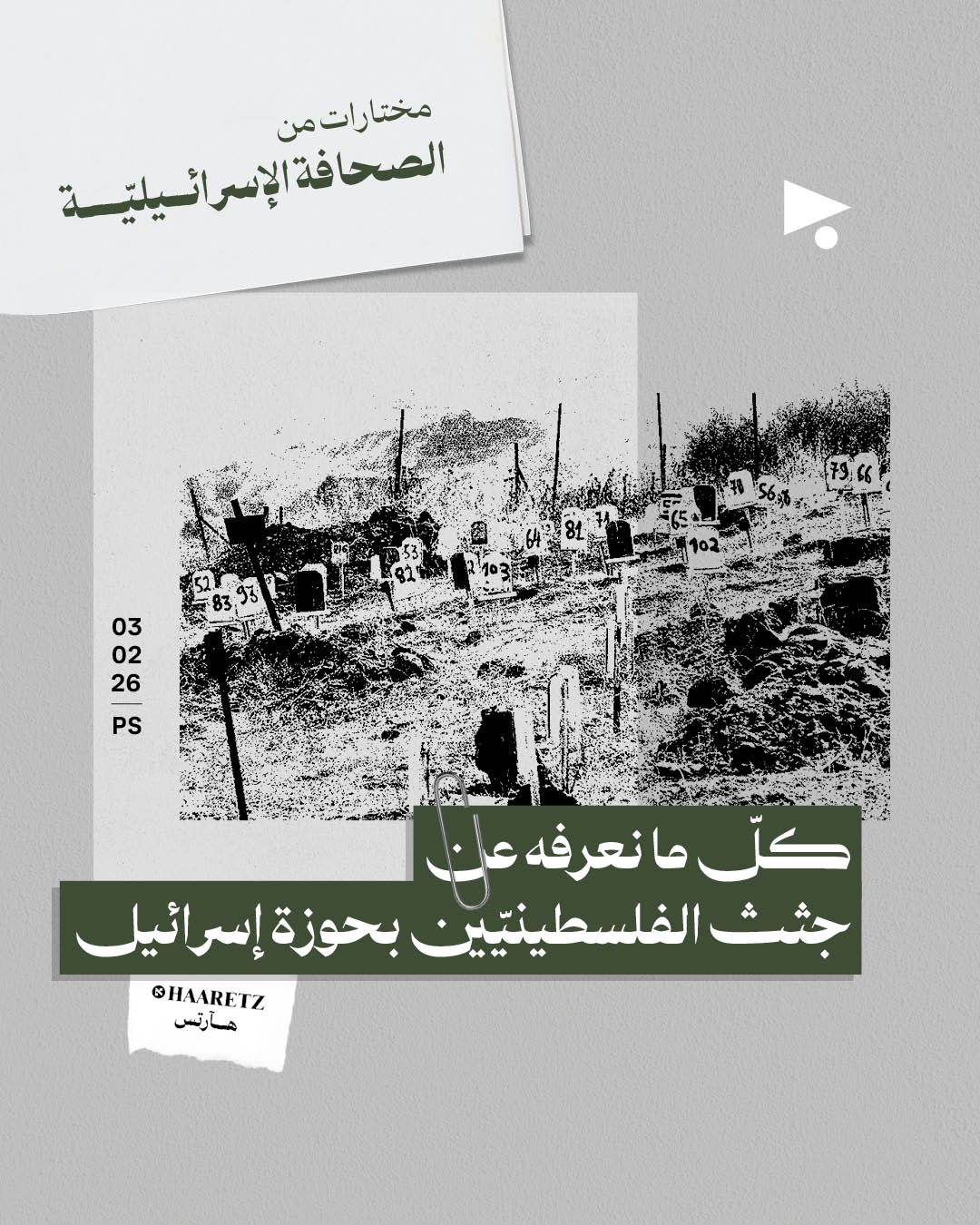يمكن أن نكتب عن…
يمكن أن نكتب اليوم، كمعنيّين وباحثين في الشأن السوري، عمّا ينتظر سوريا في المقبل من الأيام والسنوات من تحدّيات ومن تعامل مع مسائل وألغام خلّفها النظام الأسدي البائد. ويمكن أن نحافظ على حذر المراقبة ومسافة النقد اللازم تجاه كل تطوّر قد يحصل أو كل إجراء قد تتّخذه السلطات الجديدة في دمشق.
ويمكن أن نخوض في أفكار حول سُبل التعامل مع «المسألة الكردية» ومخاطر الاشتباك المُحتمل في الشمال الشرقي لسوريا، وأن نفكّر بشكل النظام الجديد ودستوره وحدود لامركزيّته الضرورية لإدارة التنوّع والتعدّد وبعض مؤدّياتهما الترابية.
ويمكن أن نتحدّث عن أهمية العمل لرفع العقوبات الأميركية والأوروبية على الدولة السورية وإنهاء آثارها والشروع في ورش إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، وعن حلّ مشاكل الملكية الخاصة والعامة داخل سوريا بعد اختلاسات النظام المخلوع وممارساته وما تخلّلها من سطو ومصادرة وإتلاف مستندات.
ويمكن كذلك أن نقدّم بعض الخلاصات من تجارب مختلفة حصلت في العالم (من إسبانيا والبرتغال الى تشيلي فبولندا وتشيكيا وغيرها) وأفضت الى إعادة بناء جيش وأجهزة أمنية وفق قوانين جديدة تضعها بأُمرة السلطة السياسية وتحت مجهر المحاسبة، بالتوازي مع إعادة تأسيس القضاء ومؤسساته والتعامل مع قضايا العدالة الانتقالية الشائكة والصعبة، بما قد يفيد التجربة السورية المُرتقبة.
ويمكن أيضاً أن نكتب عن سبل تفكيك لغم الطائفية ومقاربة «المسألة العلوية» التي خلقها النظام ووظّفها على مدى نصف قرن لتكريس تنابذ وخوف واستثارة عصبيّات، من دون مسلك التشفّي والانتقام ولغة التعميم من جهة، ومن دون المكابرة ونفي المخاوف والوقائع من جهة ثانية.
ويمكن أن نبحث أخيراً في التحدّي الكبير الذي تفرضه الحدود والسيادة عليها ومثلها إعادة بناء علاقات سوريا مع محيطها العراقي والأردني والتركي واللبناني، وتسهيل عودة اللاجئين الراغبين بذلك، وأن نشير إلى ضرورة بَلوَرَة دبلوماسية نشطة تواجه التعدّيات الإسرائيلية المتواصلة وتُعيد وضع الجولان المحتلّ في قلب المفاوضات الإقليمية والدولية المقبلة.
لكن لن يغيّر مِن فرحنا…
لكن كلّ ما سبق وكلّ ما يمكن أن يُضاف إليه لا يغيّر في أنه من حقّنا، وبمعزل عن أي اعتبار أو قلق أو سؤال، أن نكتفي منذ الثامن من كانون الأول 2024 بمشاركة السوريين والسوريات فرحهم، وأن نتمنّى أن يدوم هذا الفرح لأطول فترة ممكنة، فتطول معه التجمّعات واللقاءات والاحتفالات بسقوط واحد من أقبح الأنظمة التي عرفها التاريخ الحديث وأكثرها توحّشاً وجبناً وفساداً.
والحقّ أن كثرة منّا لم يختبروا في حياتهم هذا المقدار من الفرح ولم يعرفوا قبل فرار القتَلة من «قصر المهاجرين» هذا الكمّ من الانفعالات التي لم تتوقّف بعد، والتي سيتطلّب فهمها و«هضمها» تحليلاً يبدو أنها ما زالت عصية على قواعده أو هاربة من تصنيفاته المستندة إلى تجارب فرح سابقة أقلّ كثافة وأقلّ وقعاً علينا أفراداً وجماعات.
ولعلّنا فوق ذلك لم نعتد «الانتصارات» الجماعية في حياتنا ولم نعرف سابقاً ما تولّده من مشاعر. فطرد إسرائيل من جنوب لبنان العام 2000 لم تكتمل مفاعيله السياسية وظلّ ناقصاً. وطرد النظام السوري من بيروت العام 2005 تلته على الفور أبشع موجة اغتيالات وانقسامات لبنانية.
أما اليوم، فنحن نقف أمام انتصار لن يعدّل من كونه حاسماً أي إخفاق أو صراع لاحق. فالأسدية التي قتلت خلال نصف قرن ما قد يزيد على المليون إنسان، والتي سجنت وعذّبت مئات الألوف وشردّت الملايين ودمّرت مدناً وبلدات ومخيّمات لاجئين فلسطينيين في سوريا ولبنان، ودمّرت معها السياسة والحقّ في التعبير، سقطت إلى الأبد وتحطّمت كما تحطّمت تماثيل رئيسها ووالده المؤسّس واحترق معها قبر الأخير وسطوته وهالته التي بُنيت بالتخويف والابتزاز والقتل والتهجير.
النصر على الأسدية إذاً نهائيّ. ورغم صعوبة طيّ صفحة الماضي قبل معرفة مصير أكثر من مئة ألف مفقود ومفقودة وقبل الكشف عن المقابر الجماعية وتحويل جميع السجون وفروع المخابرات وأقبية الاعتقال والتعذيب إلى ما يُشبه المتاحف أو المزارات، إلا أن الفرح بهزيمتها واندثارها، فوق أنقاض ما ابتنته من مؤسسات قمع وجدران خوف، سيظلّ مخيّماً على يومياتنا وعلى أحاديثنا وصورنا وأغانينا لفترة طويلة.
وحتى ولَو أعادتنا حرب الإبادة المستمرة في غزة الى واقع فيه من بشاعة الشرّ ما لا يُحتمل، إلا أن فرحة العمر التي غمرتنا قبل نهاية هذه السنة ستظلّ تستحقّ الاحتفال بها والدفاع عن حقّنا بالاكتفاء بها اليوم وغداً وكلّ يوم.