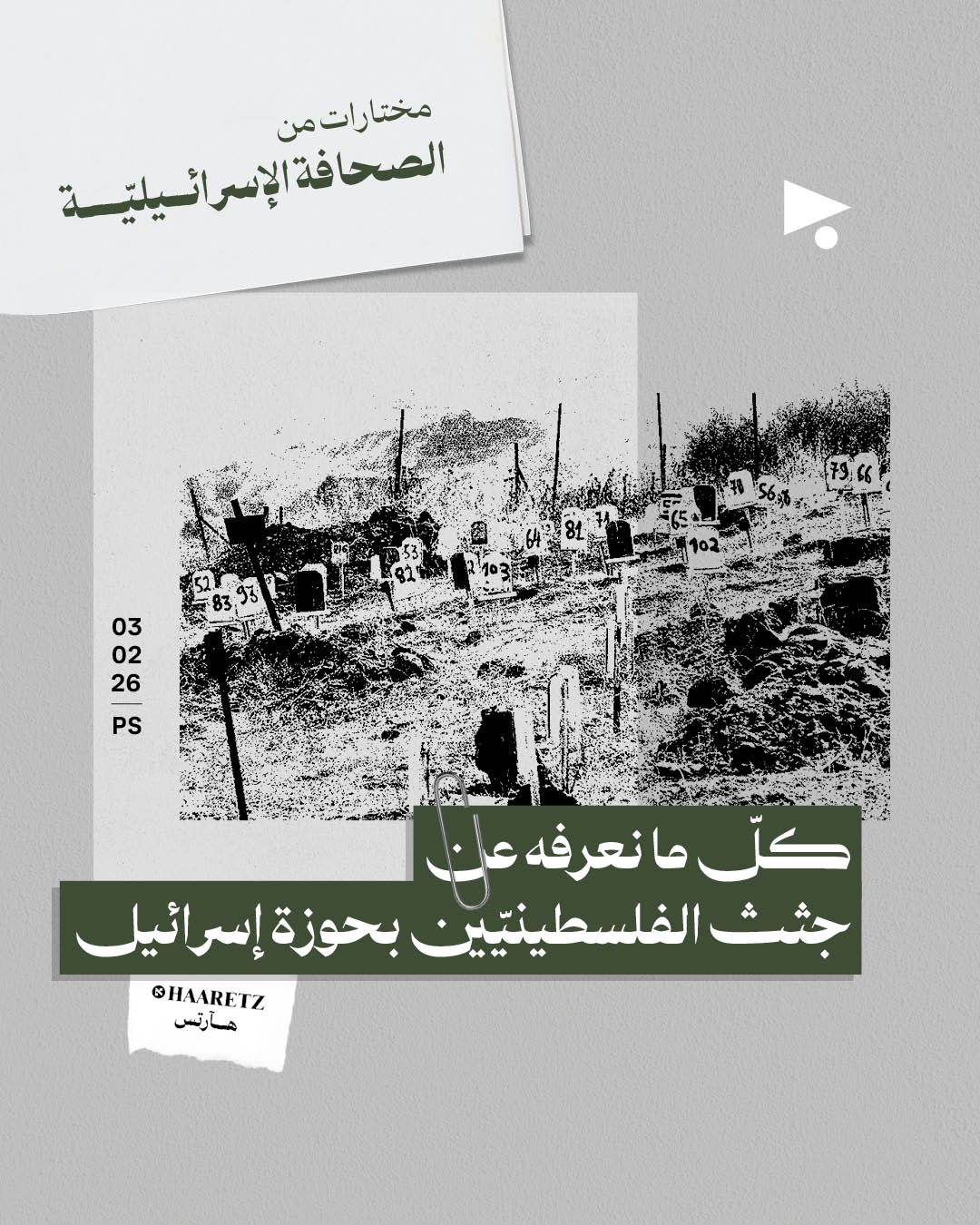سؤال الـ1975
…سؤال رافقني منذ أولى مراحل تشكّل وعيي السياسي، ولم يغادرني. استذكرته يوم 14 تشرين كمُشاهد عاجز لجولات القتال في الطيّونة، قتال عاد بي، كما بكثيرين غيري، إلى الـ1975.
فَرَض السؤال نفسه عليّ منذ طفولتي، بسبب إرث عائلي معقّد ومتناقض، تتداخل فيه روايات ومظلوميات متصارعة، لا تسمح تناقضاتها بحسم الموقف خلال حربٍ أهلية. فالحرب تحتاج إلى «وضوح» سياسي، يبسّط الأمور ويسطّحها، كمدخل لاتّخاذ موقف. وهذا ما لم يكن سهلًا في ظلّ هذا الإرث المعقّد والمتناقض.
ازداد السؤال تعقيدًا مع مرور الزمن. فمع إدراكي التدريجي لإشكاليات سياسية واجتماعية وأخلاقيّة تفرضها مسألة الحرب، باتت مسألة اتّخاذ الموقف مسألة معقدة، وإن كانت ضرورية أحياناً. ولعلّ أحد أسباب صعوبة حسم المواقف هو أنّنا ندرك تمامًا كيف تنتهي القصّة. فبعد الـ1975، كان هناك عقدان من حربٍ ما زلنا ندفع ثمنها.
لم يبقَ سؤال الـ1975 سؤالًا افتراضّياً، سؤالاً عمّا كنتُ لأفعله حينها. بات السؤال يتجدّد مع مرور الزمن بأشكال مختلفة وسياقات جديدة، لا تشبه سياق الـ1975، ولكن تتشارك معه بعوامل الدم والخوف والخطر الداهم.
بدَوْنا محكومين بهذا السؤال، سواء كنّا في الـ1975 أو بعدها، محكومين بنظام الحرب الدائم.
الحركة الاحتجاجيّة ونظام الابتزاز
ربّما شكّل انخراطي في الحركة الاعتراضيّة منذ الـ2011 محاولة لتوسيع الأجوبة المحتملة على هذا السؤال. فكنّا نصارع ونقاوم لنفرض واقعًا يسمح بمُمكنٍ سياسيّ آخر، واقعاً يخرج عن ثنائيات الحرب الدائمة، ويرفض القراءات الحتميّة لمجتمعنا وانقساماته كمجتمع محكوم بحتمية العنف.
كنّا نصارع من أجل واقعٍ يتيح لنا أن نكون أكثر من مشاهدين في مجتمعنا.
نجحت الحركة الاعتراضية، خاصة بعد ثورة تشرين، في فرض قراءة لنظام الحرب كنظام ابتزاز دائم، نظام يخيّرنا بين العدالة والأمن ويسلب منّا الاثنين معًا، نظام يطالبنا بالولاء المطلق مقابل حمايتنا الجسديّة ويعيّشنا في هشاشة دائمة، نظام يرفض الإصلاح بمنطق الأولويّات حتى يصل بنا إلى الانهيار الكامل.
انتصر هذا الخطاب في لحظة 17 تشرين، لكنّه لم يستطع خرق واقع الابتزاز الذي فرضه النظام. وبعد عامين على الانتفاضة، أتت معركة الطيونة لتذكّرنا بقساوة واقعنا: عندما يبدأ القتال، نصبح جميعاً مشاهدين.
المنفى أو الجبهة
عاد السؤال: شو منعمل لما يبلّش القتل؟
ربّما كان هناك جواب سياسي، لكنّه معقّد ويحتاج إلى مراجعة نظرية واستراتيجية وتكتيكيّة بين قوى الاعتراض للخروج من هذا المأزق. فلا يمكننا تجاهل ما حصل واعتباره مجرّد تجلٍّ طبيعي لنظام الحرب والطوائف، مكتفين بخطاب الدولة العلمانيّة والصراع الطبقي. كما لا يمكننا الاستسلام لمنطق الطوائف والكانتونات والسلاح، كواقع حتمي لمجتمعنا. وبالتأكيد، لا يمكننا تسليم أمرنا لأيّ طرف بحجّة أنّ الطرف الآخر أكثر خطورة.
قد يكون المستوى السياسي هو الأسهل. فالمسألة أكثر تعقيدًا على المستوى الشخصي:
هل أستسلمُ لموقع المُشاهد، القابع في الكوريدور أو الملجأ أو المنفى؟ هل عجزي عن حمل السلاح يخرجني حتميًّا من أي صراع ويفرض عليّ موقع المراقب أو المحلّل؟ ومَن يستمع لمراقب بات يتمتّع بأمان نسبي، جراء امتيازاته، أمان يتيح له بلورة المواقف المدوزنة والمدروسة، فيما غيره يقدّم روحه؟ هل أصبحتُ منافقًا، يريد أن يقوم الآخرون بالـ«شغل الوسخ» فيما أتغنّى بطهارة موقفي من أمان غربتي؟ أو بات البديل واقعية دموية تنصاع إلى «متطلبات المعركة» وتمجّد العمل المسلّح دون أي اعتبار أو مراجعة؟
تمزج هذه الأسئلة بين السياسي والشخصي، ولا يبقى مكان لنا، إلّا كمراقبين خارجين عن مجتمعنا أو مهلّلين للقتل الدائم. وقد يكون الخروج منها هو من خلال رفض هذا الابتزاز الضمني الذي تفترضه هذه الأسئلة، خروج أقرب لصراع يومي بعدم السماح للواقعيّة السياسيّة بأن تقودنا إلى منطق البربرية، مهما اشتدّ القهر. هو صراع لرسم خريطة جديدة لمجتمعنا تتمحور حول مركزية الضحايا، كل الضحايا، بدل قدرنا القائم على تسلسل الحروب وقوانين العفو الدائمة.
لكنّنا لسنا في الـ1975
…رغم رمزية اشتعال خط التماس القديم، وظهور المسلّحين الملثّمين، ورعب تلامذة المدارس المحاصرين، وأصوات الرصاص التي لم تتوقّف.
فرغم رغبة البعض بإرجاعنا إلى هذا التاريخ وتحويلنا مجرّد مشاهدين محاصرين في منازلنا، ما زلنا نستطيع رفض هذا الواقع، وأقطاب نظام الحرب هم أيضًا في مأزق. فمن جهة، تبدو مقاربتهم المسطّحة للمجتمع كتجمّع من الطوائف المتصارعة، وما يعنيه ذلك من ابتزاز «الأمن والخدمات مقابل الولاء»، مقاربةً غير كافية. ومن جهة أخرى، جاء الانهيار لكي يوحّد الواقع المادي على ضفّتي خطوط التماس، والانفجار ليوحّد دماء أهل المدنية، والثورة لكي تقدّم نبذة عن شعب مخفيّ تحت الطوائف، شعب موحّد بكونه ضحية هذا النظام.
فنحن لسنا بالـ1975، وربّما لهذا، قرّر القيّمون إرجاعنا إلى هذا التاريخ بالقوة.
كوننا لسنا بالـ 1975 ، ما زال لدينا خيار رفض هذه العودة، خيار يبدأ بعدم الرضوخ لابتزازهم ويستمرّ بالكفاح من أجل توسيع المساحة السياسيّة التي بدأت تتبلور في 17 تشرين، مساحة تتيح لنا أن نكون أكثر من مشاهدين في مجتمعنا.