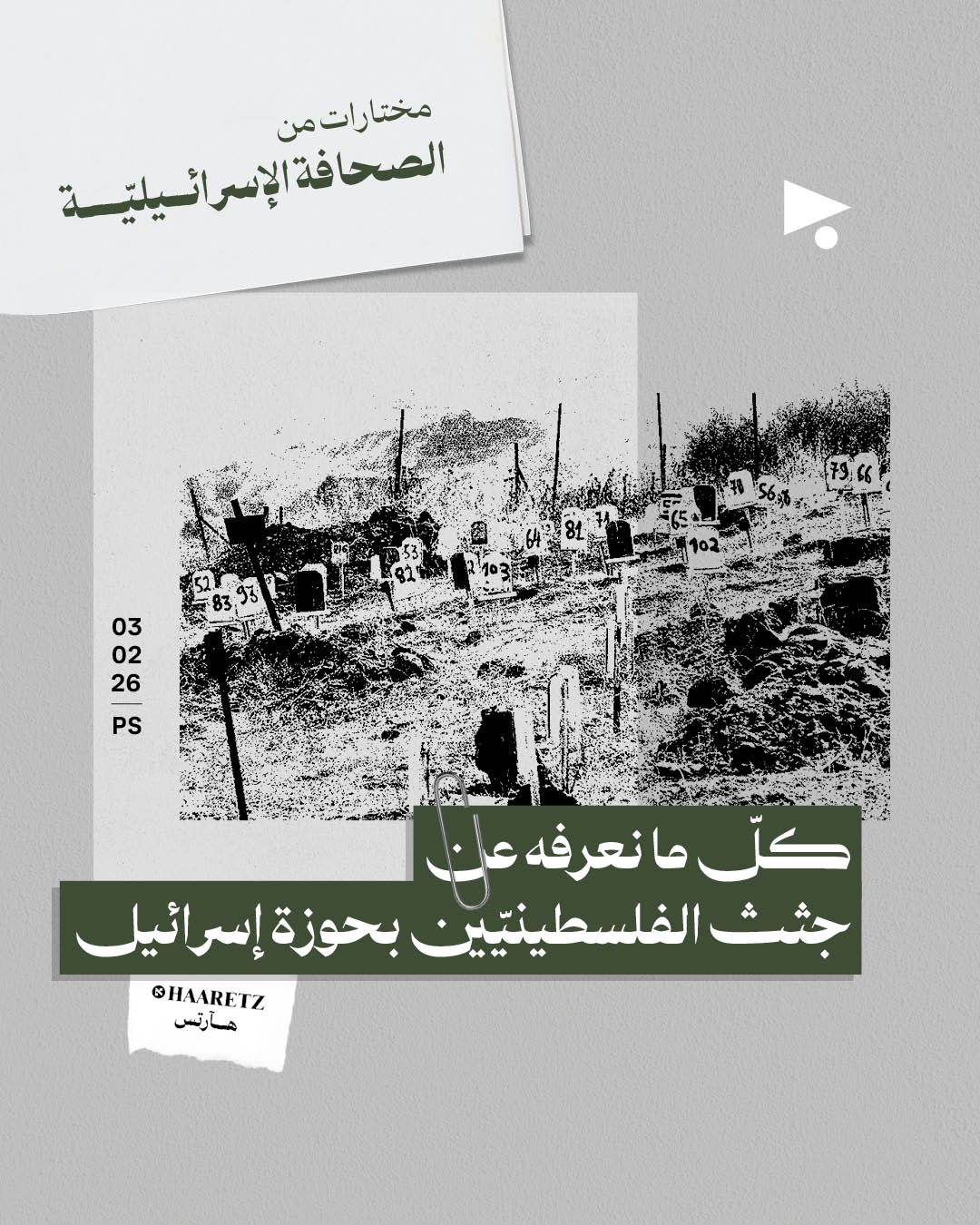الآن
لم أتوقّع. لم نكنْ نتوقّع. لا أدري لماذا انتقلت لصيغة الجمع هنا.
ذهبت لمشاهدة فيلم، بناءً على توصيات صديق أو أصدقاء، لم أعد أتذكّر تمامًا. كان اسم الفيلم يزداد تردادًا من حولي، أقرب إلى انتشار شائعة أو خبريّة، خارج قنوات «النقاش» المعتمدة للأعمال الفنيّة. اسمه أو تلاوين عن اسمه، انشالله تجي، بكرا بيجي، إجا… فلم يكن هناك أي شيء مألوف في عنوان الفيلم أو في إسم مخرجه. ع أمل تجي للمخرج جورج بيتر بربري. لم يكن هناك ما يربطني به قبل مشاهدته، بل مجرّد توصية: إحضر هل فيلم…
توجّهتُ إلى هذا المجمّع الفخم والمهجور في وسط المدينة، والذي بات أشبه بتلك الفنادق المهترئة على الطرقات البحرية، كالتي يزورها الشبّان الأربعة في الفيلم من أجل إتمام واجب «المرّة الأولى». لم نتكلّم قبل الفيلم، فلم يكن لدينا الكثير لقوله عن هذا الجسم الغريب، غير تلك التوصيات المبهمة التي سمعناها جميعًا. كانت أوّل مرّة، كانت ستكون أول مرّة… بعد ساعة ونصف.
استمرّيت لفترة بهذه الحالة الغريبة، قبل أن ألاحظ أنّ هناك شيئاً ما «خبطني»، أصابني من مكان مجهول، خارج حقل نظري وتوقّعاتي، من البترون، من مخرج لم أسمع به من قبل، من لهجة كنت أعرفها من طفولتي، وهجرتها، ولم أتوقع يومًا مشاهدتها تتكلّم عن الرجولة والجنس والخوف والأحلام والموت والقلق… خبطة أعادت إلى الذاكرة هذه الليلة من تشرين، عندما كنّا ننظر جميعنا إلى اليمين، فجاء الكف من اليسار.
لم يكن «الواقع»، هذا الهاجس الذي يطارد الفن كلعنة، ما خبطني. لم يكن «الواقع»، بل «الآن»، براهنيته وارتداداته وترابطه وصلابته… وواقعيته. جاء الكفّ من بعيد، من «الآن»، ليعيد تذكيري بأنّني ما زلت بالـ«أمس»، هناك، وراء، خارج «الآن»… هذا «الآن» الذي تشبه طعمته نكهة المرّة الأولى.
الباترونا
لحظة التقاء «الآن» هي لحظة استيعاب أنّنا ما زلنا خارجه، ربّما قابعين بالـ«أمس»، بعالم بات معتادًا وسائدًا. عودة إلى «النا» هنا، ربّما للإشارة إلى جوّ ثقافي أو حساسية جيلية. لا أدري. ليس بالضرورة عالم العادات والتقاليد، بل عالم الخطابات الثقافية السائدة، مهما كانت تقدّمية أو ثورية، عالم أسئلته باتت معروفة، توقعاته مرسومة المعالم، هواجسه بصلابة القناعات، موقعه بيروت المتقوقعة على ذاتها…
لا نخرج عن السائد بلحظة. فاستمرّيت لأولّ ربع ساعة أبحث بـ«الآن» عن إشارات عن هذا المتوقع، عن أي إشارة عن الحرب الأهلية، عن الانهيار، عن الثورة، عن الهجرة، عن سعر الصرف، عن وعود التغيير المحبطة… هذا السائد الذي تركني لدقائق أنتظر من الشبّان الأربعة، «المسيحيين»، أنّ يقولوا شيئًا عن دور أهلهم بالحرب، عن عنصرية طائفتهم، عن مجزرة الدامور أو تل الزعتر، عن إحباطهم… وهم غير مكترثين إلّا بأيرهم. ربّما من الأفضل استعمال صفة المفرد، لكوني بدأت باستشعار أنّ هذه مشكلتي، التي أحاول تحميلها لجمع متخيل، أختبئ من ضمنه.
ربّما كان تتييسهم بألّا يبوحوا بأي شيء إلّا قلقهم الجنسي قد قضى على دفاعاتي الموروثة. فاستسلمت لهذه الرحلة، في هذا النهار من صيفية ما، على شاطئ البترون، ألاحق أولئك الشبّان وهم في رحلتهم للنيكة الأولى. نستسلم ونتذكر… أستسلم وأتذكر، عفوًا، هذا الطقس اللعين من طقوس الرجولة، الذي لوّن سنوات المراهقة، وربّما كل ما تلاها. أتذكر هذه السنوات القليلة، قبل أن تأتي خطابات «الرشد الثقافي» لتمحو تلك الاهتمامات وتستبدلها بمآسٍ أكثر «جديّة»، نعود إلى تلك السنوات القليلة عندما كان «الصمود» يعني الاستمرار بالانتصاب لأكثر من دقيقتين، وليس زراعة البطاطا على البلكون.
نقف معهم، أو من ورائهم، وهم يواجهون «الباترونا»، الحاجز بين الطفولة والرجولة، مسؤولة «المرة الأولى». هل هناك دلالة بأن تكون ثريّا بغدادي تلعب دور الباترونا، أو هذا مجرّد خيالي يتطاير بلا معنى… فنقف معهم، هم مع مخاوفهم، نحن مع خطاباتنا، في وجه حرّاس الهيكل، لنكتشف سوية أنّ الهياكل الفارغة، إلّا من وعود مكسورة وأحلام معلوكة ورجولة كئيبة وثقافة مبتذلة. ندرك ذلك سلفًا، لكنّنا ندفع ثمن الدخول للباترونا، ويبدأ مشوارنا مع الصمت والقمع.
الرجولة
«الأمس» ليس فقط خطاباتنا الماضية. هو أيضًا هذا الشاب الذي مهما اعتبر أنّه نجح بأقلّ ضرر ممكن في امتحان غرفة «الأول مرّة»، ما زال هنا، بقي جزء منه في هذه الغرفة، ليحوّل كل مرة إلى «المرة الأولى».
فمن خلال تجربة أولئك الشباب الأربعة ورحلتهم، يدخل الفيلم إلى صلب الموضوع، إلى هذا الموضوع الذي لا ندرك كيف نقاربه، وإن كنّا ندرك تمامًا ألّا مهرب من مقاربته. هنا «النا» تشير إلى نحن الرجال. فالفيلم هو حديث بين رجال، بين رجل يقف وراء الكاميرا يراقب مشاريع رجال لكي يحاكي ركام مراهقين يشاهدونه بعد عمر طويل.
وصلب الموضوع هو أزمة الرجولة، أو ربّما، هو هذه الرجولة التي لم تأتِ إلّا مأزومة، ممزوجة بالعنف والكذب والأسى. هي تلك الرجولة التي تشبه هذه «المرة الأولى»، عند شرموطة مجهولة الهوية، تتحوّل فجأة من حارسة هيكل تواكبنا في رحلتنا إلى رجولة كاذبة وقامعة، إلى صاحبة النظرة الحنونة التي تشهد على إعادة إنتاج رجل فاشل جديد، بحبّ من ليس له خيار، وأسى من يدرك أنّه سيدفع الثمن مجدّدًا. ليست أزمة الرجولة ربّما صلب الموضوع. ومجرّد تسميتها هكذا محاولة لتحويلها من أزمة البعض إلى «الأزمة-الأم». وهنا، قد نكون عدنا إلى البدء…
الشباب الأربعة ليسوا أبطال هذه الأزمة، وليسوا ضحاياها. هم مجرّد أربعة مشاريع رجال من الشمال، مع لهجتهم، وذكوريتهم، وصلبانهم… ومخاوفهم وجروحاتهم ووحدتهم… على طريقهم إلى حياة محكومة بهذا القضيب، الضعيف، الزائد، بقلة الحب والعاطفة، بالأحلام المقموعة والمبتورة، بهذا العنف الظاهر، الموجّه إلى النساء، والموجّه إلى الرفاق… والموجّه إلى النفس. في كل واحدة من هذه الحيوات الأربعة، تلاوين مختلفة لأزمة واحدة، ظاهرة على المكشوف، لا تحتاج إلى تعقيب، واضحة لمن يريد أن يرى.
عبث
كل شيء مكشوف، حتى الأفكار الدفينة والمستقبل المكسور والخيبات الحتمية.
فالمكشوف هو أنّ الحياة، بكل بساطة، ليست جميلة، بل مجرّد تجميع وتراكم لسلسلة من الخيبات والأحلام غير المحقّقة والرسائل غير المرسلة والنصوص غير المنشورة والحب غير المتبادل… في حياة كل واحد صادفته الكاميرا، مسار مكسور أو مقطوع، رغبة مرفوضة أو حبّ منتهٍ، وحدة خانقة حتى ضمن الرفاق…
فتذكّرنا هذه الرحلة بأنّنا نسينا كيف نكون بائسين، تعيسين، عبثيين. تذكرنا كيف تمّ تأديب هذا البؤس، عندما تعلّمنا أن «نسيّسه» ونحوّله إلى قول ليصبح بؤسنا «محترماً» ناتجاً عن مآسٍ جماعية وتاريخية، كالحرب الأهلية والانهيار المالي وفشل الثورة وفقدان الذاكرة الجماعية… فتحوّلت مآسينا الجماعية إلى ضابط قامع لبؤسنا الخاص، إلى عنوان رشدنا السياسي. وكأنّ للمراهقين وحدهم الحقّ بأن ينشغل بالهم بقضبيهم، أمّا الكبار، فعليهم التفكير بمأساة الوطن.
نسينا كيف نكون تعيسين لأنّ في هذا «البؤس السياسي» تفاؤلًا ما، تفاؤلًا بأنّ لهذا البؤس نهايةً مع إسقاط النظام أو محاربة الاستغلال… لكن ما من مخرج، بل مجرّد حيوات مكسورة تنتظرنا.