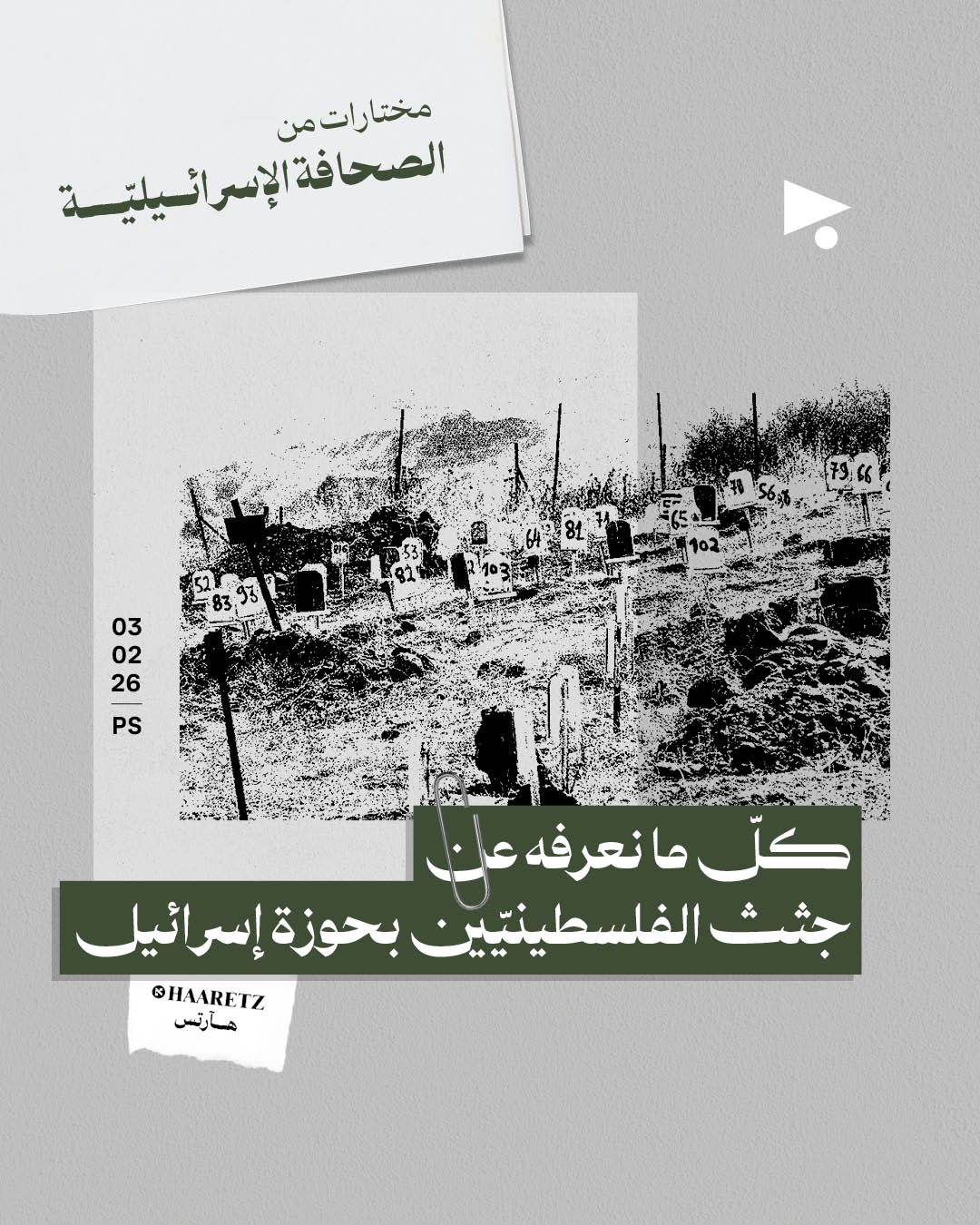في منتصف تمّوز ورد خبرٌ مفاده أنّ الاحتلال استهدف 5 مدارس للأونروا في 10 أيام. تابعتُ تعليقاً من مسؤولةٍ في الوكالة، دوّنتُ تفاصيله، أعددتُ الخبر، وعنوَنته: الاحتلال استهدف 5 مدارس للأونروا في 10 أيام.
دقائق معدودة تفصل بين تحضيريَ الخبر، ونشره.
عند موعد النشر وردَ على هاتفي خبرٌ عاجلٌ، مفاده أنّ الاحتلال قصف دير البلح. ثم ورد تحديثٌ عن سقوط عدد من الشهداء. ثم تحديثٌ آخر عن أنّ القصف استهدف بالتحديد مدرسةً للأونروا؛ ما يعني أنّه– وبين جملةٍ من الأشياء– بات الخبر الذي أعددتُه للتوّ بالياً، ويحتاج إلى تحديثٍ بدوره، على الشكل التالي: الاحتلال استهدف 6 مدارس للأونروا في 10 أيام.
على الشاشة، أمسكتُ الرقم «5».
على لوحة المفاتيح، بحثتُ عن الرقم «6».
هكذا إذاً، لم يكن علَيّ سوى أن أستبدل رقماً بالرقم الذي يليه. ومع ذلك، تردّدتُ لحظةً. فكّرتُ بغرابة ما أفعل: كيف يكون الأمر بهذه الدرجة من «السهولة»؟ حقّاً. أستبدل الرقم 5 بالرقم 6 وينتهي الأمر؟ يصبح «الخبر» الآن «دقيقاً»؟
فكّرتُ بسخف ما أفعل. هذا العبث. هذه اللحظة في غرفة الأخبار.
فكّرتُ بما أفعل، وبالفعل نفسه: أنّ طائرةً إسرائيليةً رمت صاروخاً؛ أنّها رمته على مدرسة، وأنّ المدرسة تأوي نازحين؛ وأنّ النازحين عائلات؛ فكّرتُ بعدد العائلات؛ وعدد أفراد كلّ منها؛ حاولت أن أنتقي أسماءً، للأحياء كما للشهداء؛ فكّرتُ بصِلات القربى ما بينهم؛ الأطفال، الأشقّاء، الأهل، الأصدقاء، الجيران؛ الصباح ما قبل القصف؛ صلاة الفجر؛ الفطور؛ رحلة البحث عن الماء؛ مَن كان في الخارج لحظة القصف؛ لحظة القصف؛ القصف؛ والصراخ؛ البحث عن الأحياء تحت الصراخ؛ تحت الركام؛ والأشلاء؛ وانتظار الإغاثة؛ صعوبة وصول الإغاثة؛ والإغاثة؛ الدفن تحت القصف؛ الجنازة المؤجّلة؛ الجنازات المؤجّلة؛ الإخلاء الذي سوف يلي ذلك، والذي سبقه؛ رحلة النزوح؛ أوامر الإخلاء؛ الإخلاء؛ المنزل؛ حجمه، شكله؛ الأشجار المحيطة به؛ شجرة أكّي دني، شجرة فتنة، وكعب صبّار؛ والذكريات التي تحيط بهذا الأخضر؛ الحياة العادية ما قبل الإبادة؛ أقصد شبه-العادية؛ يوميات الحصار العادي؛ مدرسة الأطفال؛ انشغالات الأهل؛ المائدة؛ أحاديث المائدة؛ زواج الابن البكر؛ العرس؛ الوالدة تزفّ ابنها؛ الزغاريد؛ الدبكة؛ حسابات الزواج؛ المشاكل ربّما؛ الوظيفة التي نالتها البنت الكبرى؛ المعاش الأوّل؛ الحلوى التي ابتاعتها لشقيقتها الصغرى؛ الشقيقة الصغرى؛ تَ تُ تِ؛ المدرسة؛ النشيد؛ المريول؛ الفسحة؛ اللعب؛ الطريق من البيت إلى المدرسة - من المدرسة إلى البيت؛ الملعب؛ الطابون؛ محل الشاورما؛ قهوة الحي؛ الرصيف؛ نزهات البحر؛ البحر، الفسحة الأخيرة؛ الرمل؛ الملح الكثير؛ الماء الأكثر؛ الموج؛ وسرعان ما غرقت بكل ما كنتُ أراه عبر الشاشة، كل تلك الوجوه التي تبدو أليفة من دون أن أعرفها، كل تلك الأسماء التي تختلط لفرط كثرتها بما يجعلك تنتبه أنّه بلى: الإبادة تطال مليونَي شخص وأكثر؛ وأنّ الإبادة تطول وقد شارفت على إتمام العام؛ فكّرتُ بكل تلك الوجوه التي رأيتها في هذا العام— لأوّل مرّة في حياتي أرى كل هذه الوجوه في مثل هذه المدّة؛ ولفرط ما رأيتُ عدداً من تلك الوجوه بشكلٍ شبه يومي، بتُّ أعرفها بالوساطة: تحديداً أنس، وربّما إسلام، اسماعيل (كان ما زال ينقل بالبثّ الحي يوم ورد خبر استهداف المدارس الخمسة، إنّما، وإلى أن نُشر هذا النص الذي تقرأون، كان اسماعيل قد استشهد)، جمعة، فادي، سعدي حسن بركة: حفّار القبور الذي ما عاد يعرف النوم لفرط ما رأى الأطفال المقطّعين؛ سيلا حوسو: طفلة السبع سنوات التي كسر القصف جمجمتها وما زالت قيد الحياة— لها صورة وفيها فروة رأسها مقطّبة من الأذن إلى الأذن؛ مرام الجعبري: الطفلة التي كانت في مدرسة التابعين لحظة قصفها— تقول أنّها رأت «منظر مرعب بيخوّف كتير هنا واحد وهنا واحد مقطّع ولا واحد متعرّف عالتاني ومن بينهم طلت أبويا أبويا وعمّي وأبويا»؛ إبراهيم سالم: المعتقل الذي خرج من «سدي تيمان» وحفظ أسماء رِفاق السجن لإخطار عائلاتهم بمصيرهم المجهول— عند خروجه، سجّل الأسماء على دفترٍ بصفحاتٍ لا نهاية لها وأخذ يقلّب الصفحات أمام الكاميرا، يقلّب الصفحة، تلو الصفحة، تلو الصفحة، والاسم يندرج تلو الاسم، تلو الاسم، تلو الاسم، إلى ما لا نهاية؛ آية عليان: السيّدة الناجية من غزّة بعد أن فقدت 50 فرداً من عائلتها، 50— «راضية الحمدالله، تقول، بس مش سهل». آية عاتبت زوجها بعد أن دفن أبناءها، «كيف هان عليك تدفنهم وتجي؟ كيف؟ أحياناً بتذكّر: كيف سمحتلّن ياخدوهم يدفنوهم؟ كيف سمحتلّن ياخدوهن منّي»؛ خالد سائد الشوّا: خالد سائد الشوّا، تكرّر بسمة الخزندار ذكر الاسم، هذا اسم ابنها: خالد سائد الشوّا، تقول أنّه ليس رقماً ولا هو شهيد مجهول، ولا هو «وشهيدٌ ثالثٌ أصابته القذيفة التي استهدفت المُراسل اسماعيل الغول والمصوّر رامي الريفي»، بل له اسم واسمه خالد سائد الشوّا؛ فرج السمّوني: المعتقل الذي عرض الجنود الإسرائيليون أمامه صور جثث وقالوا له إنّ هذه هي أمّك وزوجتك وشقيقتك— لحظة خروجه مشى مسافة 3 كيلو، ثم عثر على جوّال واتّصل برقم زوجته وسأل: انت عايشة؟ قالت اه عايشة. انت عايشة؟!، قالت اه والله انا عايشة! طب انت بخير؟ والله انا بخير. طب امّي بخير؟ اه والله امّك بخير؛ عبد العزيز: واحد من الأشقّاء الأربعة الذين فقدوا أهلهم، في استهدافَين منفصلَين، وقد أصيب هو أيضاً بعينه— يقول عبد العزيز «مش نفسي العب. بس نفسي أشوف بعيني»؛ محمد أبو طه: الطفل الذي يظهر في فيديو وهو يحتضن حذاء والده، جثمان الوالد أمامه، والأقارب موزّعون من حوله، وهو يبكي، وأنا احتقرتُ المصوّر الذي ركّز الكاميرا على عينَيه الباكيتَين. لم أنشر الفيديو. شعرتُ أنّ العدسة مزّقت خصوصية محمد— بعدما قلبت وسائل التواصل اسمه البسيط، محمد، إلى «الطفل الذي احتضن حذاء والده»، قابلَتْه قناة الجزيرة. يقول محمد «حاسس حالي اني انا بداله مستشهد»؛ حمزة؟ هذا ليس اسمَ علمٍ فحسب. «حمزة؟» سؤال، طرحته سيّدة أمام باب السجن لحظة خروج شابٍ نحيل وأخذ يحضنها: حمزة؟ انت ابني حمزة؟ ايوا يمّا انا حمزة! وراحت تكرّر: حمزة هذا حمزة هذا حمزة حبيبي حمزة. «حمزة»، هنا، ليس اسمَ علمٍ فحسب؛ كل هذه الوجوه، كل هذه الأسماء، وأنا لا أتوقّف عن لوم نفسي: كيف أعرفهم جميعهم من قصصهم اللاحقة على الإبادة؟ وكيف أحصرهم فيها الآن؟ كيف كانت حياتهم تدور في ما سبق؟ ماذا عن ابراهيم حسين وأخيه، كيف كانت علاقتهما قبل الإبادة؟ ابراهيم حسين: اتّصل جندي إسرائيلي على رقم أخيه وقال له «في إلكم كابونة [لاستلام مساعدات] جايتكم على عجل»، وصار الجندي يضحك— ما إن أقفل الاتّصال حتّى سقطت القذيفة بالجوّال مباشرةً. كانت هذه هي الكابونة اللي جايي على عجل. نكتة إسرائيلية سمجة. استشهد شقيق ابراهيم وأصيب هو؛ معزّز عبيات: لاعب كمال أجسام خرج من سجن النقب: «سجن النقب سجن غوانتامو. كل اشي لا يتصوّره العقل». في أحد الفيديوهات يكرّر معزّز «والله استشهدت أنا. استشهدت أنا. بتقتلوني؟ بتقتلوني؟ بدّن يجوا يقتلوني». ثم يطرد الممرّضون المصوّرين المتطفّلين: «بس خلونا نعرف نتفاهم معه. الله يخليكم. لمصلحة المريض. توكّلوا ع الله»— في فيديو آخر يسأل: شو اسمي؟ يقولون: معزّز. يقول: اسم حلو والله؛ عبدالله الغاف: يعيش الآن في خيمة مع ابنتَيه. قبل النزوح، طلب ابنه فراس (عامَين) بسكويتاً، فخرج عبدالله يشتري البسكويت. عند عودته كان المنزل قد قُصف، استشهد ابنه فراس، وزوجته مَريهام. «مخّي كان طاير من كتر الزعل». نجت ابنتاه، وتصاوب ابنه الآخر، محمد — 25 يوماً ومحمد يبكي طلباً للمسكّنات، إلى أن استحصل عبدالله على إذنٍ لعلاجه في مصر. وصل محمد إلى مصر، في اليوم التالي استشهد؛ أشرف أبو شمالة: كان يلعب على البسكليت مع جدّه لحظة استُهدفت خيمتهم— انجرح أشرف، لكنّ صديقته، وعد، التي كان يلعب برفقتها… يرفع أشرف يده اليسرى إلى جانب رأسه، «اجت رصاصة من هان»، ثم ينقل يده وهو يقول «هييييك» إلى الجانب الأيمن من رأسه، «وطلعت من هان»؛ محمد أحمد فرّاج رصراص: فقد ابنه في خان يونس، ابنه أخرس ويُعاني من التوحّد، ثم عُثر عليه بعد أسابيع على حاجز نتساريم مغمّى العينين— عند وصوله إلى المستشفى، ما كان الطفل يحكي، بل يمسك ورقة فقط، ورقة تلو الورقة، ويرسم عليها جنوداً يمسكون السلاح، جندياً تلو الجندي؛ رجلٌ لم أعرف اسمه لكنّي حفظتُ وجهه جيّداً. ينحني على جثمان شقيقه ويبكيه. أخوه مسعف قُتل قنصاً— يصرخ الرجل «الله أكبر. والله غير الثار. والله غير الثاااار. والله غير الدم»؛ رهف فادي ناصر: صبيّة تمسك غيتاراً وتجلس على ركام منزلٍ. حولها أطفال يقفون وكأنّهم كورس، وسوف يصفّقون لها عندما تُنهي أغنيتها— لن يُقفل باب مدينتنا، تقول. وبعد حين: ستمحو يا نهرَ الأردن آثار القدم الهمجية؛ الدكتور عمر حرب: قُصف بيته وعنده 26 شهيداً، وها هو الآن يعدّ القهوة للمُراسل الذي يحاوره، في خيمة، ويحكي كلاماً مسبوكاً، كلاماً بسيطاً للغاية، ومع ذلك تجد فيه عمق البحار. حكى عن فنجان القهوة، عن أنّه ليس مجرّد سائل لونه بنّي. حكى أشياء كثيرة— حفظت منه جملةً: «طَلَب الحياة حتّى في ذروة الموت، لعبة الفلسطيني»؛ محمد: طفل يرتدي قبّعة ليَقي نفسه من الشمس، ويرفع يديه أمامه كي يظلّل الشمس عن وجه شقيقه عادل— عادل مستشهد، والشمس تضرب كفناً أبيض؛ أبو سالم الأشرم: يحدّق بركام منزله في مخيّم النصيرات— من الركام سحب جيفة طيرَين أصفرَي اللون، وصورةً لياسر عرفات، وورقةً مكتوبٌ عليها وصفة المعمول: 5 كاسات سميد، ½ كاسة سكر (اختياري)، ملعقة زيت كعك، 3-4 دروس مسكة مطحونة، ¾ - 1 كاس سمنة [غير مفهوم] بماء الورد تُخبز مع [غير مفهوم]؛ محمد أكرم الحلو: صحافي أصيب أثناء التغطية ثم خضع لعملية— تحت تأثير البنج كان يكرّر جملاً غير متّصلة: بدّي ارجع على داري… وقفوا الحرب… والله والله شفت أطفال مقطّعين… والله شفت ناس بالخيَم… ناس بتشرب مي وسخة… حرام عليكم… حرااام… والعالم كلّه بيتفرّج… والله لالعن العالم… الله يلعن العالم كلّه.
إلهي. كان عليّ فقط أن أمسك الرقم «5» على الشاشة، وأضغط الرقم «6» على لوحة المفاتيح. هل هناك ما هو أبسط من ذلك؟ وفعلت. فعلت. وصار خبري دقيقاً. منيح هيك؟ وأقفلتُ حاسوبي. وخرجتُ أقعد تحت الشمس حتّى زاغ بصري. وفكّرت: هذه لحظة في غرفة الأخبار. فكيف تبدو اللحظة هناك؟