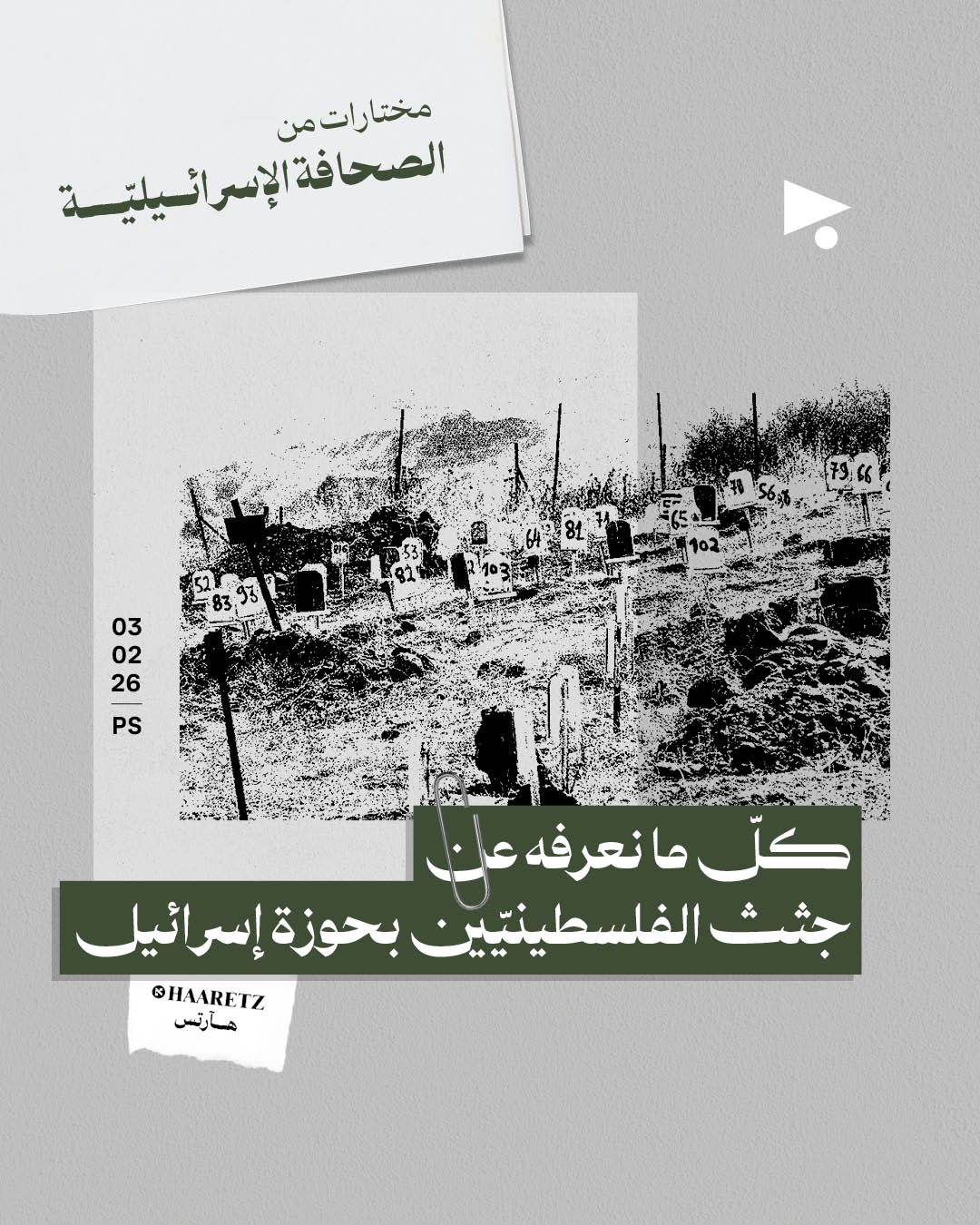تكرار النقد وحدوده الطائفيّة
بات هناك شيء من التكرار في النقد الموجّه لحزب الله، نقد يتكرّر كل مرّة يتصدّر حزب الله فيها الأخبار من خلال تظاهرة دموية أو تصريح تخويني أو شبهة اغتيال.
قد يكون تكرار النقد إشارة للتكرار المضجر الذي يرافق إطلالات نصرالله أو التكرار الدموي لتقنيات حكمه. فالتجديد ليس دائمًا ميزة إيجابية. لكن في هذا الترداد للنقد إشارة إلى مأزق: الإجماع الناشئ حول مركزية «مشكلة حزب الله» يصطدم اليوم بـأسوار البيئة الحاضنة، في علاقة شبه سببيّة: مع كل خطوة تصعيدية في النقد، تتصاعد أيضًا أسوار الطائفة.
يمكن المكابرة على هذه الأسوار، وتحليلها كنتيجة لسيطرة أيديولوجية أو انبعاث لبنية قبليّة. لكن لا يمكن نفي أنّها مبنية جزئيًا على سردية مظلومية تقدّم لها شرعيتها وصلابتها.
كتب الكثير عن المظلومية الشيعية، ربّما أكثر من باقي المظلوميات الطائفية اللبنانية، من أصولها في جبل عامل إلى تجاهل الطائفة مع تأسيس دولة لبنان، مرورًا بالحرمان الاقتصادي ومرحلة الاحتلال الإسرائيلي، ووصولًا إلى الإحساس العميق بحصار إقليمي.
يمكن المكابرة على هذه الأسوار وسردياتها. لكنّ ثمن هذه المكابرة هو احتواء النقد ضمن خطوط تماس الطوائف الموروثة.
البلد ماشي من دوننا
لا تهدف الإشارة إلى هذه المظلومية لتبرير هيمنة حزب الله أو لفتح سجال حول أحقيّتها أو عدم تلاؤمها مع التحوّلات الراهنة، أكانت اقتصادية أم سياسية. كما أن الكلام عن مظلومية لا يضفي على الخطاب الطائفي أي شرعية أو مبرّر. فالإشارة إلى هذا المستوى من تركيب الخطاب الطائفي تهدف إلى الدلالة على ترابط المظلوميات في لبنان اليوم وتماهيها مع بعضها بعضاً.
ففي لبنان اليوم، مظلومية سنّية، تنطلق من تاريخ من الحرمان أعيد اكتشافه، ممزوجة بروايات عن الاضطهاد السياسي، من العراق إلى سوريا إلى لبنان، ومدفوعة بخطاب شيطنة عالمي. أن يكون زعيمك سعد الحريري هو الدلالة على مظلومية جماعتك.
الكلام عن مظلوميات طائفية أخرى قد يزعج بقايا اليسار ومنظّري الراديكالية الذين اعتادوا تلخيص روايات الطوائف إلى تسطيحات سياسية، إذا لم تكن كاريكاتورات تاريخية، تنفي من خلالها أحقية روايتها الخاصة.
في لبنان أيضًا، مظلومية مسيحية، قد تكون بدأت مع الخوف الأقلوي، ولكنّها تكرّست بعد الحرب الأهلية التي افتتحت مرحلة قمع الأحزاب المسيحية. وهذا الخوف من الإلغاء السياسي معطوف على خوف ديموغرافي يتمّ التهويل به قبل كل استحقاق لتذكير مسيحيّي لبنان بأنّ مصيرهم هو مصير الأقليّات المسيحية في المنطقة. فصورة المقاتل الشيعي الذي يحمي أيقونة في سوريا هي التجسيد لهذا الخوف، وليس مكمن الطمأنينة، كما يعتقد نصرالله.
تتقاطع هذه الروايات ببعض محطاتها التي تشكّل نقاطاً خلافية، ولكنّها تتماهى بقلقها المشترك من أنّ قمعها أو حرمانها أو نسيانها يتعايش مع استمرار الحياة الطبيعية.
فللتذكير، شعار «البلد ماشي» والذي افتتح مرحلة «استقرار» ما بعد الحرب تلازم مع تجربة الحياة تحت الاحتلال لسكان الجنوب ومرحلة القمع السياسي في المناطق المسيحية أو تعمّق الحرمان في الشمال السني.
فقلق الطوائف هو جزئيًا قلق النسيان، قلق حرمان يتطبّع ليصبح مقبولًا و منسيًا. البلد بيمشي معنا وبلانا.
المظلوميّة الثوريّة
شيعي، سني، مسيحي… منذ سنتين حتى أحداث الطيّونة، ظهرت السياسة في لبنان وكأنّها محكومة بعناوين تخرج عن هذه اللغة، عناوين عن فساد ونظام وتحقيق وتظاهرات وحقوق…
لكن مع أول طلقة نار، عاد هذا الخطاب ليهيمن على الشارع وعلى أدواتنا المعرفية، كأنّ هاتين السنتين لم تشكّلا إلّا نزهة مؤقتة خارج هذا الخطاب، أو محاولة لاختصار مجتمعنا بتلك الساحات الثائرة. وربّما كان ما ظهر بعد سنتين من الاحتجاجات هو ضعف السردية الثورية في احتواء مخاوف وقلق الجماعات الأهلية والتعبير عنها، لتضيف مظلوميتها إلى باقي المظلوميات.
قد تبدو محاولة حشر هذه الروايات بمظلومية «ثورية» عن ضحايا مجرّدين لنظام متوحّش، محاولةً مغريةً للخروج من الطوائف ومأزقها. لكنّها تفتقد لأي صلابة ثقافية أو تاريخية، ما يحوّلها إلى حفلة نقّ داخل السرفيس خصوصاً عندما لا تعرف الهوية الطائفية لباقي الركّاب: أكلوا البلد، أي والله، كلن حرامية، ألله لا يوفقن…
النظام والطوائف
ربّما لا يهدف هذا المقال إلى شيء أكثر من الإشارة إلى صعوبة القفز فوق الطوائف وروايتها، خاصة بلحظات الاقتتال الأهلي. ربّما لم نصل إلى هذا الحد من العنف الذي يلغي أي مساحة خارج المنطق الطائفي، ولكنّ هذا الأفق بات اليوم يهدّد أي إمكانية لسياسة أخرى في ظل الانهيار العام. ربّما كنّا نستطيع تجاهل هذا الأفق في لحظة العنفوان الثوري، ولكنّه عاد مع عنف يفوق كل ما اختبرناه في السنتين الأخيرتين.
هذا لا ينفي مقولة «النظام والشعب»، لكنّه يتطلب اليوم العودة إلى الطوائف، إلى اعتبارها ساحات للعمل السياسي وليس مجرّد خطابات أيديولوجية يمكن استبدالها بقوة الإقناع الثوري أو تجاهلها بإسم أوليّة الصراع مع «النظام». ربّما شكّل تلخيص المجتمع بتركيباته الطائفية نهايةً للحركات الاعتراضية في الماضي، لكنّ تجاهل هذا البعد قد يشكّل اليوم نهاية الحالة الاعتراضية الراهنة.