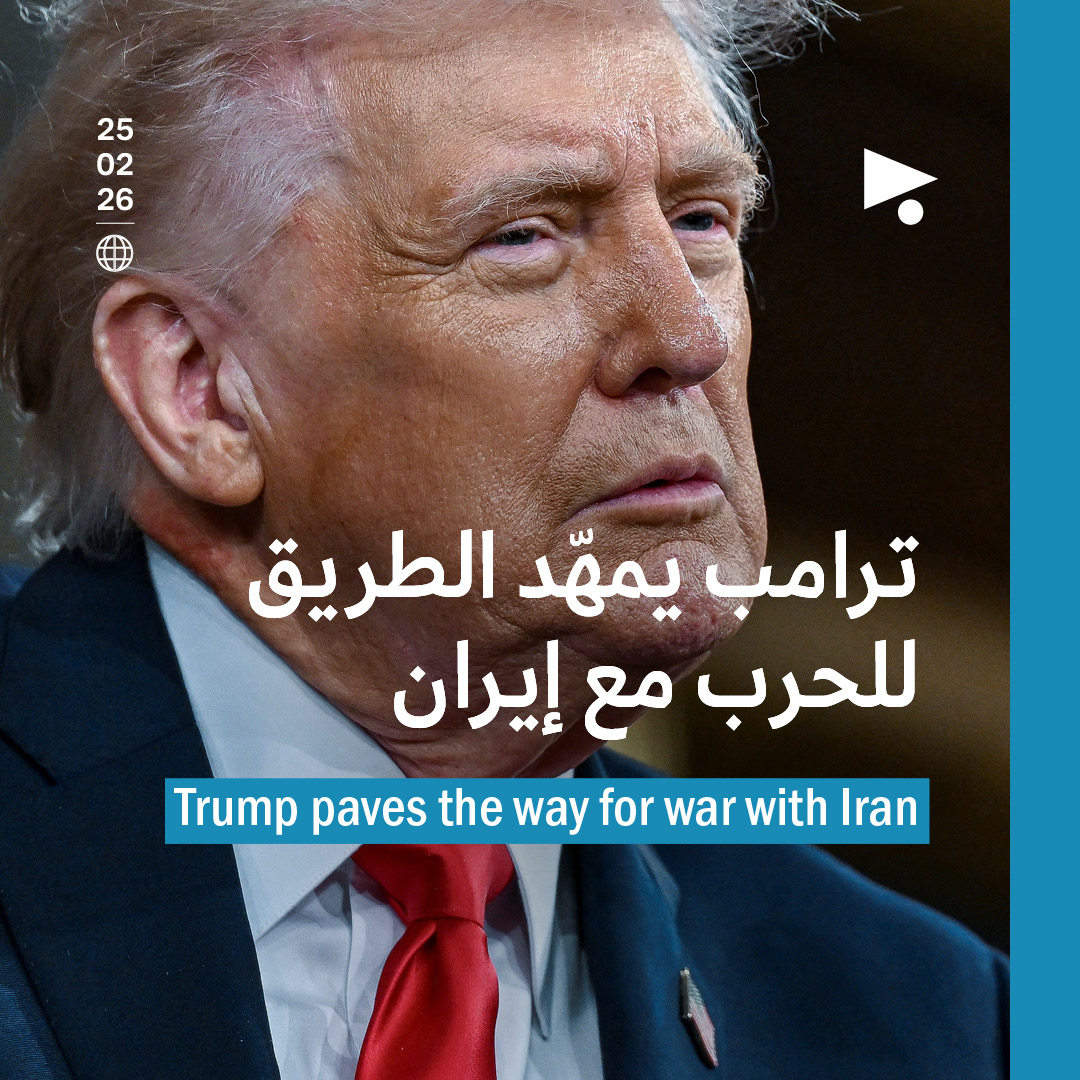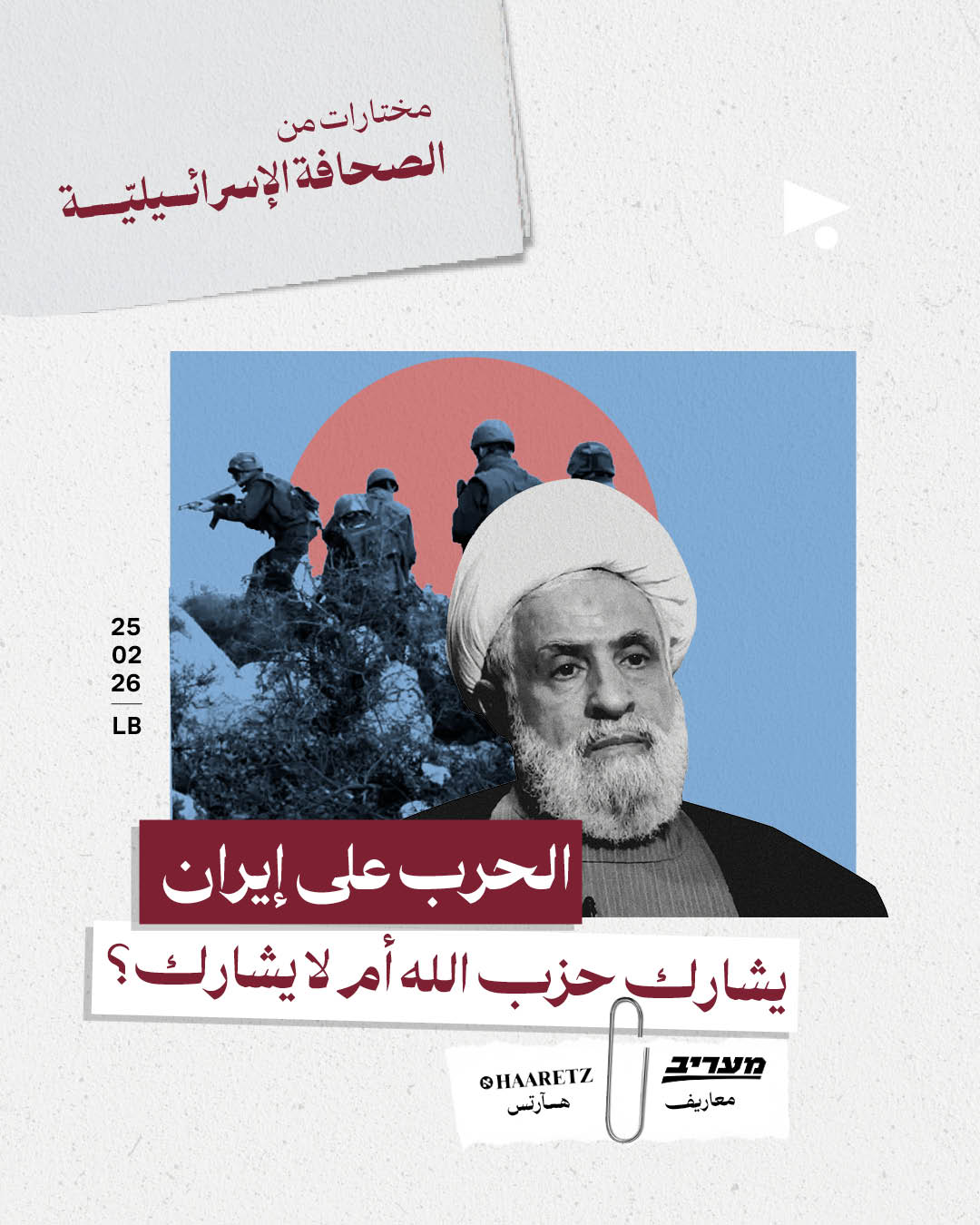ما هي الضيعة اللبنانية؟ أو المدينة؟ أو المكان المتخيّل في الثقافة اللبنانية؟ المكان ليس مجرّد «ديكور» لرواية، هو بحد ذاته أحد أبطالها، يلخّص حساسيات العمل، ربّما أكثر من أي شخصية أو حبكة روائية. من ضيعة الرحابنة إلى مدن ربيع جابر، وصولًا إلى المناطق الحدودية لـ«الهيبة»، يقدّم هلال شومان صوراً عن تحوّلات المكان في المخيال الثقافي، ومن خلالها تطورات الثقافة اللبنانية.
بعد استقلال لبنان بسنوات قليلة، استثمر المخيال الفني والأدبي اللبناني في خلق الأمكنة المتخيَّلة مرتكزًا على واقع وتاريخ يأبيان التمثُّل الصريح فنيًا. في كلِّ مرةٍ كان المكان فيها يُقدَّم في إطار مقترح خيالي منتزَع من الجغرافيا الواقعية أو متاخمًا لها، أمكن ملاحظة أسباب عامة دفعت لتخييله، تراوحت بين الرغبة في الهرَب من الوطأة اللبنانية (وأحيانًا العربية) في السياسة والاجتماع، ومحاولة إعلاء المكان المتخيَّل وموضعته في سياق أوسع من الحزازيات اللبنانية والعربية.
ما يلي هو محاولة لتتبع مسار خلق الأمكنة المتخيَّلة، من دون أن يكون هذا التتبع حصرًا كاملًا لكل ما أُنتِج، فعلى الأغلب هناك من التخييل المكاني ما دُفِن في هامش الزمن والذاكرة.
صعود المكان الرحباني والردّ الزياديّ عليه: جدليَّة الريف المتخيَّل ومدينة السلطة المأزومة
جسر القمر والريف المُتخيَّل
منذ نهاية خمسينيَّات القرن الماضي، حاول الأخوان رحباني عبر تقديمهما لكفورهما ومدنهما المتخيَّلة أن يتجاوزا الواقع، مع ابقاء ارتكازهما عليه. فاستطاعا أن يُصعِّداه إلى مستويات ترميزية من دون أن يمنعهما ذلك من تقديم ما يمكن للمتلقي أن يُسقِطه بسهولة على أحداث بعينها.
ففي «جسر القمر» (1962) مثلًا، التي عرضت بعد أربع سنوات من أزمة عام 1958 في لبنان، يقدِّم الأخوان قاطعًا بين جماعتين متناحرتين متمثلًا بـ«جسر القمر» الذي تظهر عليه صبية مسحورة، وتحاول أن تفك سحرها وتقضي على الخلاف بين الجماعتين. لم يكن «جسر القمر» كفرًا كاملًا، بل كان قاطعًا بين ضيعتيْن مغفلَتَيْ الاسم، ليُنذِر ربما بخطورة أحداث عام 1958. لقد جاء الجسر بعد طروحات مسرحية ومشهدية رحبانية توفيقية خلال فترة فؤاد شهاب الرئاسية، جرت أحداثها في قرى مبهَمة الأسماء كما في «المحاكمة» (1959) و«موسم العز» (1960). فبينما تصل «موسم العز» في نهايتها لأن تذكر لبنان صراحة في أغنية «القوي لبنان»، حيث الهنا والجنى في سماه، والذي يُعبَد بعد الله، فإنَّ الاحتفاء المباشر بلبنان، عبر أماكن تمثيلية (بعلبك) أو مؤسسات رسمية (الجيش)، واضح في عرضَيْ «البعلبكية» (1961) و«عودة العسكر» (1962). قُدِّم «عودة العسكر» كتحية للجيش اللبناني في «يوم الوفاء». وفي العام اللاحق (1963) سينتج روميو لحود مسرحيته «الشلال» (التأليف لألين لحود والإعداد والحوار ليونس الإبن، قيادة الأوركيسترا ومعظم الألحان لوليد غلمية مع ألحان لفيلمون وهبي وزكي ناصيف)، التي احتشدت فيها الأغاني الوطنية عن لبنان في ما يبدو أنه سمة ملحوظة من سمات العهد الشهابي. التندر على «الشلال» سيكون جزءًا من مسرحية زياد رحباني «شي فاشل» لاحقًا.
بعدها، سيستمر الأخوان في تقديمهما القرى مغفَلة الأسماء في «الليل والقنديل» (1963)، و«بياع الخواتم» (1964)، و«دواليب الهوا» (1965)، فيكملا الاستعانة بالعناصر والأجواء الريفية التي اعتادها الجمهور، قبل أن يقدما طرحًا تاريخيًّا بالغ المباشرة عن تكوُّن لبنان (الثوري؟) في «أيام فخر الدين» (1966).

الانتقال إلى المدينة
في «هالة والملك» (1967)، يتحوَّل المكان عند الأخوين إلى ساحة لمدينة متخيَّلة هي «سيلينا» يلتقي فيها الناس من كافة الطبقات في احتفال «الوج التاني» تحت طبقة واحدة وموحَّدة هي القناع. هذا اللقاء يبقى لقاء مرحليًا ومعلَّقًا بسبب نبوءة وصول الأميرة المتخفِّية، ولكن ذلك لا يمنع ثالوث الملك، والشحاذ والوافدة من قرية «درج اللوز»، من إعادة مظهرة الطبقات لينتفي منطق الاحتفالية نفسها. تطرح «هالة والملك» للمرة الأولى في أعمال الأخوين لقاء الكفر المتخيَّل «درج اللوز»، بالمدينة المتخيَّلة «سيلينا». فـ«سيلينا» هي مركز يجاء إليه، ويُرحَل منه (جايين ع ساحة «سيلينا».. رايحين من ساحة «سيلينا»… ).
فإنَّ «هالة والملك» تبحث إن كانت المدينة قادرة أن تحتضن كافة الطبقات من كل الخلفيات، ريفيّة أو مدينية. لكنها عدا كونها مركزًا لاحتفال السلطة الحاكمة ومن حولها، لا تحوي «سيلينا» أي ملامح مدينية أخرى واضحة.بهذا المعنى، فإنَّ «هالة والملك» تبحث إن كانت المدينة قادرة أن تحتضن كافة الطبقات من كل الخلفيات، ريفيّة أو مدينية. لكنها عدا كونها مركزًا لاحتفال السلطة الحاكمة ومن حولها، لا تحوي «سيلينا» أي ملامح مدينية أخرى واضحة. «سيلينا» مدينة الأقنعة فقط.
الانتقال للـ«مدينة» سيكمل مع «الشخص» (1968). لكن مجددًا، كما في «هالة والملك»، سيُختصر المكان بكونه ساحة لبلدة يعرض الباعة فيها بضائعهم ويتملقون السلطة تحضيرًا للاحتفال بزيارة الشخص، صاحب أعلى سلطة رسمية. لكنَّ فشل الاحتفال سيحوِّل البلدة إلى ساحة محاكمة، ما يسائل قدرة «المدينة» أن تنتج منظومة قانونية عادلة مقارنةً بالضيعة حيث تُحَلُّ الأمور حبيًا في النهاية بين الجماعات.
استراحة ملحميّة
بعد عام، سيعود الأخوان ليطرحا مقترحًا مكانيًا معلَن الاسم هو «جبال الصوان» (1969). يلاقي اسم القرية «جبال الصوان» مضمون الحكاية الملحمية في المسرحية. إنها حكاية غربة العائدة من المنفى التي أُجبِرَت عليه بعد قتل والدها لتجابه فاتك المتسلِّط. «جبال الصوان» هي جواب على «أيام فخر الدين»، وتكملة خيالية تستبدل رحيل فخر الدين بعودة غربة. إنها ترميز سيستخدمه الخطاب اللبنانوي، حيث يمكن للخيال أن يستردّ التاريخ ويكمله، ويرتفع به فوق الواقع.
هذه الاستراحة الملحمية العابرة، ستنتهي مع «يعيش يعيش» (1970)، حيث تنتفخ المدينة لتصبح امبراطورية «ميدا» التي تتوالى فيها الانقلابات المعلَن عنها في بيانات أولى إذاعية، في إحالة عن زمن الانقلابات في سوريا. عرضت مسرحية «يعيش يعيش» في لبنان قبل شهور من انقلاب حافظ الأسد، ولم تعرض في معرض دمشق على جري عادة مسرحيات الأخوين. مدينيَّة «ميدا» مختصرة مجددًا بدكَّان في ساحة، وبأثير راديوهات تستمع إليه الشخصيات، وبحكاية تنازع سلطوي.
بعد الإمبراطورية، سيقدِّم الأخوان صيغة الولاية في «صح النوم» (1970) عرضت مسرحية «صح النوم» بعد وفاة جمال عبد الناصر في الفترة بين تشرين الثاني وكانون الأول ١٩٧٠، وتطرقت عبر لطشاتها إلى تأثيرات حكم جمال عبد الناصر في لبنان («والي واحد، لا واليان»)، وهي من أقصر مسرحيات الأخوين عرضًا وأقلها نجاحًا. حيث تيسير شؤون الأهالي والحكم يقتصر على يوم واحد. أما «ناس من ورق» (1971)، فالمدينة فيها هي مدينة الانتخابات التي قد يعكر سير نشاطاتها، عروض فرقة ماريا المسرحية. وفي «ناطورة المفاتيح» (1972)، سيبحث ملك مملكة «سيرا» عن شعب ليحكمه بعدما هرب شعبه من الضرائب وترك بيوت «سيرا» فارغة وسلَّم مفاتيحها لزاد الخير. بينما تُقدَّم «المحطة» المتخيَّلة (1973) كانتظار للحداثة في بلدة يحكمها تنازع السلطات الأهلية والبلدية، وهو انتظار سيبقى عند وردة التي خلقته، والتي لن تجد من يبيعها تذكرة للقطار. أما «لولو» (1974) التي خرجت من السجن بعد ظهور براءتها وعادت إلى المدينة لتنتقم ولتستعيد العدالة المسلوبة، فإنها ستترك المدينة في حال من الفوضى والنزاع وتعود في النهاية إلى ضيعة جدّها.
الحرب الأهلية
من حيث انتهت «لولو»، تبدأ «ميس الريم» (1975) التي عرضت قبل الحرب الأهلية اللبنانية بأشهر، وتوقفت مع نشوبها. تستعيد «ميس الريم» موضوع تناحر الجماعتين من «جسر القمر»، لكنها تجمعهما في مكان واحد بلا قاطع، لا بل أنَّ الحب سيذكي من جديد النزاع، مع وصول وافدة أخرى هي زيُّون (من ضيعة «كحلون») التي خربت سيارتها في ساحة البلدة. وإذ يُحَلُّ التناحر مرحليًا بمساعدة من الوافدة، فإنَّ محرك سيارة زيُّون يبقى لا يعمل، وستبقى تنتظر من يساعدها.
المكان التخييلي عند الأخوين رحباني
مدن الأخوين هي أشباه مدن مسكونة بالأسئلة الوجودية حول العدالة الطبقية والإنسانية بعدما انتفخت من قرى إلى كيانات أخرى، فلم تستطع أن تفارق ضيعويَّتها ولم تستطع أن تتحول إلى مدن كاملة المدينية.بالنظر للأماكن التي قدمها الأخوان رحباني من خلال مسرحياتهما، وبخلاف التاريخي منها («أيام فخر الدين» و«بترا» بالرغم من الخطأ الشائع، المدفوع بأغنية في المسرحية (يا زهرة الجنوب)، لم يكن إنتاج وعرض مسرحية «بترا» سابقًا لـ«عملية الليطاني» بل إنها عرضت في عمّان في 1977، وبدأ عرضها في لبنان صوب نهاية كانون الثاني 1978، شهر قبيل عرض زياد الرحباني لمسرحيته «بالنسبة لبكرا.. شو؟» على مسرح الأورلي نهاية شباط 1978. «بترا» أقرب إلى تأطير تاريخي فقط لما سبق للأخوين أن أنتجاه في «أيام فخر الدين» و«جبال الصوان»، وما أكمل به منصور الرحباني في بعض مسرحياته بدءًا بـ«صيف 840» (1988)، لكن على إيقاع الاحتراب الأهلي (حرب السنتين) ومناوشات الحدود الجنوبية. في مقالته «من «بترا» فيروز والرحابنة الى«سناك بار»: الوحدة الداخلية منظورا إليها من وجهتين متناقضتين» المنشورة في عدد السفير 26 / 3 / 1978، يتساءل جوزف الشمالي إن كانت «بالنسبة لبكرا.. شو؟» بخطابها عن الانقسام الاجتماعي الحاد تناقش مفاعيل خطاب الوحدة الوطنية والدفاع عن نظام الخزنة والخدمات والازدهار التي روجت له «بترا». وفي مقالته «فيروز والرحابنة يفتتحون ليالي المسرح البيروتي: خرج الصراع من بنك بترا… ولم يعد» (السفير - عدد 27 / 1 / 1978) يسجِّل ابراهيم العريس لعمل الأخوين الأخير مع فيروز «قدرته على جمع البرجوازيين الصغار من كل أنحاء لبنان، هؤلاء الذي يأتون ويضحكون ويتسلون، ويستعرضون أنفسهم ويصلون بإيمان لوحدة الوطن، ويصفقون يصفقون كثيرًا…». )، يمكن القول إنَّ المكان التخييلي عند الأخوين بدأ ريفيًا، وانتهى مدينيًا بالشكل، لكن مع الحفاظ على عناصر ريفية. فمدن الأخوين هي أشباه مدن مسكونة بالأسئلة الوجودية حول العدالة الطبقية والإنسانية بعدما انتفخت من قرى إلى كيانات أخرى، فلم تستطع أن تفارق ضيعويَّتها ولم تستطع أن تتحول إلى مدن كاملة المدينية.
وبينما كانت الخلافات في قرى الأخوين تنتهي دومًا بالمصالحات الأهلية، يتكرَّر في الملحمة الثورية عندهما ثيمتا الرحيل والعودة، أما المدينة في كافة تلاوينها (بلدات، وساحات، ممالك وولايات وامبراطوريات)، فكانت دائمًا محكومة بالسلطة المأزومة ومكانًا للورطة والانتظار. فالشخصية الرئيسية التي تلعبها فيروز غالبًا عمل الأخوان رحباني مع صباح في «موسم العز» (1960) و«دواليب الهوا» (1965) ومع رونزا وأخريات في «المؤامرة مستمرة» (1980) و«الربيع السابع» (1982). ما تواجه التورط، فهي إما تتورط بزيجة، أو بالترويج لمحطة متخيَّلة، أو بمجابهة مع مرشح الانتخابات، أو بحماية البيوت الفارغة من مغادريها، أو بتسيير أمور الأهالي عبر سرقة ختم، أو بمحاكمة، أو بانتقام مؤجل، أو بتخبئة الإمبراطور الهارب.
تحظى التنويعات المدينية التخييلية عند الأخوين بأسماء أو بأنماط حكم تفترق عن الواقع اللبناني والعربي كي تنفي عن نفسها لبنانيتها وعروبيتها، في معرض انتقاد ما وصلت إليه هذه اللبنانوية والعروبة، أو في محاولة حثيثة للدفاع عمّا كان. إنها مدن في مسرح شبيه بأغنيات الأخوين التي «لا شرق فيها ولا غرب، ولا شمال ولا جنوب، بل دولة رحبانية فيروزية قائمة بذاتها»، بحسب جان شهيد في عرضه لمسرحية «يعيش يعيش» في الشبكة.
لكنَّ هذه التنويعات، رغم هربها من الواقع في الإسم المتخيَّل أو في إضمار الاسم أو في فانتازية شكل الحكم، تبقى لبنانية وعربية في المعنى المستقبَل عند مشاهديها ومستمعي تسجيلاتها. ومن هنا، جاء انتقاد هذه الدولة الرحبانية وما على ضفافها من عوالم أخرى (بعض مسرحيات روميو لحود مثالًا) من داخل العائلة الرحبانية، تحديدًا من جيلها الثاني المتمثل بزياد رحباني.
النقد الزيادي
بعد مساهمات موسيقية وتمثيلية له في مسرحيات الأخوين، وبعد أن اختصر القرية إلى مقهى نخلة التنين في مسرحيته «سهريَّة» (1973)، والمدينة إلى فندق أولًا في «نزل السرور» (1974)، وبار ثانيًا في «بالنسبة لبكرا شو؟» (1978)، ومصحّ عقلي ثالثًا في «فيلم أميركي طويل» (1980)، يقدِّم زياد رحباني في مسرحيته «شي فاشل» (1983) مسرحيةً داخل المسرحية، حيث ينتقد مسرح أبيه وعمه، ويحوِّل كافة الأمكنة الرحبانية (وحتى المدينية منها) إلى كاريكاتور واحد لضيعة لبنانية واحدة واقعة في الحيرة لكنَّها لا تركع، كي لا نصفي الما شي ونصير الما حدا، بانتظار أن تخلق «المحبة والإيمان» لبنان الجديد الذي «كلو محبة وعناقيد».

ويُكمل الرحباني في تحطيمه لهذه الدولة المتخيَّلة بشكل مباشر في الجزء الأخير من مسرحيته عبر المونولوغ الشهير لأبو الزلف الذي أداه زياد أبو عبسي، واستعاده في شكل آخر مع أبو عبسي نفسه في دور «الغادر» في مسرحيته «بخصوص الكرامة والشعب العنيد» (1993)، حيث نصل في هذه المسرحية (ولاحقًا في «لولا فسحة الأمل») (1994) إلى بيروت مستقبلية تعاني من أزمة سلطوية وهوياتية حادة، حتى تنقلب مرتعًا للعبث الكامل يعود بساكنيها إلى ما قبل التاريخ. نقد زياد الرحباني العنيف لم يوقف الدولة الرحبانية أن تتمدد من ماضيها، وكأنَّ شيئًا لم يكن، وكأن حربًا لم تقع، فأعاد ابنا عم زياد، مروان وغدي، انتاج الدولة الرحبانية القديمة عبر المقاربة نفسها التي اعتمدها الأخوان، أي محدَّدةً بنظام (وأزمة) حكم، عندما قدما جمهورية مكسيتانيا في مسرحيتهما «الانقلاب» (1995)، وأكمل بعدها منصور الرحباني ومعه أسامة الرحباني في الطريق نفسه بتعاوناتهما المختلفة في مسرحيات التاريخ والأمكنة المتخيَّلة.
يوسف حبشي الأشقر وربيع جابر: طيف الصراع السياسي مُطبِقًا على الأمكنة المتخيَّلة
كفرملات
في الستينيات من القرن الماضي، في زمن الأخوين رحباني نفسه، قدَّم يوسف حبشي الأشقر «كفرملات» المتخيَّلة في الجزء الأول من ثلاثيته الروائية، «أربعة أفراس حمر» (1964). وإذا كان ظهور «كفرملات» عابرًا في الرواية الأولى التي تبدأ في ساحة البرج وحولها، فإنَّها تصير مكانًا تأسيسيًا في الرواية الثانية «لا تنبت جذور في السماء» (1971).
كما يطرح اسمها، «كفرملات» هي ترميز للتجمع اللبناني، لجميع الملات التي تصنعه، بكافة توازياتها وتلاقياتها الطائفية والجماعاتية والسياسية. إنها ضيعة مشرفة على تناقضات الواقع اللبناني قبل الانفجار الأهلي وخلاله. هي الحلم المعلَّق أحيانًا والمحطَّم أحيانًا أخرى، وإليها يعود اسكندر الحمَّاني من بيته البيروتي الحافل بالحوارات الفكرية واللاهوتية، والمتعالي كصاحبه عن روث الواقع المتوارث الذي سيقنص البطل على تخوم مقبرة في «كفرملات» نفسها في خاتمة الثلاثية: «الظل والصدى» (1989).
«كفرملات»، على عكس قرى ومدن الأخوين رحباني، لم تبقَ عند مستواها السحري، بل كانت تترجل منه إلى الواقع لتروي مسار الجمهورية الأولى.«كفرملات» المتخيَّلة كما يصفها الأشقر في إحدى قصص مجموعته «آخر القدماء» (1985) هي: (..) ضيعة في العالم الجديد وليست منه، مكان مفتوح على الدنيا وليس فتحًا لها، زمن متصل كالخيط لا ملحوم كالسلسلة. ولأنها ساحرة، والسحر وحده لا يصطلَح فيه، وأسماؤه آتية من وراء الإدراك: ضبابية، غير معبرة، تُحزَر ولا تُحلَّل، يُشعر بها ولا يُبَرهَن عنها، ولا جسم لها وتتجسد.
لكنَّ «كفرملات»، على عكس قرى ومدن الأخوين رحباني، لم تبقَ عند مستواها السحري، بل كانت تترجل منه إلى الواقع لتروي مسار الجمهورية الأولى، بدءًا من توجسات الصعود الستيناتي للبلد، مرورًا بإرهاصات الحرب، وصولًا إلى احتدامها وخرابها الأخير. في العام 2001، سيطرح الكاتب سمير سعد مراد ومعه المخرج إيلي أضباشي في مسلسلهما «من برسومي، مع أطيب التمنيات»، محاكاة أخرى للضيعة اللبنانية المختلَقة المتشكلة على خلفية الصراع السياسي. «برسومي»، كما «كفرملات» الأشقر، هي تمثُّل تاريخي وسياسي لواقع الحياة في جبل لبنان، لكنها تسبقها في الزمن، وتقدَّم لنا عشية استقلال لبنان. «برسومي» ضيعة تحت الانتداب محكومة بجثة يتقاذفها سكانها ويخبئونها عن السلطة الانتدابية، والجثة هي جسد الاقطاعي المقتول والذي يستمر تفسخه من حلقة لأخرى ومن يد ليد، في إحالة إلى علاقات القوة في الكيان الحديث الذي سيستقل عن منتدبيه في نهاية المسلسل. إنَّ «كفرملات» تروي انحدار لبنان من أطرافه وجباله وأوديته وسهله باتجاه مدينية مركزية وبالغة التوحش هي بيروت التي سرعان ما ستأكل «كفرملات» المتخيّلة والمقدَّسة، حيث اسكندر الحماني تجيّف لإنكسار المقدس فيه، مقدّس كفرملات، مقدّس الحب، مقدّس القدّاس والزياح، مقدس التتخيتة والقبو في بيتهم فوق، وليست هناك صيغة لتحلّ محل المقدس بالنسبة للذين عرفوها، هناك تمويه فقط…

بيريتوس
بعد وفاة «كفرملات» على الورق بأكثر من خمسة عشر عامًا، سيتطرق الروائي ربيع جابر إلى التوحش البيروتي نفسه قبيل لحظة الانهيار الأول لدولة السلم الأهلي في العام 2005 في تخييل مكاني آخر. فقبيل اغتيال رفيق الحريري بأسابيع، سينشر جابر روايته «بيريتوس: مدينة تحت الأرض». نشر ربيع جابر روايات أخرى عن بيروت الخارجة من الحرب مثل «شاي أسود» (1995)، و«البيت الأخير» (1996) و«رالف رزق الله في المرآة» (1997). كما أعاد رسم بيروت التاريخية في ثلاثيته «بيروت مدينة العالم» (2003 - 2005)، ونشر عن بيروت ما بعد اغتيال رفيق الحريري في «تقرير ميليس» (2005)، وبيروت خلال الحرب في «الاعترافات» (2008)، و«طيور الهوليداي إن» (2011) التي توقف بعدها جابر عن نشر الروايات. لكنَّ التركيز على «بيريتوس..» يأتي من كونها رواية تبني بيروت المتخيَّلة جغرافيًا تحت بيروت المعروفة. يحدِّد جابر زمن روايته بزمن لاحق لانهيار برجي التجارة العالمي في نيويورك، حيث بيروت مزدحمة بمليون ونصف من أهل الخليج قدموا ليقضوا إجازاتهم فيها. وعند هذا المفترق بين زمنين، زمن انتعاش وسط بيروت المعاد إعماره، وزمن انهيار الاتفاق السوري الأميركي حول لبنان، يكتب جابر عن مدينة تحتية لبيروت، ينزلق إليها راوي روايته من فجوة سيتي بالاس.
هذه المدينة التحتية هي ما بقيت من مدينة بيريتوس الرومانية العتيقة المطمورة بعد الزلازل، التي بنيت في الأصل كمتاهة يتربع في قلبها قصر الحاكم الروماني. أما في الرواية، فتوصَف المدينة كـمتاهة من البيوت والدهاليز المنقورة في الصخر والتراب. في تخييله، يبني جابر عالمًا كاملًا للمدينة، فيصف الكهف الذي يستلقي فيه بطله في فترة تعافيه من كسور ألمّت به بعد وقوعه، حيث المسلات المتدلية من السقف، والحائط المطروش بالأبيض، والرف الحجر، والقنديل على الرف، وساعة الحائط المعلقة على بعد شبر. ومن هذا الكهف، ينطلق الراوي عبر أحاديثه مع مستضيفيه من سكان «التحت»، ليعرف أكثر عن الأحياء التحتية. فبيروت التحتية هي مدينة بخمسة أبواب تظل مقفلة دائمًا، لكن ليس وراءها شيء إلا أسطورة «ناس الوحل» الذين «يعيشون خارج المدينة، في الضواحي المهملة» حيث «لا يذهب الأهالي، وحيث يضيع كل أمل».
يعيد جابر إذًا انتاج مركزية بيروت الفوقا، التي ينفي عنها، عبر كلام الناس التحتيين، اسمها. فالناس في الأسفل يسمّون مدينتهم التحتية «بيروت»، أما المدينة التي فوقهم فيسمونها «البرَّا»، وساكنوها يصيرون البرّانيين. والبيروتان لا تحافظان على توازيهما، فالأصوات من فوق تصل دومًا للأسفل عبر طبقات من التراب والصخر. ففي أيام الحرب التي يسمونها في العالم السفلي «الوقت الأسود»، كانت بيروت التحتا تهتز وسقوفها تتصدع وتسقط، بينما يدخل الدخان الأسود من شبكة التهوئة ويقتل الأهالي. أما قبل الحرب، فكان العالمان يندمجان في زيارات استثنائية، فالناس كانوا يأتون من «برّا» في موجات من الجياعى والهاربين.
هذا التوازي والاندماج، يفنِّد عباس بيضون في مقالته «بيريتوس وبيروت» (عدد السفير 19/ 1/ 2005) العلاقة بين البيروتين، فيكتب أنّ بيروت السفلى إذا جاز القول هي مؤشر ما على بيروت العليا، حيث بيروت السفلى هي الوجه الآخر، المرآة الأخرى لبيروت العليا ويتقابلان بإحكام، ويكمل بيضون أنَّ بيريتوس هي إنذار لبيروت، إن لم تكن كناية كاملة عنها. إنها موجودة دائمًا تحت بيروت العليا ونموها السرطاني، ويتساءل إن كان ربيع جابر يقول، أو أنه يقول دون قصد ولا إرادة إنه رغم كل الظاهر المزدهر فإننا ننتج فقط خلاصة حياة وفضلات حياة وإننا في حقيقة الأمر نصنع اندثارنا وموتنا. يدفع الراوي في صفحات متقدمة من الرواية لمقارنة أحياء بيروت البرانية وبيروت التي هو فيها تحت، فيرسم مستطيلين وخريطتين:

لكنَّ تخييل بيروت التحتا لا يتوقف مع جابر عند جغرافيتها فحسب. ففي الدهاليز الضيقة تصير العيون مدخلًا لوصف الناس تحت. الأهالي الذي يزورون الراوي في بداية الرواية عيونهم كبيرة واسعة بارقة، ويحيط ببؤبؤيْ ياسمينة التي تعتني بالراوي بياضٌ بلون بنفسجي معتكر بحمرة خفيفة، أما أناس الوحل الأسطوريون، فعيونهم صغيرة قاتمة السواد، صغيرة كحبات العدس.
يمتدّ تخييل جابر في مكانه المصنوع إلى طريقة عيش الأهالي تحت. فهم يجمعون السمك الأعمى المربى في أجران عميقة، بفتحات عالية، تشبه فتحات الآبار، ويجففونه ليصير كما الجلود ثم يطحنوه كالطحين، ويبلّونه بماء وخميرة قبل أن يعجنوه ويخبزوه ويأكلوه. وهم لتيسير أمورهم بين بعضهم، يعتمدون الصدف البحري كعملة نقدية.
ومثل الراوي، فإنَّ بيروت المتخمة بالرخاء الاستثنائي فوق مريضة وتنتظر شفاءها (ربما كي تستعيد اسمها). لكن على الرغم من ذلك، فإنَّ الراوي يمنِّي نفسه بشفائه، وهو عندما يأتي ذلك اليوم، يوم شفائه، سيمشي في شوارع «مدينة الأرض» ويدخل بيوت وساحات «المدينة التي يسمّونها بيروت».
من جبور الدويهي لدراما «حزب الله» وصولًا إلى «الهيبة»: جغرافيا حكايا الجماعات
جغرافيا جبور الدويهي
في كتابته الروائية، غالبًا ما لجأ جبور الدويهي لتخييل المكان ضمن المكان. كتب جبور الدويهي أيضًا عن أمكنة حقيقية أيضًا من دون أن يخيِّل أسماءها. ف«حي الأميركان» (2014) انتقاء حقيقي من طرابلس يبني على ظاهرة تصدير أبناء المدينة كجهاديين إلى العراق. فإذا كان ربيع جابر قد رسم حدًّا فاصلًا بين بيروت الحقيقية وبيروت المتخيَّلة، فإنَّ أمكنة الدويهي المتخيَّلة كانت تُقدَّم مع موضعة جغرافية صريحة، حيث تقع أغلبها في الشمال أو الجبل اللبناني. بينما تظهر بيروت عابرةً في روايات الدويهي التي تدور أحداث معظمها في الشمال أو الجبل اللبناني، فإنَّ له رواية كانت بيروت فيها هي المركز («طُبِعَ في بيروت» (2016)). أثارت «طبع في بيروت» الجدل عند صدورها، فأحمد محسن في نقده لها بجريدة الأخبار (عدد 18 كانون الثاني 2017 - جبّور الدويهي: دليلك إلى «الشيعي المعاصر»)، يشرح أنَّ قراءته للرواية جعلته أمام «صدمة «دلالية»» لتسجيل كاتبها «موقفاً ميشال شيحاوياً، ضدّ القادمين من الأطراف إلى المدينة، وإلى عاصمة «لبنان الكبير» في الرواية»، ويرى محسن أنَّ الرواية تسجِّل «موقفًا ضد الشيعة» عبر شخصية «حسين الصادق» التي يجد محسن أنَّ الرواية تقدمها كـ«الشيطان». نقد محسن يحيل إلى جدلية تأريخ بيروت كمركز في روايات الجماعات ونقدها.
في «مطر حزيران» (2006) ورغم أنَّ الدويهي يختلق اسمًا متخيَّلًا لقريته هو «برج الهوا»، فإنه يستعيد بصراحة مجزرة كنيسة مزيارة في 16 حزيران 1957 ويثبِّت استعادته في عنوان الرواية.
من جهة أخرى، «عين وردة» (2002) هي قرية مختلَقة، لكنها ذات سمات محددة. فـ«عين وردة» مشهورة بقديسها مار نهرا شفيع البصر والقادر على شفاء المي الزرقاء والرمد الربيعي، وهي تقع على الطريق لبلدات الاصطياف في «جبال بيروت»، عند منحدر من منحدرات جبل لبنان الغربية، وتحظى بهضاب من الحور الخشخاش وجلول صخرية هي مرتع للأفاعي وتوت العليق، مع بقايا نادرة لم تُقتَلَع من سكك خط قطار بيروت -دمشق.
أما «حورا» في «شريد المنازل» (2010)، والمقصود بها على الأرجح «كفرحورا»، فهي ضيعة قريبة من طرابلس ذات سطوح قرميدية تقع بين جبل صخري يسمى «باب الهوا» ودير القديس يعقوب الحبشي. و«حورا» تصير مقصدًا للمصطافين عندما يشتري فيها شقيق مفتي طرابلس بيتًا محاطًا بأشجار الكرز، والطريق إليها تلتف حول المرتفعات وتطل على الأودية المسكونة بالأديرة، وفيها البيت المستأجر لعائلة العلمي الذي يطل على المقر الصيفي للبطريركية المارونية. و«حورا» كما «عين وردة» لها قديسها، القديس ماما، وهو جندي روماني اعتنق المسيحية وصار شفيع العرسان فيها.

مخيال حزب الله
فالجنوب في المسلسلات التي عُرضَت على قناة المنار حاضر وهائم معًا، آني وتاريخي، فقاعة وعالم ممتدّ، وفيه تُخيَّل الأماكن عند الضرورة.بدورها، فإنَّ لدراما حزب الله التلفزيونية، التي اضطلع بإنتاج أغلبها مركز بيروت الدولي، حصتها من إنتاج المكان المتخيَّل، حيث الجنوب جاهز لتلقُّف التخييل. فالجنوب في المسلسلات التي عُرضَت على قناة المنار حاضر وهائم معًا، آني وتاريخي، فقاعة وعالم ممتدّ، وفيه تُخيَّل الأماكن عند الضرورة.
فـ«عين الجوزة» بعكس بعض المسلسلات الأخرى التي عرضت على قناة المنار، لم ينتج مركز بيروت الدولي «عين الجوزة». مثلًا في المسلسل المستقى من رواية بالاسم نفسه لإبراهيم فضل الله (2013)، أهدى المؤلف روايته لأمين عام حزب الله، وذكر الأخير قراءته لها في مقابلة مع جريدة الأخبار، ما دفع لإنتاج بعض الرواية تلفزيونيًا. والمنتج بعضها الروائي تلفزيونيًا (2015)، هي قرية متخيَّلة عند الحدود اللبنانية الجنوبية تعيش صراعًا بين المزارعين ووجهاء القرية المتحالفين مع الفرنسيين بين عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي، للدفاع عن الأراضي وصولًا لتشكيل حركات مقاومة ضد الفرنسيين وأعوانهم في الحكم من مختار ورئيس مخفر وآخرين.
ومثل «عين الجوزة»، يُبقي إنتاج الحزب الدرامي منذ عام 2011 كل من (وما) هو خارج الطائفة الشيعية على تخومها، خيرًا وشرًا. بعض المسلسلات التي عرضت على قناة المنار تشمل: «الغالبون» (2011 - 2012)، «قيامة البنادق» (2013)، «ملح التراب» (2014)، «درب الياسمين» (2015)، «عين الجوزة» (2015)، «بلاد العز» (2017)، «بوح السنابل» (2018)، «فرج ورحمة» (2019)، «مرايا الزمن» (2020)، «وصية أب» (2021)، «ظل المطر» (2022)... إنه إنتاج، المكان المخيَّل فيه هو جنوب دائم، أو موصل إليه.
الهيبة
ولدت قرية «الهيبة» الحدودية في المسلسل ذي الانتاج اللبناني (شركة سيدرز آرت برودكشن - (صباح إخوان))، والكتابة والتمثيل السوري/اللبناني بعد الثورة السورية، وقبل الانهيار اللبناني بأعوام قليلة (2017 - 2021).
ففي زمن ما بعد تحلُّل الدولة السورية وانكشاف الحدود اللبنانية السورية على تهريب السلاح، تستعيد هذه الملحمة الدرامية صيغة الانتقام على أكثر من مستوى حكائي، وتستولي على فكرة الطفّار معيدةً إنتاجها في حبكة درامية تنزع منها عصبها الاعتراضي على الدولة المركزية التي تنتج الحرمان في قرى الأطراف. لا بل تصل «الهيبة» في النهاية إلى تنسيق دؤوب مع الدولة، وتصير مسرحًا للدفاع عن البلد ضد الميليشيات الجهادية السنيَّة.
أما البطل، فليعيد إنتاج رجولته وهيبته دومًا كما اسم ضيعته، فإنه يحظى بزوجة أو حبيبة جديدة في كل جزء من المسلسل. ففي الجزء الأول يحظى بأرملة أخيه، وفي الجزء الثاني يحظى بزوجة من العائلة العدوة، وفي الثالث ينهمك بحب جارته الإعلامية، وفي الرابع يستميل ابنة خاله، وفي الخامس يتقرَّب من ناشطة حقوق إنسان.
لـ«الهيبة» في «الهيبة» ساحة يظهر فيها وفي جوارها مقهى ومكتب مختار وملحمة وفرن مناقيش ومحل حلاقة وصيدلية. كما أنَّ «الهيبة» تحظى في جزئها الأخير بسدٍّ مائي لتصل الخطر الجهادي بخطر الطوفان المحدق. لكن بخلاف هذه العناصر التجميلية، فإنَّ قصور ومحدودية تخييل «الهيبة» هما من هيولية هويتها الدرامية المشتركة اللبنانية/السورية.
في الأمثلة الثلاثة (روايات الدويهي، ودراما الحزب، والهيبة في الانتاج المشترك)، تُخيَّل الأمكنة ضمن جغرافيا محدَّدة إما دفع إليها مشروع الكاتب الروائي (الدويهي)، أو المشروع الدعائي (دراما الحزب)، أو استهلاك الإنتاج التجاري لمفاعيل اللحظة السياسية (الهيبة). وبذا، تنتهي الأمكنة المخيَّلة كذريعة لتقديم حكايا الجماعات بتفاوت في مستوى الطرح. يبتعد عمل الدويهي الروائي عن الدعائية المباشرة كما في دراما الحزب، أو الاستهلاك التفريغي لظاهرة الطفار كما في «الهيبة»، لكن للدويهي رأي سياسي لا يخفيه أنتج منطق رواياته وتشابك أحداثها والعلاقات بين شخصياتها وأدوارها على خلفية الأحداث السياسية التي تتكئ عليها رواياته. تتضمن مقالة أحمد محسن عن «طبع في بيروت» نقدًا لهذا المنطق.
من «كفرناحوم» إلى «كفرحلم»: انعدام الجغرافيا والترويج لـ«نظام العدالة»
من «كفرناحوم»
بعد ظهور خجول لبيروت غالبية مشاهد الفيلم الخارجية تقع في الجميزة، من دون أن تُذكَر المنطقة بالاسم صراحةً، والفيلم مهدى في نهايته «إلى ست الدنيا، بيروت». في فيلمها الأول «سكر بنات» (2007)، تستقر نادين لبكي في فيلمها الطويل الثاني «وهلأ لوين؟» (2011) على ثيمة الضيعة المختلَقة، لكنَّها ضيعة معدومة الاسم جغرافيتها صعبة التحديد ومعزولة عن باقي البلد (إلا من طائفتيه الكبيرتين). ما هو واضح في مشاهد الفيلم أنَّ القرية تقع بالقرب من سفوح جرداء، أما البيوت فيها، فيفصل بينها مساحات ترابية. لكن عدا ذلك، فإنَّ القرية تُقدَّم لنا فقط بوصفها تجمعًا للتضاد الإسلامي/المسيحي المستعاد على أنقاض الاشتباك الشيعي/السني في 7 أيار 2008. بمعنى آخر، يستعيد هذا التقديم خلافًا معدوم الصلاحية ومجمَّدًا في السياسة عبر تفاهمات وأحلاف، لا لشيء إلا للقفز عن نقاش الاشتباك الشيعي / السني في 2008 وتسطيحه.
تحضر الجثَّة في «وهلأ لوين؟»، يذكِّر التنازع على تخبيء الجثة في «وهلأ لوين؟» (2011) بجثة مسلسل «من برسومي، مع أطيب التمنيات» (2001). لكنَّ ظهورها إلى العلن من قلب البئر التي خُبِّئَت فيه قد يؤدي إلى تعاظم فتنة قد وقعت بالفعل. ولذا، فإنَّها جثَّة لن تظهر إلا عندما يُمكِن دفنها. ومع ظهورها، بعد تغيير الأمهات لدياناتهن، تصل الجثَّة إلى مفترق طريق وتصير مقبرتها النهائية موضع السؤال الأساسي الذي هو عنوان الفيلم. هل ستُدفَن في المقبرة الإسلامية أم المسيحية؟ يحاذر الفيلم في نهايته أن تمتلك جماعة من الاثنتين الجثة، فيجعلها جثَّة مُنذِرة فقط لا تصل بين الجماعات بل تبقى بينهما. إنَّ تبادل طوائف الأمهات في «وهلأ لوين؟» لا يوصل إلى ردم العلاقة بين الطائفتين عبر الجثة، بعكس جثَّة الإقطاعي في «برسومي» التي يمتلكها كل الأهالي، أو جثَّة نظام العلمي في رواية جبور الدويهي «شريد المنازل» (2010) التي يقرِّر الدويهي في نهاية الرواية دفنها في بستان مربّيَيْه رخيمة وتوما المسيحيّيْن حيث تظللها دومًا اليراعات المضيئة التائهة.
في فيلم لبكي الثالث، «كفرناحوم» (2018) هي مجرد تقديم إسمي في العنوان لجحيم بيروت ولبنان الآتي، حيث تختصَر بيروت الرمادية بموبقات الطبقات الدنيا. يبقى الفيلم عند سطح المشاكل الاجتماعية التي تختصَر بذمِّ «عادات» الجماعات المدقعة في فقرها، مبتعدًا عن الغوص في بنيوية النظام الذي أنتج هذه المشاكل، فيقدم طرحًا تقنيًا وطبقيًا لجحيمٍ تلعب فيه قوى الأمن (ممثلةً الدولة) دور المخلِّص وترسم في نهاية الفيلم ابتسامة نادرة على وجه الطفل الذي سيحظى أخيرًا بأوراق رسميَّة. الفيلم الذي اختُصِر من اثنتي عشرة ساعة لما يقارب الساعتين أبقى في أحد مشاهده على زيارة من ناشطين خيريين لمركز احتجاز رسمي تتجمع فيه العاملات المهاجرات في غرف ضيقة خلف القضبان. في المشهد، يحمل الناشطون ألعابًا وآلات موسيقية، فيغنون ويرقصون أمام القضبان محاولين تسلية العاملات في ما يبدو تعاطيًا مع السجينات كـ«قِرَدة في قفص» كما أشارت سناء الخوري في مقالتها «نادين لبكي في «كفرناحوم»: محبوبة اللبنانيين وعقدة المخلّص» بموقع حبر.
إلى «كفرحلم»
ومثل «وهلأ لوين؟»، تدور أحداث مسلسل «ع أمل» كتبت نادين جابر مسلسل «ع أمل» (٢٠٢٤)، وأخرجه رامي حنا، وأنتجته شركة «إيغل فيلمز». الذي عرض في رمضان الماضي (2024) في قرية «كفرحلم» المتخيَّلة معدومة الجغرافيا اللبنانية والباحثة عن العدالة والخلاص.
لا نعلم أين تقع «كفرحلم». نسمع عن «السوق العريض» فيها، ونعرف أنَّ القاطنين فيها ينزلون منها إلى بيروت، لكن أي طرق يسلكون، لا نعرف. يراد لـ«كفرحلم» أن تجمع كل الضيع اللبنانية في ضيعة واحدة، لكنها كما اللهجة فيها، مخلوقة خصيصًا للهرب من مأزق الاتهام الذي قد تنتجه في ما لو لم تُخلَق. وحدهما الحجاب والصلاة الإسلامية يؤكدان أنَّ «كفرحلم» ذات غالبية إسلامية من دون أن نعرف إن كانت سنية أو شيعية.
وعلى النسق الهارب نفسه، ما من جغرافيا محددة لـ«كفرحلم» يرغب المسلسل في التركيز عليها، ولا بمجتمع حي يهتم بتشريحه. «كفرحلم» هي مجرد ديكور يجمع كل الموبقات الذكورية، في عائلة ونصف، إحداهما هي عائلة حلم نفسها، بينما نصف العائلة الأخرى رديفة لعائلة حلم بمصاهرتها إياها، ولا تملك حتى حق الحصول على اسم. أما أهالي الضيعة، فيعبرون في مشاهد معدودة ككومبارس للنميمة أو لتمرير رسائل مباشرة تشرح أن رجعيَّة رجال عائلة حلم مثال استثنائي في القرية المتخيَّلة لا يشمل كل أهالي القرية.
«كفرحلم» ليست ردًا نسويًا على «الهيبة» كما قد يبدو للوهلة الأولى من موضوعها الحكائي. فالموبقات الذكورية فيها هي موبقات الافتراق عن المعنى الحقيقي للرجولة. والبطلة الرئيسية تحاول أن تستعيد الحلم في اسم الضيعة التي تسميها في سيرتها الذاتية التي تود توريثها لبنتيها: «كفركابوس». إنها كفركابوس أشباه الرجال، وكفرحلم الرجولة الحقة التي مع استرجاعها ستتحقق حقوق النساء.
و«كفرحلم»، كما «كفرناحوم» وانتاجات لبنانية أخرى، تقدِّم الإعلام مسرحًا للعدالة. لكن كيف ستتحقق عدالة البطلة وتصير «كفرحلم»، كفرحلم فعلية لا كابوسًا؟و«كفرحلم»، كما «كفرناحوم» وانتاجات لبنانية أخرى، تقدِّم الإعلام مسرحًا للعدالة. لكن كيف ستتحقق عدالة البطلة وتصير «كفرحلم»، كفرحلم فعلية لا كابوسًا؟ في الحلقة الأخيرة، ستترك البطلة عملها مفضِّلةً ممارسة أمومتها المؤجلة والاهتمام بابنتيها اللتين صارتا في أواسط عشرينياتهما، ورعاية زوجها (حبيبها السابق) الذي ضربها من الغيرة، وتعلمنا أنها لم تكن مؤهلة لحل مشاكل الناس، وتعيد طبع سيرتها في كتاب، وتصير ممثلة لجمعية «حماية» المدافعة عن حقوق الأطفال، قبل أن تمشي في مشهد أخير مع ابنتيها في سهول «كفرحلم» السحرية.
كل ما في «كفرحلم» حاضر لينتج عكس معناه الظاهر. الحلم فيها كابوس تسطيحي لا يستطيع أن يقدِّم العلاقات البنيوية للعنف الذكوري في مجتمعها الضيق المصنوع، وهذا نتاج دراما لا ترغب في بناء بانوراما اجتماعية، لأنه دون قدرتها على طرحه، ودون رغبة مشاهدها المستهدف كما تراه. «كفرحلم» هي كابوس القضية في صيغتها الناشطية والتكنوقراطية. ديكور لقضية محدَّدة في مكانٍ خاوٍ.
نهاية الرحلة، حتى الآن…
بالنظر إلى سير إنتاج الأماكن المتخيَّلة، يمكن ملاحظة اضمحلال الأسباب والمعاني التي حفَّزت خلقها. إنها رحلة من المعنى إلى اللامعنى، ومن بناء الرمز اللبناني، مرورًا بترميز انهياره، نهاية باستخدام التخييل المكاني لاستسهال الهرب من الاتهامات.
فإذا كان الأخوان رحباني قد قدّما معالجات سحرية تحاول أن تعلو في طرحها الترميزي عن لبنان باتجاه عالم رحباني خالص، فإنَّ كفرملات يوسف حبشي الأشقر تبقى الطرح الأكثر اكتمالًا في ترميزيته عن لبنان ما بعد الاستقلال وحتى حربه الأهلية. وبينما ينصب جابر مرآة تخييلية تعيد إنتاج بيروت وتحاول البحث عما هو خلف النموّ المضطرد والمتوحش لها، يركّز الدويهي على تخييل قرى الشمال والجبل اللبناني متّكئًا على رؤيته للتاريخ اللبناني الحديث. أما دراما حزب الله، فتطرح إجابة عن سؤال «لبنانية» الحزب، لتنتج وبشكل مباشر لبنانًا شيعيًا عبر قصص مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والانتداب الفرنسي والتصدّي للمؤامرات التي تستهدف البيئة.
هذه الرحلة التخييلية تصل إلى نهايات بائسة مع «كفرناحوم» و«الهيبة» و«كفرحلم» حيث لا تعود الأماكن المتخيَّلة إلا ذرائع لتقديم مواضيع محددة منزوعة النسق الاجتماعي والطبقي والطائفي. إنها ليست أعمالًا «سياسية»، بل أعمال «إنسانية»، كما يقدِّمها أصحابها والمحتفون بها، وهو تقديم سطحي (وسياسي!) يختصر «السياسة» بالتطرف، و«الإنساني» بالمتوازن واللاسياسي.
يحيل ذلك التقديم الإنساني/التكنوقراطي مجدّدًا إلى شكل الإنتاج الفني والأدبي في الزمن الحالي حيث يُستبدَل جهد إنتاج البانوراما الاجتماعية بصناعة محتوى محلّيته شكليَّة وعروبته المشتركة وحتى عالميته المرتجاة أسهل استهلاكًا وأقصر صلاحية، يساعده في ذلك تدهور مكانة الكيان اللبناني وانتفاء معناه. وتلك، على الأرجح، نهاية كفرناحومية بامتياز للمعاني التي حفَّزت التخييل المكاني اللبناني وكمنت فيه.