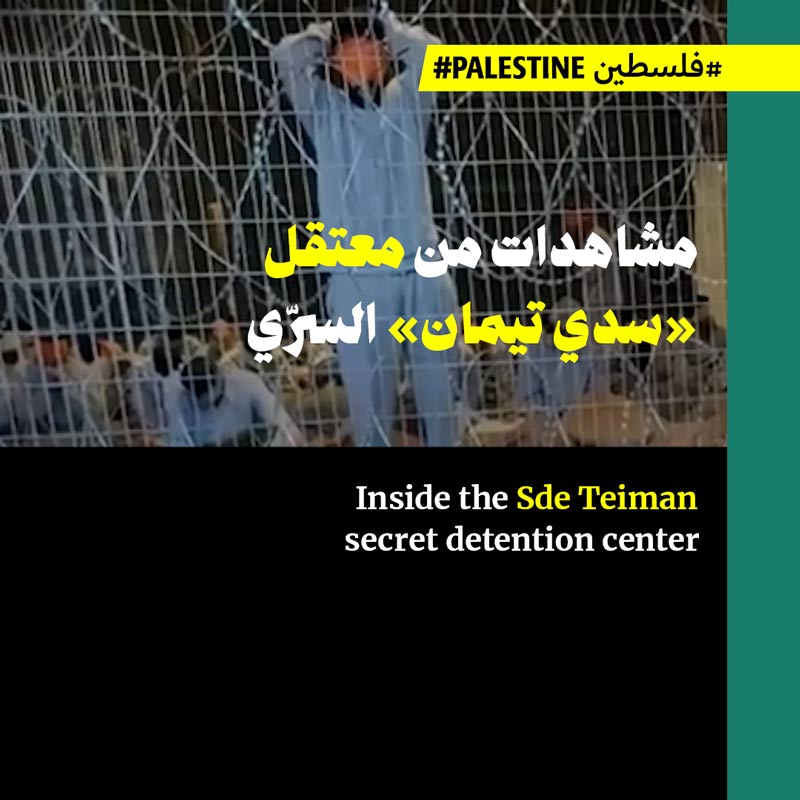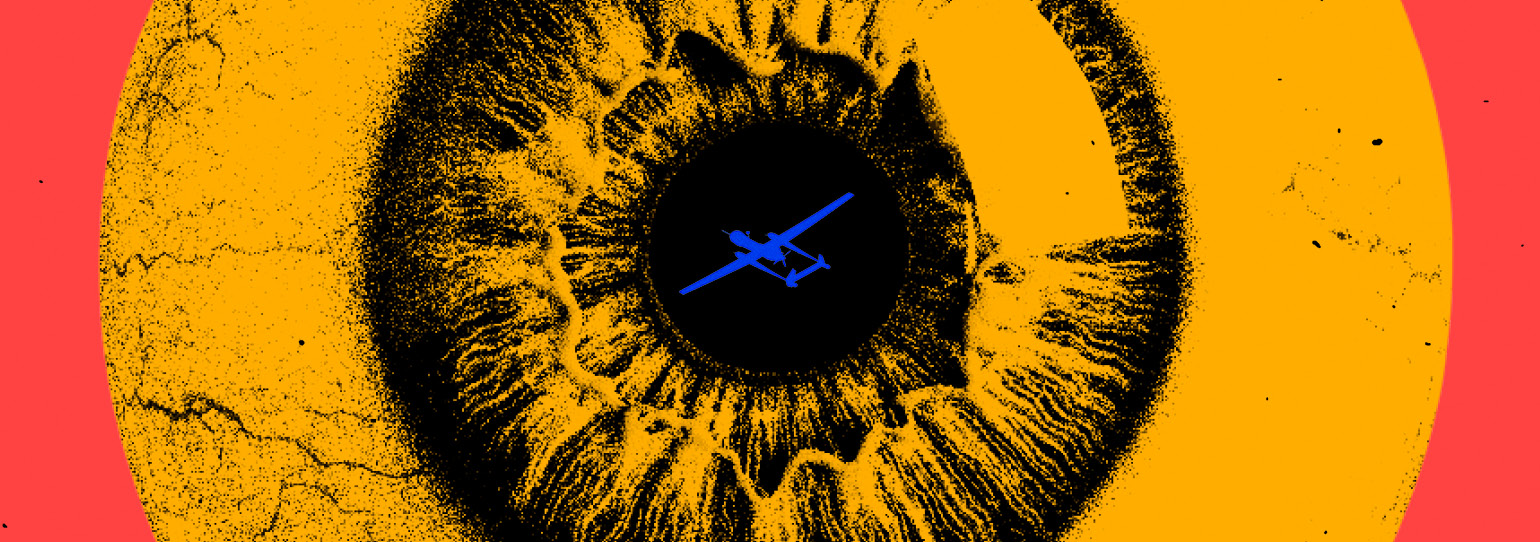
ماذا يعني أن يعيش المرء تحت المراقبة الدائمة؟ أن يعرف عدوّه أدّق تفاصيل حياته، إن لم يكن يعرف عنه أكثر مما يعرف هو عن نفسه؟ أن تكون كلُّ حركة مراقَبةً ومسجلةً وموثّقة، حيث لم يعد هناك مساحة خاصة لإنسانية مَن هو مراقب؟ هذا هو الوضع في غزة، كما يوثّقه محمد مهاوش، وضع سمح باستهداف كل قاطن هناك في خصوصية حياته. لكنّ غزّة ليست استثناء، فهي المختبر لأساليب الحكم القادمة.
حاجز نتساريم
في الأيام التي سبقت وصولنا إلى حاجز نتساريم في غزة، في أوائل نيسان 2024، كنا قد جهزنا أنا وزوجتي نسخةً منقّحة عن أنفسنا. صحيح أننا عشنا ستة أشهر من الحرب، لكنها كانت المرة الأولى التي سنقف فيها أمام جنود إسرائيليين. وبعد أن رأينا صحافيين يُقتلون ومستشفيات تُقصف ورصاصًا يمزّق أجساد الأطفال، فهمنا أن الطريقة التي سنروي بها قصتنا للجنود الإسرائيليين ستحدّد مصير فرصتنا في الخروج، وبالتالي حياتنا.
قرّرنا قول الحقيقة، لكن بالاقتصار على الأجزاء الأقل إثارةً للريبة: إننا عائلة نازحة تطيع أوامر إسرائيل، التي تصلنا عبر منشورات تُلقى من الجو أو مكالمات هاتفية تأمر السكان بالإخلاء إلى الجنوب، بعدما دمّر القصف حيّنا في مدينة غزة على مدار الشهور التي سبقت. سنقول إن أسماء- زوجتي- حامل، وإن ابننا رفيق، البالغ عامين، أوهنه سوء التغذية.
قرّرنا ألّا نعرّف عن أنفسنا كصحافيين، وألّا نُظهر أنّ هذه الرحلة ما هي إلا بداية هروبنا من غزة، أو أننا نخطط عبور معبر رفح إلى مصر. تمرّنتُ على إجاباتي حتى أصبحت الكلمات باردة في فمي. كنت مستعدًا للتحدث فقط كأبٍ وزوج يحاول النجاة.
سرنا بمحاذاة ساحل المتوسط، على طول طريقٍ أنهكته القذائف. كانت عجلات عربة طفلنا تحتكّ بالإسفلت المتشظي، فيما تحوم الطائرات المسيّرة فوق رؤوسنا. كانت بطاقة هويتي الخضراء، التي تصدرها إسرائيل ويحملها الغزيون، في جيبي. بعد نحو ساعتين من المشي، وصلنا إلى نتساريم. كانت هذه المنطقة في الماضي امتدادًا ساحليًّا للمدينة، حيث تتنزه العائلات، لكنها تحولت الآن إلى ممرّ عسكري يعج بالدبابات والسواتر الرملية والماسحات الضوئية. أمامنا دبابتان، وقناصة يعتَلون أكوام الحطام، وصفٌّ من الجنود تتضح ملامحه مع كل خطوة.
عند الحاجز، أمر الجنود الناس في مجموعاتٍ من خمسة أشخاص. أبقيت عينيّ على رفيق، فيما لوّح جندي لنا بالتقدّم نحو كاميرا بدت كعدسة داكنة خلف زجاجٍ على ترايبود، يومض تحتها ضوءٌ أحمر. أمسكت أسماء بيد ابننا، بينما كان الجنود يراقبون شاشةً خلف الكاميرا. في البدء، تقدّمت أسماء ورفيق، حدّقنا في الكاميرا وحبسنا أنفاسنا، ننتظر إشارة الإبهام التي اعتاد الجنود استخدامها للسماح بالمرور، بينما كان آخرون يُسحَبون جانبًا.
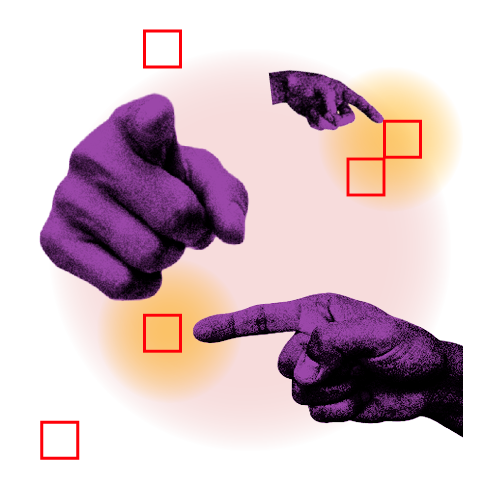
طالت الثواني. نادى الجندي أخيرًا: محمد. لم أتحرك في البداية، فاسمي شائع، إلى أن نطق باسم عائلتي. شعرتُ بأنفاسي تنقطع. كان وجه الجندي محجوبًا وبندقيته معلّقة على صدره، حين أشار إليّ بالتقدم. لم يكن خوفي مما قد يكتشفونه عني، بل مما يعرفونه سلفًا. كانت هويتي لا تزال في جيبي. زالت النسخة المنقّحة التي تدرّبتُ على تقمصها، ولم يعد أي شيء يجدي الآن. لقد جرى تأكيد هويتي للتوّ.
نظام المراقبة المستمرّ
لا يمكن التعرّف على غزّة التي خلّفها العدوان الإسرائيلي في أعقاب 7 أكتوبر. لم تقم حملة القتل الجماعي وتمزيق المجتمع الغزي وتدمير السكن عبر القنابل والرصاص والدبابات وحسب، بل قامت أيضًا على منظومةٍ لمراقبتنا والتحرّي عنّا وجمع بياناتنا من خلال طائرات مسيّرة تحوم بلا انقطاع، وطائرات كوادكابتر تهبط قرب النوافذ وتتسلّل إلى البيوت، وأنظمة مسح للتعرّف على الوجوه عند الحواجز، وتتبّع تحركاتنا عبر هواتفنا ومكالمات تشوَّش قبيْل الغارات الجوية. كان الجيش الإسرائيلي يوظّف الذكاء الاصطناعي لوضع قوائم الاغتيال، ويراقب حساباتنا على مواقع التواصل، ويخزن تسجيلات مكالماتنا بالجملة.
حاول الصحافيون والباحثون الحقوقيون والقانونيون دراسة أجزاء من بُنية المراقبة هذه في غزة. لكنّ ما غاب، إلى حدّ كبير، هو فهمُ الأثر المباشر لهذه التقنية؛ كيف وقعت على الأجساد والمنازل والأحياء؟ كيف أعادت تشكيل حياة من أُجبروا على العيش داخل هذه المنظومة، وكيف أعادت ترتيب عقولنا؟
ردًّا على قائمة من الأسئلة، نَفَى الجيش الإسرائيلي الادعاءات بأنّه يوظف أنظمة ذكاء اصطناعي لاختيار أهداف للهجوم بشكل مستقلّ أو أنه يهاجم أهدافًا بما يتنافى مع القانون الدولي. ووصف هذه الادعاءات بأنها كاذبة تمامًا. كما قال إنّ القوات الإسرائيلية لم ولن تستهدف الصحافيين عمدًا، وأضاف متحدث باسم الجيش إنّ القوات الإسرائيلية ملتزمة بالقانون الدولي وتعمل وفقًا له.
تمكنتُ من الخروج من غزة بعد يومين من مواجهتي مع الجنود الإسرائيليين عند نتساريم. على مدار العام الماضي، بمساعدة زميلين لا يزالان داخل غزة، استمعتُ إلى شهادات أكثر من عشرة أشخاص يعيشون تحت نظام المراقبة المستمر هذا. أكتفي بذكر أسمائهم الأولى، فذكر الأسماء الكاملة في تقرير عن المراقبة أشبه بتسليمها للاحتلال.
كان أحد هؤلاء مروان، إداريّ في إحدى مستشفيات مدينة غزة، يبلغ الستين من عمره، وقد اعترض في البداية على طبيعة أسئلتي في ظلّ أهوال المجازر. قال مروان: شو هتفرق يعني إنه اطّلع على خصوصيتي في الفيسبوك، ولّا سمع كل مكالماتي ولّا راقب بيتي؟
لكن سرعان ما استرسل في الحديث عن إدراكه بأنه مراقَب على الدوام وكيف عقّدت المراقبة عالمه وضيّقت نطاق حياته. قال إنه بات يتجنّب الاتصال بأخيه، خوفًا من أن يسأله عن إطلاق الصواريخ من المنطقة أو ما إذا كانت القوات الإسرائيلية قد وصلت إليها، وقلَقًا من أن تُساء قراءة هذه الكلمات أو يحرّفها من يتنصّتون في الخفاء. وصف مروان أيضاً انهيار التواصل نفسه؛ كيف يتسلّل الخوف إلى الأسرة، مكالمةً تلو الأخرى، إلى درجة يصبح فيها التعبير عن الحبّ مدعاةً لتعريضهم للخطر.
أمّا خالد، الذي عمل سائقًا لسيارة إسعاف في مستشفى العودة لنحو ثلاثة عقود، فرَوى ما حدث معه أثناء استجوابه. أظهر له ضابط إسرائيلي رسالة نصية خاصة كان قد أرسلها إلى أسرته. قال خالد: كل شي نحكيه، يشوفوه. كانت الرسالة عادية، لكن الهدف، كما يراه هذا الأب الستيني لسبعة أبناء، كان إثبات مدى قدرتهم على اختراق حياته الخاصة.
كما وأخبرني آخرون بأنهم اضطرّوا إلى إخماد أفكارهم، كما لو أن المحققين والمتنصتين قادرون على كشف ما يدور في أذهانهم. قال لي رجلٌ يُدعى محمد: ما فش حدا ما عندُه ميول [سياسية]، فقتلتها. ممنوع تحكي فيها، سكّر بالمفتاح.
لدى الجميع قصص عن مراقبتهم؛ منهم ماري، كاتبة تبلغ 26 عامًا، ونشأت في منزل من طابقين في الجانب الأكثر ثراءً من مدينة غزة، حيث كان الغزيون يتنزّهون على مقربة من البحر في شوارع تصطف على جانبيْها المتاجر وساحات المدارس الفسيحة. كان لمنزلها واجهة بيضاء نظيفة ونوافذ عالية وشرفة صغيرة وثمانية أشجار أروكاريا قديمة اعتنى بها والدها لتظلّل البوابة. قبل الحرب، كثيرًا ما كان المارّة يتوقفون لتأملها.
مع حلول الصيف، كان القصف قد فتح صدعًا في جزء من السطح. وفي الساعة الرابعة والنصف فجرًا من يوم 27 تموز، بينما كانت ماري نائمة في إحدى الغرف الناجية، استيقظت على صوت طنين خافت بدا وكأنه جوارها مباشرة. تجمدت، قالت لي، ما قدرت أصرّخ، ولا حتى أتحرك.
وصفت ماري الصوت بأنه لجسم مربّع داكن يحوم قرب السقف، فحدّقت فيه بلا حراك، حتى انسحب خارجًا عبر النافذة. قالت لي إنه إذا كان في وسعهم توجيه طائرة مسيرة قرب سريرها، فبالتأكيد يستطيعون رؤية كل شيء.
وبعد أسابيع من هذه الحادثة، قُتلت جارتها البالغة 35 عامًا بواسطة طائرة مسيّرة بينما كانت تنشر الغسيل على الشرفة، وبجانبها ابنها ذو الأربع سنوات، بحسب ما روت ماري. أخبرتني أنها لا تهاب الموت في حد ذاته، بل الرعب الذي يسبقه.
العيش في غزة خلال العامين الماضيين يعني فقدان كل ما هو مرئي: عائلاتنا، منازلنا، شوارعنا. لكنه يعني أيضًا فقدان ما لا يُرى، مثل الخصوصية في أذهاننا، الحميمية بين الناس، والقدرة على التعبير دون توجّس من مراقبة الآلة. أظهر استطلاع للرأي، أجراه معهد التقدم الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني قبل أسابيع قليلة من وقف إطلاق النار في تشرين الأول، أن نحو ثلثي الغزيين يعتقدون أنهم مراقبون باستمرار من قبل الحكومة الإسرائيلية.
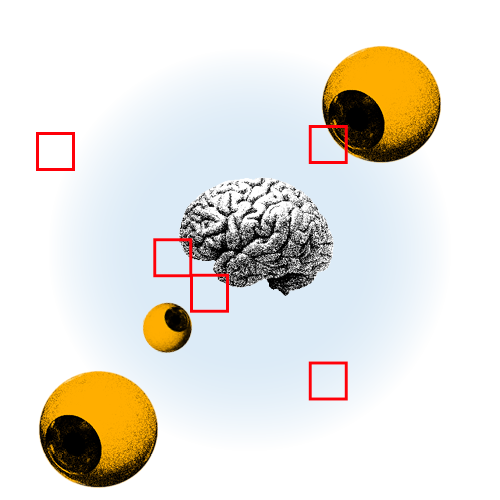
هنا تتجلّى التبعات الكارثية للتكنولوجيا، التي وفرتها شركات أميركية جزئيًا، عندما تُسند إلى سلطات تمتلك سيطرةً شبه مطلقة على سكان محاصَرين، وتواصل شيطنتهم علنًا. هذه الحالة تمثّل تتويجًا لعقود من الاحتلال المراقب، ومزيجًا من كابوس شمولي ورعب إبادي، مرسّخةً نظامًا يتطور ويتعاظم استعدادًا لما يأتي لاحقًا.
أما التحذير القديم الذي تتبناه كل الأنظمة السلطوية: إن لم يكن لديك ما تخفيه، فلا تخشَ شيئًا، فيفقد معناه في غزة.
الصهيونية نظام مراقبة
عاش أبي دائماً بالشك، لا يثق بالأشياء التي يعتبرها معظم الناس بريئة أو آمنة. حين اقتنى الجيران تلفزيونات ذكية، امتنع هو عن ذلك. قال إنها طريقة أخرى للتلصص على منازلنا. فكان لا يجيب أبي الهاتف، في منزلنا بمدينة غزة، إلا بعد صمتٍ طويل، مفترضًا أنّ هناك من يتنصّت على المكالمة، ويوجه كرسيه بعيدًا عن النافذة عند الحديث. تنبع بعض مخاوفه من حكايات عرفها قبل مولدي بسنوات ورواها جيلٌ غير جيله، فشكلت حياته، ثم حياتي. إذْ هجّرت القوات الصهيونية جدي وجدتي من منزلهما في يافا عام 1948، عند تأسيس دولة إسرائيل، ولم يتمكّنا من العودة إليه.
أصبحت بطاقات تسجيل الأونروا وقوائم المساعدات دليلهما الجديد على وجودهما كلاجئين. كانت جدتي تقول إنه حتى للحصول على الطحين من مراكز الإغاثة، توجّب عليهم الخضوع لملفات اللاجئين. تأتي السيطرة أولًا عبر الجوع، ثم من خلال الإجراءات والأوراق الرسمية.
توضّح هِلجا طويل-الصوري، الأستاذة في جامعة نيويورك والباحثة في تقاطعات التكنولوجيا والسياسة في فلسطين، أن الصهيونية وُلدت كنظام مراقبة. منذ البداية، ورثت إسرائيل أنظمة الاستعمار البريطاني والأنظمة العثمانية السابقة، بما في ذلك ملفات التعداد السكاني، والصور الجوية للقرى، والخرائط، والتحكم المركزي بخطوط البث والاتصالات. تُضيف هِلجا أن العديد من أدوات إدارة السكان كانت قائمة قبل عام 1948، حيث عملت إسرائيل على توسيع نطاقها شيئًا فشيئًا، حتى تحولت أرقام الهوية وسجلات الممتلكات وسجلات الشرطة وقوائم الضرائب وهدم المنازل جميعها إلى أدوات للفرز والسيطرة.
في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، عمل والدي في الداخل المحتل، في مصنع دواجن إسرائيلي بتصريح يومي، يعبر حاجز إيرِز صباح كل يوم ويعود إلى حي الشجاعية شرقي غزة في المساء. كانت عمليات التفتيش على الحاجز بطيئة ومضنية، فكان الجنود يتفحصون كل شيء، بما في ذلك قصاصات الورق. وقد روى لي كيف كان الفلسطينيون يعودون من جلسات الاستجواب في السجون الإسرائيلية، خلال الانتفاضة الأولى، مصدومين من كمّية المعلومات التي يعرفها الجنود عنهم مسبقًا، من أسماء أصدقائهم، إلى مواعيد عودتهم إلى منازلهم، وحتى الغرفة التي ينامون فيها.
حتى اللحظات التي بدت واعدة، وكأنّها تمنح الفلسطينيين قدرًا من الاستقلال، انتهت في الواقع بتشديد قبضة السيطرة. فاتفاقيات أوسلو، التي قُدِّمت مطلع التسعينيات كخريطة طريق نحو الحكم الفلسطيني الذاتي، رسّخت عمليًا هيمنة إسرائيل على قطاع الاتصالات ومعظم ترددات البث. نتيجة لذلك، أصبحت كل الشبكات الخلوية الفلسطينية وأبراج الاتصالات وأجهزة البثّ المستوردة خاضعة لموافقة إسرائيلية مسبقة. بالرغم من السماح للشركات الفلسطينية بإنشاء بنية تحتية للاتصالات، إلا أنها لم تُمنح حق التحكم بالقنوات التي تمرّ عبرها الإشارة، وحين بدأ الناس حول العالم يحملون هواتفهم المحمولة أينما ذهبوا، تحوّل الاتصال في فلسطين إلى وسيلة إضافية للمراقبة.
شبكات الشركات الخاصّة
وُلدتُ في غزة عام 2000، مع اندلاع الانتفاضة الثانية، وتزامنت طفولتي مع ظهور العصر الرقمي. كنت في الخامسة عندما أعلنت إسرائيل عن «انسحابها» من غزة. غادر الجنود والمستوطنون القطاع، لكنّ الاحتلال لم يختفِ، بل تغيّر شكله فحسب. فلم تعد إسرائيل بحاجة إلى وجود الجنود على الأرض لمراقبة السكان، بل بات يكفيها التحكم في أدوات الاتصال الرقمي. تصف هِلجا طويل-الصوري هذا النمط بـ«الاحتلال عن بُعد»، والذي يمارَس من خلال الكاميرات وقواعد البيانات والبث الجوي وشبكات الهواتف الموصولة بخوادم إسرائيلية. بذلك، أصبح الحدّ بين إسرائيل وغزة غير مرئي ومطلقاً في الآن ذاته، فلا تنتهي الحدود عند السياج، بل تمتد عبر شاشاتنا.
لازمني الشعور بتلك الهيمنة في طفولتي. أثناء انقطاع الكهرباء المتكرر في حيّنا، وحين تنقطع إشارات الهاتف الضعيفة أصلًا، كان والدي يخفض صوته وينبّهنا ألّا نكثر الكلام. في الشجاعية، أثناء زيارتنا لبيت جدي، كنت ألعب كرة القدم مع الأطفال قرب السياج الشرقي، حيث اتجهت أبصارنا دومًا إلى برج المراقبة الشاهق خلف الملعب. كنا نتمازح أحيانًا بأن الريح نفسها لها آذان.
اختُبرت غالبية تقنيات المراقبة الإسرائيلية للمرة الأولى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي عام 2013، خلال زيارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى رام الله، رفع الفلسطينيون لافتات احتجاجية تطالب بوقف الدعم الأميركي للفصل العنصري الإسرائيلي، إلى جانب لافتة ساخرة تحذر الرئيس الأسبق من إحضار هاتفه الذكي، لأنه لا توجد تغطية لشبكة 3G في فلسطين!

نالت الضفة الغربية الشبكة بعد خمس سنوات، بينما ظلّت غزة محرومة منها حتى اليوم. حسب المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة)، تُعتبَر غزة من الأماكن القليلة في العالم التي تُحدَّد فيها تغطية الهواتف المحمولة بقيود صريحة، لا بسبب عجز البنية التحتية.
ويرى بعض المختصّين أنّ تقييد الشبكة جزء من نظام المراقبة نفسه، إذ يشغّل الجيش الإسرائيلي شبكاته الخاصة بسرعات عالية، بينما يُجبر الفلسطينيون على استخدام شبكة 2G ضعيفة وغير آمنة عمدًا. يؤكد جلال أبو خاطر، الناشط المقدسي في مجال الحقوق الرقمية، أن كل الشرائح الفلسطينية وخطوط الفايبر والاتصالات عبر الأقمار الصناعية تحت السيطرة الإسرائيلية، مضيفًا أنه في حال تعطل أي كابل، لا يمكن للفنيين الفلسطينيين إصلاحه أو الوصول إليه من دون إذن إسرائيلي.
مع بلوغي سنّ المراهقة، أصبحنا نعرف أسطح المنازل التي تومض باللون الأحمر بسبب الهوائيات، وأيّ الأزقّة بعيدة عن أعين المراقبة. كانت الطائرات المسيّرة ترصد مدننا، بينما ترفرف بالونات المراقبة فوقنا كنجوم لا تتزحزح، مرورًا بالسياج الفاصل. أما التصاريح التي تقدّمت عائلاتنا للحصول عليها، فكانت تُسجَّل في قواعد بيانات تربط بين أسمائنا وعناويننا ووجوهنا.
في عام 2019، قبل عام من جائحة كورونا، أطلقت السلطات الإسرائيلية تطبيقًا للهواتف المحمولة حوّل نظام التصاريح إلى رقميّ. للتحقق من الموافقة على تصاريحهم لعام 2020، اضطرّ نحو 50 ألف مستخدم لتفعيل الوصول إلى كاميرا هواتفهم وإحداثيات الموقع والرسائل والملفات المخزنة.
ذهبتُ إلى الإمارات عبر مصر، عام 2022، وكانت تلك المرة الوحيدة التي سافرت فيها قبل الحرب. علمنا ممن خرجوا عبر إسرائيل أن غالبية المسافرين اضطروا لمشاركة سيرتهم الذاتية كاملة، بما في ذلك الانتماءات، أماكن العمل، أرقام الهواتف، أسماء الوالدين. زوّدت تلك المعلومات قواعد بياناتهم بتفاصيل إضافية عن حياتنا، لتصبح أشبه بصفقة: الانكشاف مقابل القدرة على التنقُّل.
بحلول عقد 2020، أصبحت غزة من أكثر المناطق عرضةً للمراقبة على وجه الأرض. حتى الأشياء التي تربطنا ببعضنا ومع العالم الخارجي أصبحت تُعرِّضنا للخطر. أفادت تقارير بأن انقطاعات الإنترنت كانت متزامنة مع العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأرض، حيث أصبحت الهواتف والتطبيقات التي نستخدمها خرائط دقيقة لتحركاتنا، حاول الناس التحايل عليها بطرق بسيطة. فتارةً يبدّلون شرائح الاتصال، وتارةً يتركون هواتفهم في المنزل عند زيارة الأصدقاء والعائلة، ويحذفون الصور قبل المرور عبر المعابر.
بعد السابع من أكتوبر عام 2023، كشف النظام، الذي بُني بهدوء على مدى سنوات، كامل قدراته. اكتشفنا أن عدة حكومات غربية وبعض كبرى شركات التكنولوجيا في العالم قد ساعدت الإسرائيليين على مراقبتنا وتصنيف بياناتنا. تبيّن أن مايكروسوفت تسمح لإسرائيل بتخزين ملايين المكالمات الفلسطينية المخترقة في مراكز بيانات في أوروبا، يمكن استرجاعها بعد شهر وأحيانًا أكثر (تقول مايكروسوفت إنها منعت وصول إسرائيل إلى هذه الخدمات منذ ذلك الحين).
كما أبرمت شركة «بالانتير» (Palantir) اتفاقًا لتزويد الجيش الإسرائيلي بتقنيات لدعم مهام متعلقة بالحرب، وفقًا لتقرير بلومبرغ، وقد نشرت الشركة إعلانًا في صحيفة نيويورك تايمز تعلن فيه صراحةً أنها تقف إلى جانب إسرائيل. وفقًا للتقارير، وظّفت وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية خدمة «غوغل فوتوز» (Google Photos) إلى جانب تقنية من شركة «كور سايت إي آي» (Corsight AI) الإسرائيلية، لتفعيل برنامج للتعرّف على الوجوه وتمييز الأشخاص وسط الحشود وفي لقطات الفيديو.
وتشير تقارير أخرى أنّ غوغل وأمازون، اللتيْن توفّران للحكومة الإسرائيلية خدمات التخزين السحابي المتقدّم وتقنيات الذكاء الاصطناعي، أدرجتا في عقودهما نظامًا سرّيًا لتحذير إسرائيل في حالات إلزام المحاكم الأجنبية لهما بتسليم بيانات الحكومة الإسرائيلية، فيما لا يُسمح للشركتين بإبلاغها مباشرة.
وفي تصريحات رسمية، قال متحدث باسم غوغل إن خدمة Google Photos منتج مجاني متاح للجمهور ولا يوفر تقنية التعرف على الوجه لأغراض عامة على نطاقٍ تجاري. كما أكد أن خدمات السحابة للشركة غير موجهة للأعمال بالغة الحساسية أو السرية أو العسكرية المتعلقة بالأسلحة أو الاستخبارات، قائلًا إن تفادي الشركة لالتزاماتها القانونية تجاه الحكومة الأميركية أو أي دولة أخرى خاطئ قطعيًّا. من جانبه، قال متحدث باسم أمازون: ليست لدينا أي آليات تتيح لنا الالتفاف على التزامات السرّية المفروضة علينا بموجب أوامر قانونية مُلزِمة.
أنتجت الصناعات الجوية الإسرائيلية مقطعًا ترويجيًا يظهر طائرة كوادكابتر مزوّدة بمحركات من صنع الشركة البريطانية «أر سي في إنجينز» (RCV Engines). وفي بيان لها، قالت الشركة إنها زوّدت مطوّرًا إسرائيليًا بنموذج أولي للمحرّك فقط، وإنها لم تقدّم أي تقنية للجيش الإسرائيلي مطلقًا. كما أفادت تقارير بأن الشركة الفرنسية «تيلز» (Thales)، العاملة في مجالات التكنولوجيا الدفاعية والفضائية، قد زوّدت إسرائيل بمعدات إلكترونية تُستخدم في طائرات المراقبة المسيّرة.
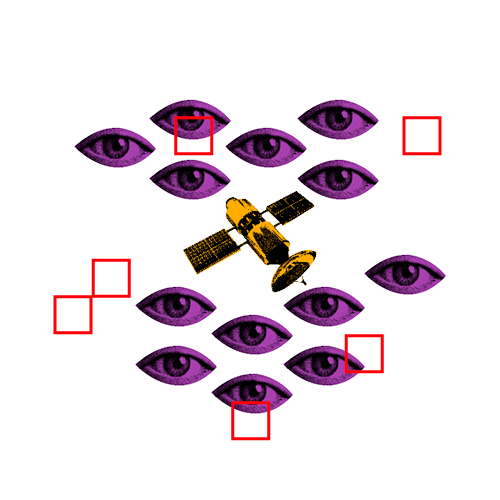
بفضل هذه التقنيات، والتمويل الخاص الذي تقدمه شركات رأس المال الاستثماري الغربية لصالح شركات التكنولوجيا الإسرائيلية مثل Corsight AI وCellebrite إلى جانب شراكات أخرى، طوّرت الحكومة الإسرائيلية منظومات مراقبة فاقت كل تصوّر. كانت الخوارزميات تصنّف الأشخاص وفق مستوى «التهديد» المفترض، بحسب ما كشفت مجلة 972+ ومنصّة «لوكال كول» (Local Call)، بحيث تحدّد، فعليًا، من يُستهدف ومن ينجو.
وأبلغت مصادر استخباراتية إسرائيلية الصحافيين أنّ أحد هذه الأنظمة، المصمَّم لتقييم الأفراد وفقًا لاحتمال ارتباطهم بفصيل فلسطيني مسلّح، أصدر قائمة بعشرات آلاف الأسماء، ولا يستغرق الأمر أكثر من ثلاثين ثانية لشنّ غارة على أيٍّ منهم.
يصنّف برنامج آخر المباني تبعًا لنوعها ومدى إشغالها، مدرجًا إياها في بنك أهداف الاحتلال. كما طوّر جنود من وحدة 8200، رفقةَ جنود احتياط يعملون في شركات مثل غوغل ومايكروسوفت وميتا، أدوات لتحليل الرسائل النصية العربية ومنشورات التواصل الاجتماعي، بحسب نيويورك تايمز. وعندما دمجت هذه التصنيفات مع سياسة استهداف المشتبه به داخل منزله لا كهدفٍ منفرد، كانت النتيجة إبادة عائلات كاملة لا ذنب لها سوى وجودها في المكان الخطأ.
ترافقت هذه الأنظمة المتقدّمة مع تقنيات أقدم، مثل التعاون مع المخبرين والجواسيس، ومداهمة المنازل والمكاتب وتفتيشها. سمعتُ قصصًا لا تُحصى عن جنود يفصلون الناس عن بعضهم بعضاً، ويلتقطون صورًا لهم، ثم يفتشون هواتفهم، في إطار ممارسات أوسع للتفتيش والاحتجاز خلال الحرب؛ وبذلك التحمَت ماكينة المراقبة بماكينة القتل.
كنّا قد اعتدنا على الطائرات المسيّرة التي تراقبنا من بعيد، لكنّ طائرات الكوادكابتر الصغيرة باتت تحوم على ارتفاع منخفض، حاملةً القنابل، فتهبط إلى مستوى الشارع وتدور فوق الباحات والشرفات. وفق تقارير صحفية، بلغ الأمر حدّ أن تحاكي بعض الطائرات صوت بكاء الأطفال.
في غزة، نسمّي الطائرة المسيّرة «الزنانة». بعد أكتوبر 2023، أصبح صوتها ملازمًا لنا، ضجيجًا ثابتًا في الخلفية لا ينقطع. كنّا نميّز بين الزنانات القادرة على القتل وتلك المخصّصة للمراقبة فقط. وقد أخبرني كثيرون لاحقًا أنهم تجنّبوا مواقع توزيع «مؤسسة غزة الإنسانية» سيّئة السمعة (التي أُغلقت في تشرين الثاني/ نوفمبر)، ليس خشية التعرّض لإطلاق النار وحسب، كما حدث مع مئات الأشخاص، بل خوفًا من الكاميرات التي قد تمسح وجوه الحشود وتطابقها مع قواعد بيانات، بحيث يتحوّل مجرد السعي للطعام إلى نقطة انكشاف جديدة وفرصة لتعقّبهم. وفي تموز/ يوليو، أكّد مقاولان يعملان في قوى الأمن داخل مواقع التوزيع تلك أن هذا ما كان يحدث بالفعل، بحسب الأسوشيتد برس.
كانت هذه المنظومة الآلية قادرة على التسلّل إلى البيوت، ورصد مَن في داخلها، ووضعهم ضمن دائرة الاشتباه أو المتابعة. أما محاولة العيش دون الالتفات للمراقبة، فلم تعد ممكنة، وقد تتحوّل إلى مخاطرة قاتلة.
الحياة المراقبة
محمد أبٌ لطفلتين، وعمره 36 عامًا. قبل الحرب، كان يعمل مستشارًا للمؤسسات الأهلية في مجالي الإعلام والتسويق الرقمي. لكن بعد 7 أكتوبر، سعى محمد جاهدًا لأن يصبح «شفافًا» قدر الإمكان. قال: احنا كل حياتنا يعني صرنا متأقلمين مع فكرة إنه حياتنا كلها مراقبة. حتى إنه تجنّب حمل أكياس غير شفافة عند ذهابه إلى السوق. بحاول اجيب كيس شفاف، قال لي. ما أطلعش وأنا حامل شنطة على ظهري، بلاش الشنطة تنفهم غلط. وفي شقته المطلة على البحر، كان محمد يتردّد بين إبقاء الستائر مفتوحة أو إغلاقها، خشية أن تلتقطه الطائرات المسيّرة في الخارج. أصبح يعتقد أن السلامة مرهونة بعدم ترك أي مجال للتأويل.
في آذار/ مارس 2024، كان محمد لا يزال يقيم في عمارته السكنية المطلّة على مستشفى الشفاء. كانت القوات الإسرائيلية قد حاصرت المستشفى، واقتحمته بالدبابات والجرافات، ونسفت مبانيه، وسحقت سيارات الإسعاف. يروي الناجون أنّ عددًا من المرضى قُتلوا، واعتُقل أفراد من الطواقم الطبية، إلى أن أُعلن المستشفى خارج الخدمة بالكامل. كان محمد يسمع نيران الجيش تهزّ نوافذ شقته ليلًا: وحتى الساعة 8:00 ما قدرنا نرفع روسنا أو نتحرك من على الارض. دوّى طَرْقٌ عنيف على الباب ذلك الصباح، قبل أن يدخل رجل، فلسطيني، عاريًا، كما روى محمد، وإبلاغه أن الجنود ينتظرون في الخارج، وعلى الرجال جميعًا أن يخلعوا ملابسهم. سأل أحدهم عمّا إذا كان ينبغي إحضار الهويات، فأجاب الرجل بألّا يأخذوا معهم شيئًا.
أُخرج نحو خمسة وعشرين رجلًا من سكان المبنى إلى الشارع. كان الجو باردًا وماطرًا. أُمرت النساء والأطفال بالسير جنوبًا، بينما أُجبر الرجال على الوقوف حول صفّ من الدبابات. كان بينهم مسنّون ورجال من ذوي الإعاقة.
يقول محمد: تمّ فحصنا من خلال بصمة الوجه، وطلبوا منا نتطلّع باتجاه الضوء، كانت كاميرا هناك، واضح. كانت الأوامر تُسمع عبر مكبّر صوت بلهجة عربية فصيحة: وقّف. اطلّع يمين، يسار. اطلّع على الكاميرا. وعندما خطا محمد خطوة في الاتجاه الخاطئ، أطلق الصوت نكتة ساخرة: انت ساقط صف سابع إعدادي.
يقول محمد: إحنا اتبهدلنا لمدة 12 ساعة.
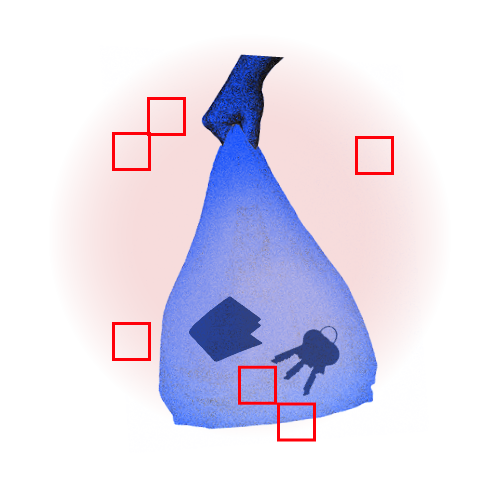
عند الثامنة مساءً، وبعد أن وقفوا شبه عراة تحت المطر لساعات، وأيديهم مقيدة بأربطة بلاستيكية، أمرهم جندي بأن يغادروا. سار محمد مبتعدًا بحذر، متوقعًا رصاصة في ظهره في أي لحظة. وعند مغادرتهم، وزّع الجنود بطانيات (أغطية). فكّر لحظة في أخذ واحدة، ثم امتنع عن أخذها: أنا ما غطيت حالي، لأنه اللي بالشارع مش هيعرف إني انفحصت وخلصت… ظلّيت ماشي وأنا عاري كدا، هاد إثبات إنه أنا طلعت من عندهم.
سار لأكثر من ساعة عبر مدينة غزة، عاريًا تحت المطر؛ فيه بيوت موجودة، ما رضيتش أخبط على دار حدا، أو أدوّر على قماشة أغطي حالي من البرد. واصل السير حتى وصل إلى منزل صديق، فاستعار هاتفًا هناك، واتصل بزوجته. كانت بخير.
حين تحدّث محمد عن ذلك اليوم، كان أكثر ما يفزعه إيمانه بأن حذره سوف يحميه. قال: بدأ يتضح لنا الموضوع، إنه فيه بصمة وجه، فأنا قلت خلص، بدي أطلع مع المجموعة الأولى، لأنه عارف حالي، قلت افحصونا من الأول تعالوا. كان يمنّي نفسه بأنهم يدركون ألّا علاقة له بالمقاومة، فلن يؤذوه أو يتعرّضوا له. بعد أشهر، علم بوجود فيديو متداول على الإنترنت يُظهر مجموعة رجال، شبه عراة، يسيرون بالقرب من مستشفى الشفاء. كان محمد بينهم. صحيت الصبح لقيت الناس ممنشنيني عليه… بكيت. إنه ما هانش على الواحد نفسه. تبيّن في النهاية أن كل محاولاته لأن يكون مكشوفًا وشفافًا لم تنقذه: الواحد إذا بدّه يصعب عليه شي، بتصعب عليه آدميته.
امرأة في أوائل الأربعينيات من عمرها، طلبت عدم الكشف عن هويتها، كانت تعمل في صالون تجميل قبل الحرب، تم توقيفها أثناء سيرها من مأواها في شمال غزة باتجاه الجنوب، ووُضعت أمام جهازين لتسجيل ملامح وجهها: هاتف لالتقاط الصورة، وشاشة أخرى لمعالجتها. حاولت الإشاحة بوجهها بعيدًا عن الكاميرا، إلا أن جنديًا أجبرها على مواجهتها، ثم ضربها على رأسها بمؤخرة بندقيته.
في البداية، لم يوجه إليها الجندي أي أسئلة: ما سألني ولا اشي، ولا اسم، ولا هوية، ولا شي. ظهر اسمها الكامل على الفور، فقرأ الجندي اسمها واسم والدها وجدها واسم العائلة؛ على طول عرف اسمي. ألقى ضابط نظرة على الشاشة، وقرر احتجازها. أُجبرت على خلع كل ملابسها إلا الملابس الداخلية، ولم تكن لتكتشف أنّ أربعة جنود يوجهون كاميرا نحوها، لولا انزلاق العصابة عن عينيها في تلك اللحظة. صرخت، حاولت ستر جسدها، وبكت، ثم تلقت ضربة على صدرها وشُدَّت العصابة فوق عينيها. شتمها الجنود، ودفعوا بها إلى قفص ضيق، مهددين إياها بالضرب في حال أي عصيان لأوامرهم. هددها أحد الجنود بنشر الصور، وكانت الهواتف والكاميرات وساعات اليد تسجل كل شيء من حولها، على حدّ اعتقادها.
بعد أيام من احتجازها، نُقلت إلى غرفة يمكث فيها ضباط ومعهم ملفها الكامل: مهنتها، مكان إقامتها، وأسماء أفراد عائلتها. بدأ الاستجواب بمحاولة تجنيدها، فقال أحد الضباط: انتِ بتشتغلي بصالون تجميل؟ بنعطيكِ الهوية الإسرائيلية، الجواز الأمريكي، بنعطيكِ راتب. أخبروها بأنها سوف تتقاضى أجرًا كافيًا للإنفاق على نفسها وعلى ابنتها، وعرضوا عليها جلبابًا طويلًا لتتخفى وتتعاون معهم كمخبرة، قالوا لها: فكّري، لكنها رفضت. حينها بدأت الضربات تنهال عليها من جديد؛ على الرأس، والصدر، والفم.
كانت كل إجابة، أو لحظة صمت، تستدعي اعتداءً جديدًا، إلى أن بدأت بالنزيف: لحد ما صار الدم يطفح من فمي، ومن الأنف. عادوا للضغط عليها مرة أخرى، يعرضون الصفقة ذاتها؛ العمالة مقابل النجاة. أصرّت على الرفض، وهم لم يتوانوا عن ضربها، ثم تحوّل الاستجواب إلى نوع جديد من الأسئلة: أين الرهائن؟ أين أبناء عمومتك؟ أين يحتمي المقاومون؟
قالت إنهم نقلوها بين الزنازين ومعتقل «سديه تيمان» وسجن «الدامون» في إسرائيل. في سديه تيمان، الذي يُعرف الآن بسجلّ طويل من الانتهاكات المروعة الموثقة، تعرضت هذه المرأة للاغتصاب أربع مرات. أثناء دورتها الشهرية، سخر الحراس من نزيفها ورائحتها. كانوا يعرفون أن لديها ابنة مراهقة، وأنها عملت في صالون تجميل، قصّوا شعرها. قالت إنهم استخدموا كلّ معلومة عنها ضدّها، وبعد 32 يومًا من الاعتقال، أُفرج عنها.
استهداف الصحافيّين
منذ الأيام الأولى للحرب، كنت أتنقّل في غزة لتغطية الأحداث لوسائل إعلام مثل الجزيرة الإنجليزية وThe Nation و972+. بحلول أواخر أكتوبر 2023، كان هاتفي يفيض برسائل تتضمّن اقتباسات من تقاريري، وتهدّدني بالقتل. بدا أن بعض الرسائل صيغَت عبر الذكاء الاصطناعي. تلقى كل صحافي أعرفه، تقريبًا، تهديدات مشابهة.
على مدار ستة أيام، مطلع كانون الأول 2023، تنقّلت بين مستشفى الشفاء وحيّي الشجاعية والدرج في مدينة غزة، أنام في مراكز الإيواء في المدارس، وأحيانًا في المستشفيات، وأرسل تقاريري الصحفية من أي زاوية حيث تتوفر الكهرباء. كنت أبقي مكالماتي قصيرة وأغلق هاتفي أثناء العمل، خوفًا من كشف المواقع التي أتنقّل بينها.
في السادس من كانون الأول، عدت إلى البيت لأطمئن على عائلتي. وما إن وصلت حتى رنّ هاتفي. تكلم المتصل بالعربية وقدّم نفسه باسم «ديفيد» من الجيش الإسرائيلي. ناداني «حبيبي»، وقال إن أمامنا 20 دقيقة لإخلاء منزلنا المكوّن من ثلاثة طوابق، والمكتظ بأفراد العائلة والجيران. سمعت قصصًا من آخرين، بينهم زملاء صحافيون، عن مكالمات مشابهة اتضح لاحقًا أنها خدعة. بدا الأمر مجرد مضايقة أخرى، وربما كان أيضًا وسيلة تدفعنا للرحيل، في وقت لم يكن هناك مكان نلتجئ إليه. لذلك بقينا.
عند السابعة والنصف صباحًا في اليوم التالي، سمعت وقع قدمي ابني في الممر، بينما كنت أمدّ يدي نحو كوب الشاي. وقع الانفجار بلا أي إنذار. انهار المنزل. لم أرَ السقف يتشقق أو الجدران تسقط؛ شعرتُ بثقل مفاجئ، أسمنت ومعدن يسحقان جسدي. انحشرت ذراعاي، وعلقت ساقاي، وامتلأ فمي ورئتاي بالغبار.
صرخت أنادي زوجتي وابني ووالديّ. في البداية، لم أسمع أي جواب، ثم جاء صوت صغير من مكان لا أستطيع الوصول إليه: «بابا». كان حيًّا. لم أكن قادرًا على الوصول إليه. تلاشى شعوري بالزمن. تحرّكت أحجار في مكانٍ ما في الأعلى، وسمعت أصواتًا خافتة بعيدة. لا بد أنني فقدت الوعي.
حين تمكن المنقذون أخيرًا من إبعاد الركام، تسرّب شقّ من الضوء، وشرعت الأيادي بإزالة الحطام. سحبوني إلى الخارج، وبعد لحظات من استعادة وعيي، أخرجوا زوجتي وابني.
قُتل أربعة من أهلي: اثنان من أبناء عمومتي، واثنان من جيراني، واحدٌ منهم كان يمرّ ببابنا حين سقطت القذيفة. كانوا يعلمون حق المعرفة أنني في المنزل، وعلى الأرجح تعقبوا هاتفي إلى هناك. أعتقد أن المنظومة رصدتني أولًا، ثم أصبح كل من يقع في محيطي جزءًا من حسابات الجيش الإسرائيلي لما يُسمّى بالأضرار الجانبية المسموح بها، بما في ذلك ابني. في ذلك اليوم، نُقلنا إلى مستشفى الشفاء، حيث تلقّينا إسعافات أولية فقط، ثم عدنا إلى حيّنا وأقمنا عند أحد الجيران. بعد أسبوعين، انتقلنا إلى مركز للإيواء في إحدى المدارس، ثم واصلنا التنقّل بين ملاجئ مؤقتة في أنحاء مدينة غزة.
منذ تلك اللحظة، افترضت أنني مكشوف تمامًا. واصلت النشر، لكنني واظبتُ على حذف المسودّات وأرقام جهات الاتصال. كنت أغيّر مسارات تحركاتي، ولا أنطق باسم أي موقع جهرًا. ومع ذلك، كنت أعلم أنني داخل شبكتهم. بعد ثلاثة أشهر، وبينما كنت في مأوى مؤقّت للنازحين، رنّ هاتفي من جديد. جاءني صوت غليظ يقول بالعربية: قلنالك توقف. ما وقفت، ورح يكون في عواقب.
كنا جميعًا، كصحافيين، أهدافًا للرقابة والتهديد. أظهرت تجاربنا في غزة تماهي المراقبة مع آلة الحرب بوضوح، واتضح فعلًا استهداف الجيش الإسرائيلي لبعض الصحافيين، رغم ارتدائهم سترات الصحافة، وذلك بحسب شهادات مراسلين ميدانيين وتقارير نشرتها وسائل إعلام دولية. في إحصاء أولي منذ أكتوبر 2023، سجلت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين مقتل ما لا يقل عن 206 صحافيين وعاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية في غزة على يد إسرائيل، ووصفت اللجنة عام 2024 بأنه الأكثر دموية للصحافيين منذ أن بدأت بجمع بياناتها قبل أكثر من ثلاثة عقود، حيث تتحمل إسرائيل مسؤولية مقتل نحو 70 بالمئة من هؤلاء الصحافيين.
في ظلّ هذه الظروف المشؤومة، كان من الطبيعي أن يتوقّف بعض الصحافيين عن تغطية جرائم إسرائيل في محاولة لحماية حياتهم. إحدى النساء اللواتي أعرفهنّ معلّمة لغة إنجليزية سابقة، اتجهت إلى الصحافة عام 2023 قبل أشهر فقط من اندلاع الحرب. خلال مكالمة على واتساب، قبيل وقف إطلاق النار الأخير، جلست في غرفة تطل على حي الرمال الذي كان يومًا شريانًا نابضًا وسط مدينة غزة، وأصبح الآن حقلًا من خيام النازحين وركامًا للأبراج الشاهقة. حين تسرّب صوت الزنانة إلى المكالمة واشتد، تجمّد وجهها وتشنّج فكّها، فأبقت عينيها معلّقتين على النافذة.
في كانون الثاني/ يناير 2024، نزحت عائلتها من حي الزيتون، شرقي مدينة غزة، إلى شقة عمتها غرب المدينة. كانت تستخدم بطاقة e-SIM؛ الوسيلة الوحيدة للاتصال خلال انقطاعات الكهرباء، فتوسل إليها أقاربها المقيمون معها ألّا تلتقط الصور حال تفعيلها البطاقة. حين صعدت إلى سطح المنزل للاتصال بالشبكة، كان الأمر مرعبًا: أنا وهم كنا خايفين. قررت كذلك أن تتجنب الرد على المكالمات داخل المنزل، يلازمها شعورٌ بأنها تحت المراقبة على مدار الساعة.
وفي أحد الأيام، بعد بثّ مباشر من مستشفى الشفاء، عطّلت الصحافية النَّسخَ الاحتياطي على السحابة ومسحت كل جهات الاتصال المتعلقة بالعمل، مدركة أنها لن تتمكن من طلب مساعدتهم لاحقًا. شددت عائلتها على ضرورة احترام شروطهم. وبعد انفجار قريب، همس زوج عمتها لها: ما تصوريها. بعد أسابيع، في حي الشجاعية، عندما رفعت هاتفها صوب الأنقاض، مرّ رجل مسنّ وهمس: ديري بالك، ما تصوري.
فقدت ثقتها بمنصّات التواصل الاجتماعي حيث اعتادت نشر تقاريرها، بعد أن اكتشفت أن شركات مثل ميتا (Meta) تقيّد المحتوى المتعلق بفلسطين. شعرت بأن عليها الانسحاب من المشهد؛ أن تتوارى عن الأنظار، إذ أصبح واضحًا لها أن من يوثق مشاهد الدمار يصبح مستهدفًا. في آب/ أغسطس، قُتل ستة صحافيين، بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع من شبكة الجزيرة، وهما زميلان لي، إثر غارة إسرائيلية قرب مستشفى الشفاء. أخبرتني أنها لم تكن تختبئ ولا تستطيع الاختباء أساسًا، لكنها توقفت ببساطة عن العمل الصحفي: اخترت عيلتي، واخترت سلامتي.
هل ما زال رفيق هناك؟ تحسّنت صحّة صدره؟
بعد قصف منزلي، لم تتوقف التهديدات عبر واتساب ومنصّات التواصل الاجتماعي والهاتف. أدركت أنّ السفر إلى مصر قد يُتاح لمن يدفع رسومًا معيّنة. بمساعدة زملاء في الخارج، جمعنا المال واستعدّينا للرحيل نحو الجنوب، وحينها وجدنا أنفسنا عند حاجز نتساريم في نيسان/ أبريل 2024.
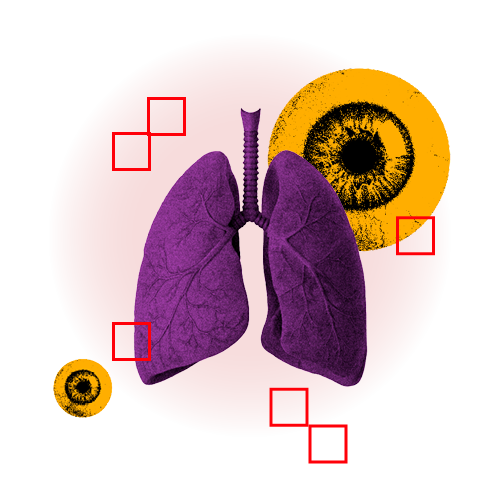
فكرت مرارًا في شكل المواجهة مع القوات التي كانت تقتلنا، ولا أقصد هنا الدبابة أو الطائرة المسيّرة ولا ذاك الصوت المجهول على الهاتف، بل الجندي نفسه. كنت أخشى ما سيرونه عند مواجهتي، متسائلًا عمّا إذا كان مثولي أمام إنسان سيجعلهم يرونني إنسانًا أيضًا.
بعد تعرّف الآلة على هويتي، فصلني الجنود عن أسماء ورفيق دون أن يطرحوا سؤالًا واحدًا. أشار أحدهم إلى الأرض لأضع هاتفي ومحفظتي ومفاتيحي هناك، ثم أشار إليّ مجددًا لأخلع قميصي وبنطالي وملابسي الداخلية. كان رفيق يحاول الاقتراب نحوي، أسمع صوته الرقيق وهو يقول: بابا. حينها انطلق صوت بجواري، يهدّد بإطلاق النار على طفلنا الرضيع إن لم تأخذه أسماء وتبتعد. كبّلوا يديّ بأربطة بلاستيكية، ووضعوا عصبةً على عينيّ، وجرّوني إلى غرفة.
كانت مصابيح الكشاف تطن فوق رأسي، والرمل تحت قدمي حادٌّ، تحجّر من شدّة الحرارة. اقتادني أحدهم إلى الداخل ممسكًا بذراعي، بينما سمعت أصوات فلسطينيين، رجالًا ونساء، يتوسلون ويجادلون بنبرة متوترة منهَكة، محاولين إقناع الجنود بأنهم ليسوا كما صنّفهم نظام المراقبة. كان الجنود يتحدثون العربية غالبًا، تتخللها كلمات قليلة بالإنجليزية الأميركية والعبرية، وكانوا يتحدثون بسرعة كمن يتناقل الأوامر. دفعني أحدهم إلى الأرض، وجهي إلى الأسفل، ويداي مقيدتان خلف ظهري، بينما يضغط جندي على مؤخرة رأسي. تركوني هناك، ولم ينبس أحد بكلمة طوال لساعات، أو هكذا بدا لي.
وعندما انتشلوني أخيرًا، أمسك بي أحدهم وجرّني لبضع خطوات، قبل أن يضغط الجنود جبيني على الجدار الملتهب. سمعت طقطقة السلاح قرب أذني. بعد ثوانٍ، أداروا وجهي ونزعوا العصبة عن عينيّ. حدّقت في الضوء، عاريًا، وبالكاد أستطيع فتح عينيّ.
يرتدي الرجل الجالس أمامي بزة عسكرية كاملة ولا يشدّ رباط خوذته، واضعًا دفتر ملاحظاته وهاتفه على ركبته. ابتسم كمن يحاول طمأنتي بألّا شيء يدعو للقلق. قال: محمد، كيف حالك؟ سنبدأ بالأسئلة واحدًا واحدًا. كانت لغته العربية ممتازة، قريبة بما يكفي من لغتي، ما طمأنني للوهلة الأولى. صِغتُ إجاباتي بخليط مضطرب بين العربية والإنجليزية؛ أجبتُ بالإنجليزية كلما شعرتُ بالضيق، واتكأت على العربية كلما احتجتُ استعادة نفسي.
بدأ يستعرض حياتي؛ دراستي، وعملي، ويذكر المواقع التي عملت فيها مراسلًا، مثل مستشفى الشفاء والعودة والدرج. سأل عن أقاربي، وعندما ترددت، أكمل هو أسماء أبناء عمومتي، وذكر الحي الذي لجأت إليه عائلتي. سواء أجبتُ أو تعثّرت، كان دفتر ملاحظاته يلتقط كل شيء بلا استثناء. استمر الاستجواب لساعات، وما أصبح واضحاً لي خلال تلك الدقائق الطويلة أن شاشة المحقق تُظهر نسخة من حياتي، استقاها من مراقبة حثيثة للمكالمات والكاميرات والإحداثيات.
ثم سألني عن ابني، قائلًا: هل ما زال رفيق هناك؟ تحسّنت صحة صدره؟ للحظة، فقدتُ القدرة على التفكير. يأتي هذا السؤال من داخل منزلي، ويعيدني إلى عام 2022، عندما كان عمر رفيق 11 شهراً، أثناء وجودنا في الإمارات. أصيب حينها رفيق بعدوى رئوية، وقضى ليلتين في مستشفى بدُبي. لم يكن الأمر خطيراً وتعافى سريعًا، لكن الغريب أنني لم أكتب عن هذه الحادثة ولم أنشر عنها من قبل. تحدث المحقق عنها وكأنها بندٌ على قائمته. لا يمكن أن تكون معرفتهم بمرض ابني قد جاءت من فراغ؛ هل حصّلوها عبر سجلات المستشفى في الإمارات؟ أم تسجيلات مكالماتي؟ أم عبر اختراق بريدي الإلكتروني؟ شعرت وكأنهم عشّشوا داخل ذهني.
اشتدت حدة الاستجواب. ضربني جندي ببندقيته على رقبتي حين نفَيت المشاركة في أي عمليات ضد إسرائيل، وقال بالإنجليزية: قل الحقيقة. كان كل سؤال يطرحه المحقق بمثابة امتحان. التزمت بإجاباتٍ مقتضبة؛ أننا نزحنا جنوباً طلباً للطعام وأننا ننفذ الأوامر وهي عبارة من صياغتهم، فأكررها على مسامعهم أملًا في حماية عائلتي. تطرق بعدها إلى قصف منزلنا واصفاً تقاريري بأنها «إعلانات» وقال إنني كدت أعرّض عائلتي للقتل.
لمحتُ شاشة جهازه اللوحي، بدت مزدحمة بقوائم طويلة دون أيقونات. ظل يتصفحه طويلاً، وعندما تكلّم مجدداً، سأل إن كنت قد عاونت أحداً في تنفيذ هجوم أو شهدت على أمرٍ كذلك. ثم عرض عليّ صفقةً: إرسال رفيق لتلقي العلاج في الداخل، مقابل التخابر. لوهلة قصيرة، راودني شعورٌ بأن أصدقه، بدا وكأنه يحمل شيئًا من الرحمة.
كان أحدهم ينادي بالأسماء من حولنا، بينما يأكل جندي آخر رقائق الشيبس من كيس برتقالي ويمضغ ببطء، يراقبنا كما لو كانت وردية عمل روتينية. مرت ساعتان إضافيتان في الحرّ، وكانوا قد أعادوا ربط العصبة على عينيّ، ثم وضعوا ملابسي ومحفظتي عند قدمي، ولم ينقص شيء من نقودي. عاد الجندي الذي ضربني ومعه زجاجة ماء باردة وأمرني أن أشرب. كنت صائمًا في رمضان، لكنّي شربت على أي حال. قال المحقق: نبقى على تواصل، نعرف أساسًا كيف نصل إليك.
ارتديت ملابسي وخرجت نحو الساحة نفسها، حيث الكاميرات السوداء. لم ألمح أسماء أو رفيق. كانت الدبابات متوقفة خلف السواتر الترابية. واصلت المشي كمن يعرف يقينًا أن أحدًا سيستدعيه مجددًا. وعندما التقيت بعائلتي أخيراً، أخبرتني أسماء بأنها أرادت انتظاري قرب الحاجز، لكنها أُجبرت على السير جنوباً، باكية، ورفيق متشبّث بها. ساعدنا رجلان، أحدهما مسنّ والآخر شاب وكلاهما يكسوهما الغبار، في حمل حقائبنا. بعد يومين، وصلنا إلى معبر رفح.
سجلّ الإبادة
في غزة، لا سبيل للاطلاع على السجل الذي يحكم علينا، أي الملف الذي يقرر تحويل أسمائنا إلى إنذاراتٍ حمراء. يلتقط أصدقائي وعائلتي التحذيرات عبر الأصوات العادية في منازلهم، كالنغمة الدولية للاتصال، أو في عدسة كاميرا مثبتة فوق الباب. يقولون لي إنه رغم توقف سقوط القذائف إلى حدّ ما، ما زالوا حذرين في مكالماتهم، فيبقونها مختصرة ويتجنبون إجراءها إلا في حالات الضرورة. يستمر طنين المسيّرات لساعات، فيسترشد الناس بالصوت لاختيار طريقهم وتفاديها.
يمكننا أن نتخيل أن جزءًا كبيرًا من المعلومات التي جمعها الإسرائيليون خلال العامين الماضيين سيُحوّل إلى قاعدة جديدة لأرشيف موسع وقائمة مراقبة دائمة، وإلى خريطة حيّة لمكالماتنا وأماكن تواجدنا. توضّح مروة فطافطة، مديرة السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة (Access Now): نتحدث عن عقود طويلة من جمع المعلومات، وبناءً على هذا النمط التاريخي، بالطبع لن تتوقف إسرائيل عن مراقبة الفلسطينيين بشكل ممنهج بعد وقف إطلاق النار. من المرجح أن يصبح نظام المراقبة أكبر وأكثر توغلًا، تبعًا لتحولاته المستمرة في كلّ مرحلة جديدة من الاحتلال.
بينما يُخطَّط مستقبل غزة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، تظهر دلائل على بدء تشكّل أنماطٍ جديدة من المراقبة. خلال الأسابيع القليلة الماضية، أضافت الولايات المتحدة مستوى جديدًا من المراقبة عبر مسيّرات، تزعم التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار. إذ تتم مراجعة المقاطع التي جمعتها المسيّرات في مركز تنسيق مدني- عسكري بقيادة أميركية جنوب إسرائيل. في الآن ذاته، قُطّعت أوصال غزة إلى نصفين بواسطة ما يُعرف بالخط الأصفر الذي يفصل المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل عن بقية أراضي القطاع، حيث أفادت تقارير بأنّه سيُسمح بدخول هذه المناطق فقط للفلسطينيين الذين اجتازوا فحص الأمن الإسرائيلي الذي تجريه المخابرات الداخلية. يبدو أن جهاز المراقبة، الذي استخدم في شنّ الغارات الجوية، قد يحدد الآن من يُسمح له بالعودة إلى منزله ومن يحق له إيجاد سرير للنوم من الأساس.
قالت ماري، الكاتبة التي استيقظت لتجد طائرة مسيّرة تحوم داخل غرفتها: الخصوصية صارت رفاهية إلنا أهل غزة، بعدما سُحقت آدميتنا. وصفت ما يعيشونه بأنه نوع من «صهر الوعي»؛ مستعيرةً مصطلحًا للكاتب الفلسطيني والأسير الشهيد وليد دقّة. وأضافت: ما فيه نكون مرتاحين بالحديث، بِنراقب كل كلمة ممكن تضرنا.
وأفادت غدير الشرفا، أخصائية علم النفس السريري والمتخصصة بدراسة الصدمات النفسية في غزة، إنه حتى بعد وقف إطلاق النار، لم يتسنَّ للعقل مساحة لالتقاط أنفاسه، فبحسب الشرفا: إحنا مراقبين لسا… احتمال الحرب ترجع، لأنه لو هم خلّصوا فعلًا، كان طائرات الكوادكبتر ما بتلفّ حوالينا وتحوم في السماء.
رافقني نظام المراقبة هذا حتى خارج غزة في أبريل 2024، فحملته معي إلى رفح، حيث اجتازت عائلتي بوابات العبور المزدحمة بالناس، نجرّ حقائبنا سيرًا على الأقدام قبل صعودنا الحافلة المتجهة إلى القاهرة. رافقني في وقت لاحق من ذلك اليوم، حين نادى ضابط مصري اسمي، ولم أشعر بشيء من الراحة إلا بعد ختم جوازي بتأشيرة الدخول المصرية. لقد نجوت، لكنّني لم أستطع التخلّي عن بعض العادات الصغيرة. ففور خروجي من غزة، بدّلت شرائح الهاتف بلا سبب. ما زلت ألاحظ وجود الكاميرات في المكاتب والمباني، وأحتفظ بهاتف احتياطي نظيف. أخفض صوتي قرب البوابات والميكروفونات في المؤتمرات، وأصمت في اجتماعات «زووم» عند أول تشويشٍ في الصوت.
أفكّر في ابني. قد تكون صورته الأولى محفوظة بالفعل في قاعدة بيانات ستبقى بعد رحيلنا. لا أستطيع الاطلاع على السجل الذي يلاحقنا، لكن يمكنني أن أترك سجلّاً آخر يخصّنا نحن. لذا أكتب كلّ شيء: الأسماء، الأوقات، الأماكن؛ لتبقى أثرًا يعود إلينا، لا إليهم. فلا ملف يمكن أن يكون نهائيًا ما دام الأشخاص داخله مستمرّين في تدوين ذواتهم بأنفسهم.
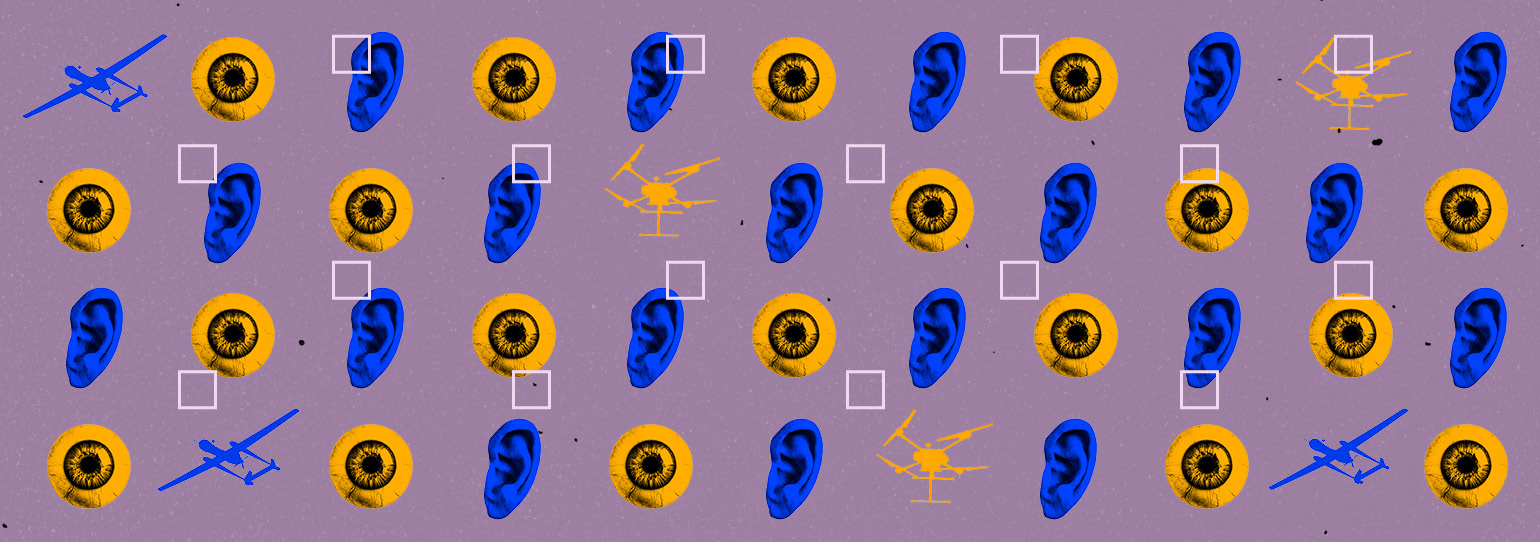
نُشرت هذه المادة باللغة الإنجليزية في New York Magazine، وأنتجها «مختبر فلسطين للصحافة»، أحد مشاريع مؤسسة Just Vision.
الترجمة للعربية: لما رباح