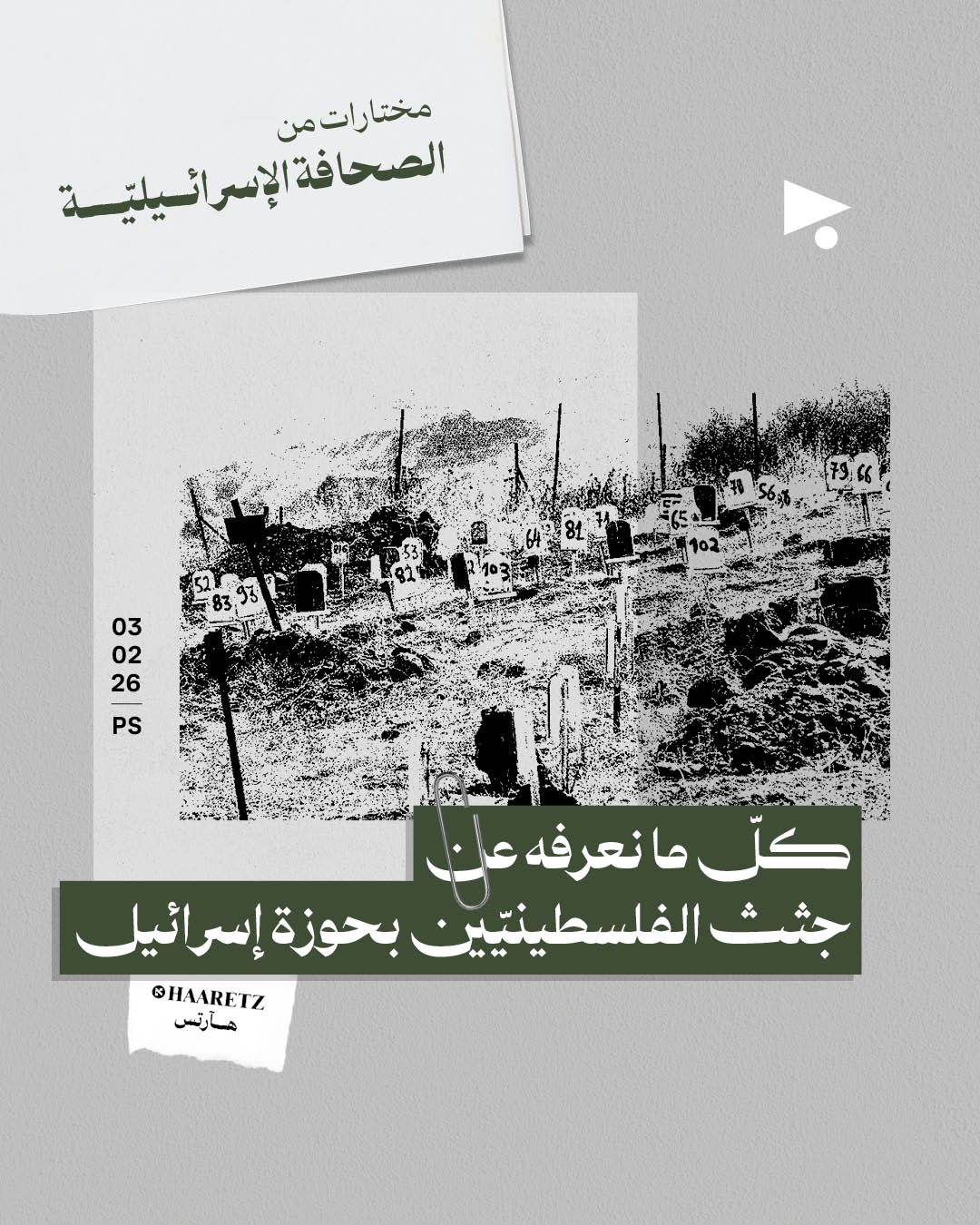نعرف مساحتنا وأبعادها، حتى بعدما تنازل النظام عن جزيرتين وممرّ دولي. تعيش الخريطة في وعينا، يدرسها الطلاب منذ المرحلة الابتدائية، المربّع ذو الحواف الطائرة من الشمال الشرقي، البحار ترصع حدوده الشمالية والشرقية، الصحراء الواسعة من جهة الغرب والشرق، حاميات طبيعية تفصل الوادي وسكانه عن كل الحدود والمخاطر. لكنها لا تستطيع أن تفصله عن العالم، بل أن هذا المربع، قُدِّر له أن يربط الحيوات والمصائر والنكبات.
هذا الضجيج الجغرافي الكبير، وما يحمله الآن من صمت مخيف… كيف فعلها هذا النظام، كيف تعالت أصوات سرينة المدرعة فوق أصوات المصريين، كيف ركّعت الرصاصة أصوات الموسيقى وسحر الأفلام وضجيج المطابع ونقاش المقاهي والتجمعات وصحوة الجامعات. ورغم انحيازنا الفطري لقضيتنا الأمّ، وعدائنا الواضح للمشروع الصهيوني، إلا أنهم ساقونا للفراغ من ممرات خلفية، بعدما هزمناهم فى كل الميادين.
شريط رفيع يطلّ على ساحل المتوسط، يجاورنا منذ عرفنا جغرافيا بلادنا، ينظر إلينا في تعجّب، حسرة، غضب. ترانا غزة، فننكمش، يرانا أهالي وأحباب ما يزيد عن الـ40 ألف شهيد، يتضاءل حجم الخريطة الكبيرة. ترانا عيون الجوعى، تلعننا صرخات المصابين، نحن المكبّلين المهزومين. كيف ننقذ الضحية، دون مواجهة مجنون الغرفة، الرصاصة الطائشة، المدرعة المجنونة، العسكري المدفوع بحب زنازين الوطن. لم يحب هذا العسكري يوماً هذه الشوارع، جرف أشجارها، لم يتذوّق فنونها، فصدّر صنّاعها مثل بضاعة رخيصة لمواسم الترفيه السعودية. وجد هذا العسكري ضرورةً لتجفيف منابع الأمل بصناعة السجون وزراعة الخوف في كلّ حيّز إنساني، بحيث ينمو متشعّباً فوق رؤوس الناس، فلا ينظرون لأعلى، تراهم، ينظرون جميعاً للأرض، يخشون أن تُسحَب من تحت أقدامهم أيضاً.
هل حاولنا؟
مع بداية حرب الإبادة الصهيونية على غزة، فزعنا وخرجنا إلى الشوارع. بعد 10 سنوات من تركيع هذا الشعب بكل الطرق والأسلحة، ظهر الناس، على مدار 4 أسابيع متواصلة، يبحثون عن مكان لإعلان الغضب والتظاهر ضد ما يحدث، بدأت كرة الثلج تتكون في نقابة الصحفيين المصريين وتبنّت دعوات واضحة للاحتشاد والتظاهر، وأعلنت سلالم النقابة لأول مرة منذ سنوات عن عصيانها الجديد، بعد 8 سنوات من الصمت، وخرجت القلة لمواجهة الفراغ العام. وفي نفس الوقت، ذهب العامة بشكل تلقائي إلى صلاة الجمعة في جامع الأزهر، وانفجرت ساحته من جديد بالهتاف لفلسطين ودعمًا لغزة. حاصرت القوات المتظاهرين وألقت القبض على بعضهم. أعطوا أوامرهم للساسة المتواجدين في الأزهر بصرف المتظاهرين، وفعلوا.
منذ ذاك اليوم، أدرك الناس أنه علينا جميعاً الذهاب للأزهر، نقطة انطلاق المقاومة الشعبية للمصريين في أسوأ عهود الاحتلال في عقود مضت، والمكان الذي انطلقت منه أكبر احتجاجات في عهد مبارك ضد الاحتلال الاسرائيلي والغزو الأميركي للعراق، حينها. حتى قوى اليسار الشيوعي كانت تدعو لمظاهرات الأزهر التي تبدأ من الجامع وتشتبك مع قوات الأمن، وإن استطاعت التغلب عليهم، ينطلق الركب إلى الهدف الثاني، الهدف الدائم: ميدان التحرير.
منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية، تمرّن جيلنا على الرحلة من الأزهر للتحرير. موجات هادرة من البشر تلتقي بعد الصلاة وتبدأ اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن للخروج من حيز الجامع للشارع. وبمجرد أن ينفلت الزمام، ينضمّ الناس للمظاهرات وتخرج الأمور عن المرسوم. هنا تبدأ رحلة الوصول للتحرير في شكل تجمعات متفرقة او كتل كبيرة، حينها تكون القلة قد نجحت في مسعاها وتعجز القوات الشرطية عن السيطرة. وبعد انضمام سكان الأحياء الشعبية المجاورة لحيّ الأزهر، تصبح المواجهة مكلفة والخيال العام يتفوّق على قدرات العصا. نجحت جموع المتظاهرين في فعلها في 20 آذار/مارس وقت الغزو الأميركي للعراق، وشهد شارع الأزهر على مواجهات عنيفة واعتقالات وإصابات بالعشرات للمتظاهرين، لكننا نجحنا.
كانت أولى الرحلات المؤثرة في وعي جيلنا. فيمكننا عبور الحدود المرسومة، والوصول إلى الميدان. كانت البروفة الأولى لثورة يناير واحتلال التحرير.
وفي 2006 ومع الحرب الصهيونية على لبنان، خرج الساسة والعامة للأزهر واندلعت احتجاجات تهتف ضد الصهاينة وضد موقف مبارك من الحرب. حوصرنا ومُنعنا من الخروج من الجامع إلا أنفاراً. وجرت اعتداءات على من حاول تجميع الناس في شارع الازهر. ثم استطاعت قلّةٌ الإفلات والتجمّع وتنظيم مسيرة وصلت لنقابة الصحفيين في وسط البلد بعد إغلاق ميدان التحرير.
ومع طوفان الأقصى وحرب غزة، عاد الوعي الجماعي المصري يعمل في نفس الاتجاه. وعادت الشراسة الأمنية وعاد الخذلان السياسي لنخبة فاقدة لأبسط قواعد العمل السياسي، وهي الاتصال مع الجماهير. استمر جموع المصريين في الذهاب إلى الأزهر وغاب الساسة وقيادات الأحزاب عن المشهد تمامًا. تركوا الناس وحدهم في مواجهات مع قوات الأمن المبالغ في عددها أثناء صلاة الجمعة. كانت التحصينات مكثفة، والمخبرون في كل زاوية، ومع ذلك صنع الناس مغامراتهم دون غطاء سياسي.
اضطرت السلطة السياسية في مصر بعد تعالي أصوات الغضب، إلى تبنّي مظاهرات داعمة لفلسطين، وقررت هندسة المشهد واستخدامه للدعاية أيضاً. وصار يوماً لتفويض الرئيس بدلاً من دعم غزة. لكنّ الغضب الحقيقي لا يُهندَس، ولا يمكن الوثوق في خروج المصريين للشوارع. قالها نجيب محفوظ مراراً في ملحمته الروائية: إيّاك وغضبة الحرافيش! استجابت المعارضة المدنية لدعوة النظام للتظاهر لنصرة غزة، لكنّها تخلّت عن الأزهر وناسه وجمهوره الحقيقي، ذهبوا لمساحة الغضب المسموح.
ذهبنا معهم إلى الأزهر. كنا عشرات من الصحفيين والنشطاء، وشباباً حديثي العهد بالمشاركة السياسية. كانوا أطفالاً وقت ثورة يناير. أقيمت الصلاة تحت حراسة مشددة. القوات والمدرعات والمصفحات تحتل الشارع وتمنع مرور السيارات. ومع كل أجواء الترهيب، قاطع المصلّون مرحلة الدعاء بعد انتهاء الصلاة، هتفوا لغزة وبدأت المناورات داخل الجامع لمحاصرة الناس. لكنّ اندفاعهم سمح لهم بالخروج من الأسوار. استطاعوا مواصلة السير في شارع الأزهر. حاول الأمن عدم الاصطدام مع المتظاهرين الذين زاد عددهم. وهتفنا حينها الهتاف الذي غيّر المعادلة، والذي منع استخدام مظاهرات دعم غزة لتبييض صورة النظام المصري: دي مظاهرة بجد مش تفويض لحد!
فشل النظام في دعوته لحشد مأجورين للتظاهر، ونجحت المظاهرة الحقيقية من الأزهر. بدأت رحلة أجيال جديدة للميدان الذي لم يدخلوه من قبل، ولم نقترب من حدوده منذ 10 سنوات، لكنه النداهة الأبدية لأجيال الغاضبين في عصرنا.
تحوّلت الفكرة التي قرّر النظام تجريبها إلى كابوس. ما أن يعود الناس إلى الشارع، سوف يصلون سريعاً إلى سبب نكبتهم. هتفت الجموع «عيش، حرية، الأرض فلسطينية» في ميدان التحرير، وحّدوا بين مطالبهم وحريتهم وخبزهم بدعم فلسطين. لشباب اليوم حماسة كبيرة ورغبة في مواصلة توسيع رقعة الاحتجاج. لكن النظام الذي أغضبته الهتافات الشعبية، بدأ العصف، اعتداءات واعتقالات للعشرات من الميدان والشوارع المحيطة. استمرّ غضب الشباب وقرروا مواجهة الوحش فى شوارع وسط البلد لأول مرة، دخلوا إلى الشوارع الجانبية، مزّقوا صورة الرئيس الموضوعة في منطقة شعبية.
انتهت أحداث اليوم بحملة اعتقالات واسعة من المنازل للشباب الذين شوهدوا في الأحداث. وانضمت قضية معتقلي دعم غزة إلى مئات القضايا التي لفّقها النظام السياسي للشباب والمعارضين، ولا يزال أغلب هؤلاء المعتقلين في السجون من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى الآن. أنفقوا من أعمارهم عاماً دعماً لغزّة.
في الأسابيع التالية، مُنعت الصلاة فى جامع الأزهر نهائياً إلا لافراد الشرطة. ظلت أحداث الحرب تتصاعد، وظل الناس يذهبون للأزهر لمحاولة الصلاة والغضب. فشلوا في الإثنين. رأينا الغضب يمشي متجوِّلاً في شوارع وحارات الأزهر والحسين، ولا يجد من يجمعه من صدور الناس ليتحوّل إلى فعل سياسي جماعي. هنا شاهدنا الفرصة وهي تنساب من كفوفنا، حين تركناهم وكان بديهياً أن يتركونا.
جزيرة نقابة الصحفيين
في قلب الحراك الذي أعقب طوفان الاقصي، وقفت نقابة الصحفيين المصريين وحدها بين النقابات المهنية والسياسية التي فضّلت طاعة النظام والالتزام بفعل الصمت والاكتفاء بالبيانات. حتى نقابتا المحامين والأطباء، واللتان كانتا من أنشط النقابات في قضايا فلسطين على مدار عقود، سقطتا تماماً في جبّ الأجهزة الأمنية. ومع ذلك، راحت نقابة الصحفيين تنظم المؤتمرات وتفتح سلالم النقابة للتظاهرات من جديد، ودعا صحفيّوها ونقيبها لتنظيم قافلة ضمير العالم لوقف الحرب وإدخال المعونات إلى غزة وقت الحرب. ولاقت الفكرة حماس عدد كبير من مجموعات التضامن العالمية، وبالفعل وصل العشرات منهم إلى مصر. ثم منعت الأجهزة الأمنية تحركهم، بل وألقت القبض على بعضهم ورحّلتهم لبلادهم، ليصبحوا عبرة. حوصرت النقابة كمقرّ وحيد لتجمّع الشباب والمحتجّين على الإجرام الصهيوني، وبات أعضاؤها الفاعلون والنشطاء المتردّدون عليها مهدَّدين بالاعتقال دائماً، ونقابتهم مهددة بحصار الموارد وغضب أعضائها على جرّ النقابة للعراك مع النظام بالنيابة عن جموع الغاضبين الصامتين. ولطرق حصار النقابة، قصة لا بدّ أن تُحكى بشكل منفصل، إذ كان الهدف أن تتحول إلى جزيرة معزولة، يراها الناس من بعيد ولا يستطيعون الاقتراب!
رأينا بأمّ أعيننا. لم يتخلَّ بسطاء هذا الوطن عن غزة أو لبنان. رغم تعاظم الفقر والسجون والتهديدات، نما الوعي العام في مصر خلال هذا العام، بشكل سريع، والغالبية تعلم الآن أنّ الصهاينة يحكمون بلادنا. سمعتُها بأذني مراراً، وأن هناك سلطة مرتعدة من فكرة فتح مجال التظاهر من أجل غزة ولبنان، خوفاً من أن تردّ الطلقة في صدرها، وأن هناك طبقة من الساسة والمثقفين تركوا أصوات الناس وحدها في الشارع. كان واضحاً أنّ الشعب عاد مهزوماً في محاولته، عاد للتطبيع مع الفقر والصمت، ننام ونصحو على وقائع الإبادة المروعة وندرك أنّ لنا فيها يداً وجرماً وذنباً، ثم يأتي من تسبّب في فقرنا وضعفنا ليقارن أوضاعنا لكونها أفضل ممّا يعانيه أهالي غزة الآن، يقارن ما حدث للمصريين في عهده بما يحدث على يد الاحتلال الوحشي الذي يمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرق. لقد كان تشبيهاً في محلّه لندرك حقيقة ما نواجهه.
والآن، ومع دخول الحرب الصهيونية عامها الثاني ودخول لبنان وشعبه على خط المواجهة، نقف جميعاً مشدوهين أمام الاحتراق الذاتي لبلادنا. الجميع يخشى اللحظة غير المعلومة، عندما ينفجر جبل الصمت وتتهشّم اللحظة فوق رؤوس الجميع، ظالمين ومظلومين.
أثناء كتابة هذا النص، وفي ذكرى مرور العام الأول على الطوفان، خرج بعض الشباب إلى أعلى جسر (كوبري) يربط وسط المدينة بعدة أحياء مزدحمة، رفعوا لافتات دعم لفلسطين ولبنان. إحداهنّ كانت تمسك بميكروفون وتهتف بصوت وحيد وسط ضجيج المدينة وأهلها المنكوبين. محاولة خطرة جداً في مصر، من شباب لا ينتمون إلى أيّ حركة أو حزب أو تنظيم سياسي، محاولة عفوية وثمنها يُدفع فورياً، قُبِض على البنات الخمس وشاب، اختفوا لساعات وظهروا بعد يومين، اتهموا برفع أعلام فلسطين ولبنان وحيازة الكوفيّة الفلسطينية، والجهر بالصياح، اتهامات لا تدين المتهمين، بقدر ما تهين السلطة التي توجّه هذا النوع من الاتهامات لشبابها الذين تجعل منهم عبرةً لكسر شوكة هذا الشعب. شاهدَ خبرَ القبض على الشباب ملايينُ المصريين المضرّجين بالصمت، غضبنا ولعنّا وخجلنا، ولا نزال في مكاننا.
أُدرك أنّ حالنا يثير العجب في كل الأوضاع. فحين نثور ونخرج للشوارع، لا شيء يستطيع قمعنا، وحين ننام، ننام طويلاً في وضع أشبه بغيبوبة سريرية لا يعرف مداها الأطباء. وبين هذا وتلك، تحصل تفاعلات، تشبه حين يحرك النائم أصابعه في الهواء. وهذا النص معنيّ باستذكار حركة النائم وسط الغيبوبة!