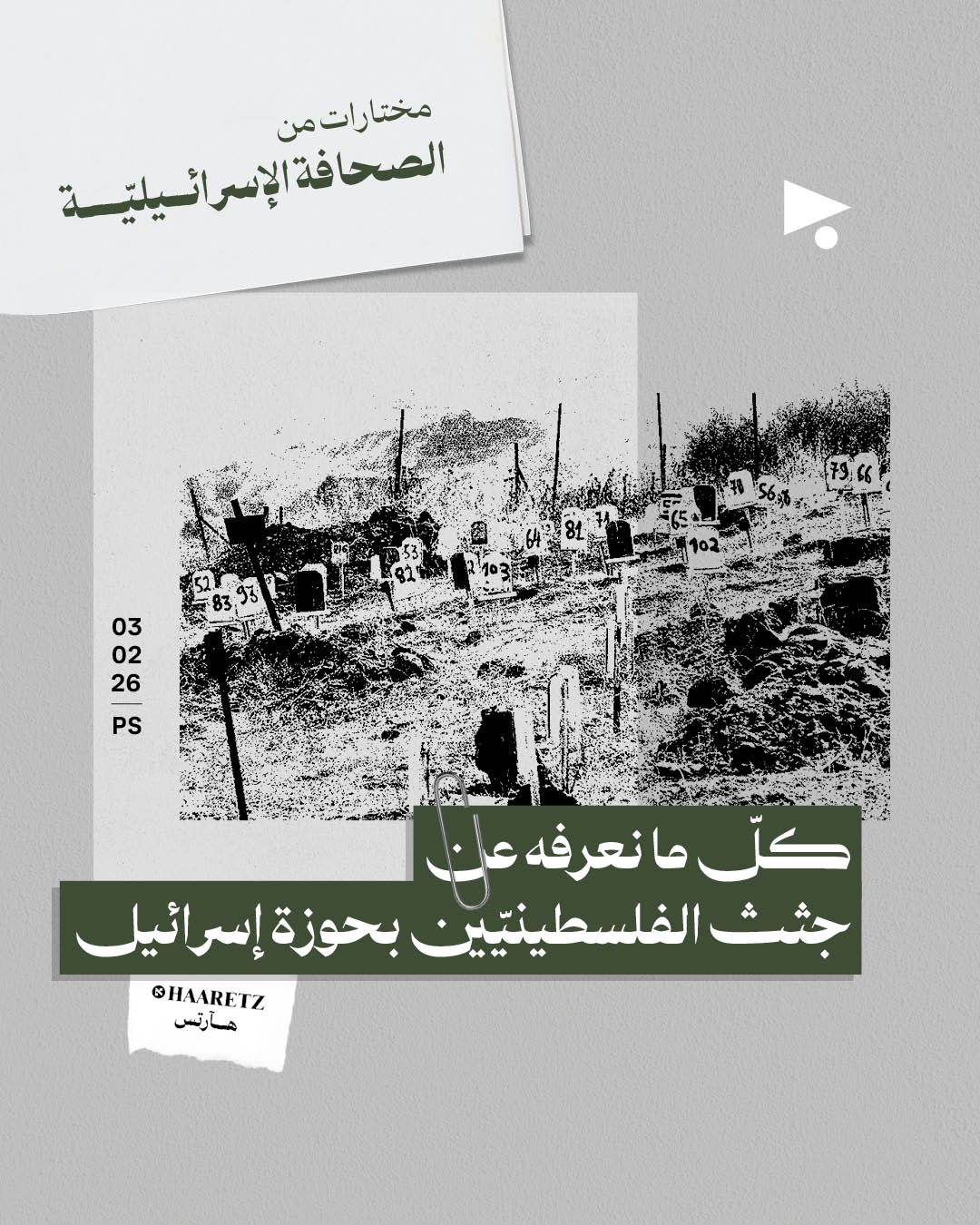ظهرت في الآونة الأخيرة، أو بالأحرى تعممّت، تقنيةُ قمعٍ تنطلق من «استياءٍ شعبي» مزعوم. استياءٌ يسبقه موجة تحريض لها آليتها، ويليه قمعٌ وقضمٌ لمساحةٍ جديدة كانت خارجة على طاعة السلطة. مع نضوج هذه التقنية، يكون النظام اللبناني قد دخل في طورٍ قمعي جديد، يجمع بين (1) خطاب كراهية معمّم (2) وأدوات الدولة، من منع وتشريع وقضاء وأجهزة أمنية، (3) وغضب شعبي مُستحدَث وموجَّه ومَبني.
أُطلقت اليوم يد رقابةٍ تدّعي أنّها رقابة شعبية، ولكنّها في الواقع رقابة فئوية، متطرّفة، تترجم أشهراً من التحريض الممنهج المتواصل. ومع إطلاق يد هذه الرقابة، نكون قد فتحنا الباب أمام قمع غير محدود.
«الشارع» تقنية سلطة
الشارع ليس تعبيرًا مباشرًا لعواطف الناس أو «للرأي العام». هو تقنية سلطة لها محرّكيها ومؤسّساتها. ففي لحظة استجواب الكوميدي نور حجار لدى الشرطة العسكرية، كان هناك من ينكش في أرشيفه عن مزحةٍ يمكنها تجييش «الشارع» ضد صاحبها. هناك من بحث، ثم اجتزأ ولفّق ورمى الزيت على النار، ثم ثمّة من تلقّف الفيديو وأرسله إلى غروبات الواتس آب وشبكات التواصل الاجتماعي، وهناك من حرّك بعض «المفاتيح» ورجال الدين، وهناك من دعا لتظاهرات ومَن صوّرها، ومَن سرّب رقم هاتفه، ومَن اتّصل وهدّد. وهناك أيضاً غطاء مؤسّساتي وراء هذا التحريض من إخبارٍ قدّمته دار الفتوى وإشارةٍ لمحامي المنظومة المدّعي العام التمييزي غسّان عويدات.
«الشارع» والقمع
صحيح أنّ هذا القمع يبدأ بعد حراكٍ رسمي نابع من أجهزة الدولة والدين، لكنّه ينتهي أيضاً بأن يطلق حراكاً رسمياً جديداً بين أجهزة الدولة والدين، أشدّ فتكاً ممّا كان عليه بالبداية.
الفارق اليوم مع محطّات القمع السابقة هو وجود هذا «الشارع». فحالات المنع والقمع السابقة (مثل ما قام به السنة الفائتة وزير الداخلية) بدت وكأنّها مقطوعة عن أي سياق خارج قمع الدولة. كانت مقاومتها أسهل. أمّا اليوم، فقدّم الشارع «شرعية شعبية» لقمع الدولة المؤسساتي. فتحوّلت الدولة من قامع إلى طرفٍ «يستجيب لمشاعر الجماهير المخدوشة» ويدافع عن أخلاق عامّة باتت بخطر. هكذا، تترفّع الدولة عن الصراع، وتوهمنا أنّها الحكم بين «شارعين»، أو بين «شارع» وأحد الفاسقين. تدّعي الدولة أنّها تقمع لا لأنها تقمع، بل حقناً للدماء وحفاظاً على السلم الأهلي المزعوم. الدولة، بهذا المعنى، ليست إلّا مَن يستجيب لمطالب الشعب الرافض لهذه «الأقليّة» الخارجة عن المعيار.
ابتزاز النظام
لكنّ الشارع يقدّم أكثر من ذلك. يفتح المجال لنوع من العنف الخبيث، القائم على الإذلال والنبذ. فليس المنع أو التوقيف ما يشكّل سلاح «الشارع»، بل إذلال الضحية بعمق يومياتها ومن ثمّ نبذها من المجتمع، غالبًا من خلال الضغط على محيطها ومجتمعها المصغّر. عنف «الشارع» لا يُعاقب، بل يطّهر، لا يرتاح إلّا بعد تدمير وإخراج الدخيل من بيئته ريثما تعود إلى طهاراتها المفقودة. وفي وجه هذا العنف، تتحوّل الدولة القامعة إلى «الحامي» من غضب «الشارع».
يضعنا النظام أمام ابتزاز واضح المعالم: إمّا العودة الطوعية إلى كنفه طالبين الحماية من مجموعات الشارع، أو مواجهة عنفهم، المحمي بدوره من الأجهزة الأمنية والقضائية. أي بكلام آخر، يخيّرنا النظام بين شقّه المؤسّساتي أو شقّه «الشعبي». الخيار هو بين مواجهة غسان عويدات وقراراته غير القانونية أو مواجهة دار الفتوى وتهديدات القتل التي أطلقتها مجموعات مستاءة من مزحة. الخيار هو مواجهة القوى الأمنية وعنفها أو مواجهة جنود الرب وتهديداتهم بالقتل.
الأنظمة القمعية
لنخرج لحظة من الاستثناء اللبناني. ما نشهده اليوم في لبنان هو تقنية استعملتها سائر الأنظمة القمعية، من مصر وإيران، وصولاً إلى الأنظمة الفاشية التي ظهرت في أوروبا في أوائل القرن العشرين، حيث وجدت أو ابتكرت الأنظمة أطر شعبية ومجتمعية، تقوم بالقمع المباشر أو بالمراقبة المجتمعية، وتؤمّن غطاءً شعبياً لسياسات الدولة.
غالباً ما تستغلّ الأنظمة القمعية والفاشية القلق الشعبي الناتج عن الأزمات الاقتصادية والسياسية لتحويله إلى موجة غضب جماهيرية ضدّ فئة اجتماعية محدّدة (اليهود، المسلمون، المهاجرون، الشيوعيون، المثليون إلخ). تهدف حملات التحريض على الفئات الأضعف في المجتمع إلى حماية النظام من التداعيات المحتملة لقلق الناس حول مصيرهم. بالمقابل، تبسط حملات التحريض أكثر فأكثر هيمنة هذا النظام على مساحات يكون قد فقدها بفعل خروج هذه الأقليّات عن طاعته، كما يُستخدَم التحريض لإعادة إحياء غضب شعبي، حتّى يصبح نمط العلاقات الاجتماعية قائماً على الكراهية والحقد والعنف، فتُسحَق أي مبادرة أو تنظيم اجتماعي مُحتمَل.
الانقضاض على مكتسبات 17 تشرين
لأوّل مرّة منذ 17 تشرين، يخوض النظام معركة الرأي العام، متّكلًا على دعم «شعبي» لقمع «الشذوذ»، أو على استياء أهلي من مزحة. بعد قُرابة 4 أعوام على الانتفاضة وبداية الانهيار ومن بعده الانفجار، يعود النظام بنا إلى ما قبل كلّ هذا، إلى سنوات القمع المُريح. وبعد 4 سنوات على محاولة النظام استعادة أحقّيته السياسية، وجدها أخيرًا في حملته للدفاع عن «الأخلاق العامة».
في سجّلات النظام وأجهزته، فِيَش ولوائح، وتحديد للمسؤوليات والعقوبات المناسبة على شكل «فركة أذُن» بتوقيف من هنا، أو ملاحق قضائية من هناك، أو منع لنشاطات أو حتّى تشبيح في الشارع. في هذه المعركة الجديدة، ينقلب النظام على انتفاضة 17 تشرين، كتصفية حسابات مع اللاعبين الذين ساهموا بزعزعة سطوته وتهشيم صورته وكسر قدسيّة زعاماته: من ناشطين، وصحافيين، ومحامين، ونقابيين، وكوميديين وغيرهم. جميعهم تحدّوا الثورة المضادّة الجارفة وساهموا باستمرار شيء من الحالة الاعتراضية، سياسيًا، قانونيًا، أو حتّى خطابيًا، حتّى بعد انتكاس الانتفاضة. لكنّها أيضًا تصفية حساب مع بوادر مجتمع ظهر إلى العلن في الانتفاضة، مجتمع خربط صور نمطية عفنة وكسر سطوتها وفسّخ قوالبها.
رمّم النظام نفسه، وعاد قويًّا لدرجة قدرته على جمع مختلف عناصر الديكتاتوريات المتناقضة حتى، دين وعسكر وأحزاب وزعماء ورموز، يتعايشون في نظام واحد في دولة واحدة في مشهد قمعي واحد.