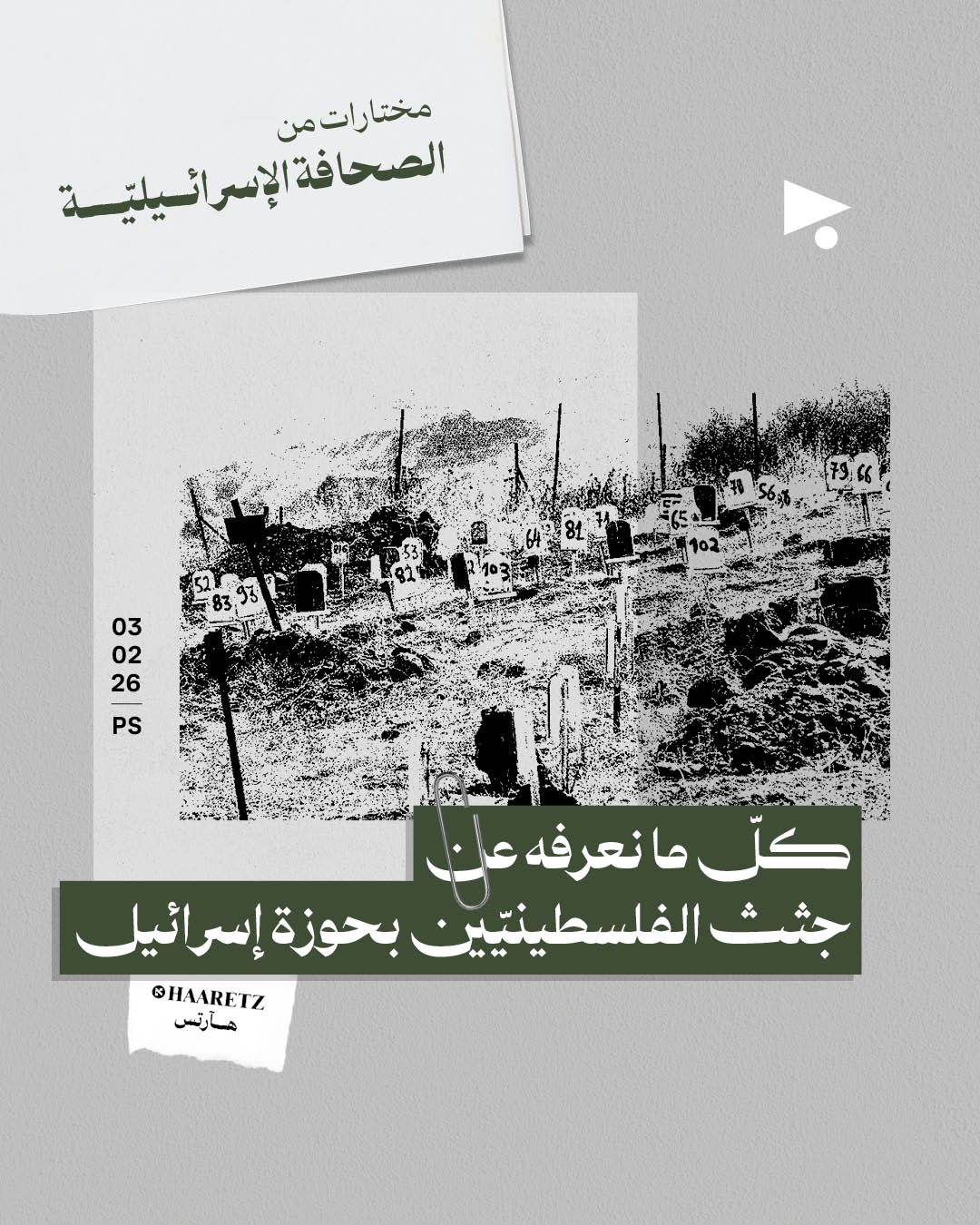فلسطين والتطبيع العربي
منذ عقود من الزمن، وخاصة بعد انتهاء مرحلة أوسلو، لم يعد هناك قابلية عند المجتمعات العربية للتضامن مع القضية الفلسطينية، خارج الفولكلور القومي وأغاني بعض مطربي الدرجة العاشرة. فزمن القضايا كان قد ولّى، وحدود المخيلة السياسية باتت مضبوطة ضمن الحدود الوطنية. كانت «فلسطين» من رواسب ماضٍ انتهى، مثلها مثل «الاشتراكية» أو «الناصرية» أو «القومية».
كان لهذا الفتور التضامني عدد من الأسباب، منها تخلّي الأنظمة عن «مركزية» هذه القضية من أجل تسوية أمورها مع حاكم العالم الجديد، ومنها استغلال هذه القضية من قبل «ممانعيها» لمآرب سياسية، ومنها شعور عام بأنّه تمّ التضحية بالكثير من أجل قضية «خاسرة» من قبل دول ومجتمعات جوار لا تتشارك مع أصحاب هذه القضية إلّا قرابة قومية باتت حملًا ثقيلًا.
في هذا المناخ من اللامبالاة، بدأ التطبيع العربي في عام 2020، والذي لم يلاقِ أي اعتراض شعبي أو سياسي يُذكَر. بدا التطبيع وكأنه طبيعيّ، وحتى متأخّر بعض الشيء. وإن بقي هناك كلام فضفاض عن حقوق الفلسطينيين وضرورة إقامة دولة فلسطينية، كان واضحًا أنّ هذه القضية الفلسطينية لم تعد تشكّل أي اعتبار في سياسات الدول المطبّعة، ما شكّل خروجًا حتى عن موقف «معتدل» كمبادرة الملك عبدالله للسلام في عام 2002.
لكنّ اللامبالاة لم تكن مجرّد مناخ فضفاض. لقد شكّلت هذه اللامبالاة أيديولوجيةَ هذه الاتفاقات ومنطقَها، والتي باتت تعتبر أن «السياسة» هي المشكلة. فلا داعي للكلام عن حقوق أو دولة مستقلة أو عدالة، فهذه مفاهيم خلافية لا مكان لها في عالم التطبيع. هكذا استُبدِل هذا الكلام بشتى أنواع الاتفاقيات «التقنية»، من الأمن إلى الاستخبارات إلى الاقتصاد إلى التعاون الاقتصادي.
في هذا العالم، ليس من مكان لفلسطين. في هذا العالم العربي المحكوم من ملوك وأمراء وقادة عسكر، لا حاجة للسياسة أيضًا، وإزعاجها. أنظروا إلى الخليج، ثمّة ذكاء اصطناعي في كل مكان، كما قارن أحدهم الإمارات بغزّة في لحظة إبادتها، وذلك لأنّه ليس هناك من سياسة. تخلّوا إذاً عن السياسة، وهناك في انتظاركم وظائفُ ومدارسُ ومعارض فنية وتمويل ومطارات ومولات وتطبيع.
دروس غزّة وسوريا
كان ذلك قبل الإبادة. أمّا بعدها، وبعد عودة فلسطين إلى وسط السياسة محمولةً من وسائل تواصل لا تحكمها الأنظمة، بات العالم بحاجة إلى تأديب. فكانت غزة الدرس لكل من يريد أن يقاوم، أو حتى أن يعارض إسرائيل، أو أن يطالب بعالم تحكمه بعض العدالة، الحدّ الأدنى منها. والدرس يحتاج إلى تلقين وتكرار وحفر في الجسد. وهذا ما تفعله إسرائيل في دعايتها للإبادة والافتخار بها في ظل عالم يدعمها سياسيًا وعسكريًا. بات الدرس واضحًا: حدود العالم القانونية والأخلاقية تنتهي هنا، الفلسطينيون ليسوا جزءاً منه. إمّا تقبلون هذا وإلّا فإنّ الإبادة بانتظاركم.
الدعاية جزء من الإبادة، كما كانت دعاية النظام البعثي جزءًا من إبادته آنذاك، والتي أعلنت نهاية الربيع العربي. وقتها، انصدم الجميع بالصور المروّعة عن تجويع وحصار وتعذيب وقتل في ظل عالم قرّر أن لا يتدخل. لكنّ هذه الصور لم تكن خطأً أو تسريبات أو تباهياً من قبل ميليشيات غير نظامية، كانت درس سوريا، ومفاده أن أي مطلب سياسي، مهما كان ضئيلًا، سوف يواجه بالإبادة. من بعد هذا الدرس، انتهى الربيع العربي وبات «مسموحًا» للأنظمة أن ينكلوا من جديد بمعارضتهم.
وإن دعمت دول الخليج بعض هذه الثورات لأسباب مرتبطة بخلافها مع إيران، فقد كان واضحًا موقفها المعارض من حركات الاحتجاج هذه، من اليمن إلى البحرين. وفي آخر المطاف، كان درس سوريا يصب في مصلحة كل الأنظمة العربية. فبعده باتت المطالبة بالديموقراطية أو المشاركة السياسية أقرب إلى كفر، ثمنه إبادة الساذج الذي طالب به ومجتمعه بأكمله. وبات الاستقرار اللا-سياسي للأنظمة أفضل من مآلات السياسة الدموية.
درس سوريا أعلن هجرة السياسة من منطقتنا من باب الديمقراطية، وغزة أعلنت هجرتها من باب فلسطين، إبادتان ستحدّدان شكل المنطقة للعقود القادمة.
عالم بشع يتحضّر
منذ الـ2003 إن لم يكن من قبل، والعالم يهددنا بـ«شرق أوسط جديد». كان من المفترض أن يكون ديموقراطيًا في حينه، خالياً من التطرّف، وأصبح اليوم «خيراً»، يصنعه نتنياهو الذي أوضح أخيرًا حدود عملياته العسكرية: الشرق الأوسط.
منذ بداية الحرب، والغرب يريد أن يصوّر نتنياهو كخارج عن العقلانية الغربية، قائد عسكري لم تعد تضبطه أي حدود، المسؤول الوحيد عمّا يجري، فاقد لأي رؤية في المدى البعيد. لكنّ هذا جزء من الدعاية. نتنياهو يقوم بالعمل القذر الذي لا تريد أي من الحكومات الداعمة له، غربيًا أو عربيًا، تحمّله. هو الإبن الضالّ الذي أخذ على عاتقه أن يُتّهم بالإبادة التي يحتاجها هذا النظام الجديد لإتمام شروطه.
لنتنياهو رؤية، رغم اعتقاد العديدين أنّه يدمر لمجرّد التدمير، أو هربًا من ملاحقات قانونية قد تطاله بعد انتهاء الحرب. وهذه الرؤية لا يمكن فصلها عن مسار التطبيع الذي سبق «طوفان الأقصى»، والذي يُنذر بحكم جديد في المنطقة، يدمج بين التقنية الخليجية والأمن الإسرائيلي والقمع النظامي. هو عالم بشع ينتظرنا، عالم تديره إمارات وممالك ودولة فصل عنصري، ممسوك بشبكات المراقبة والتجسس المشتركة، ومحمول من عنهجية المنتصر. هو عالم أباد مطالب المشاركة في سوريا ثم أباد مطالبة العدل في غزّة، ليعرض على من بقي هنا أن يكون «مواطن درجة ثانية».
على هامش هذا العالم
على هامش الإبادات، تدور السجالات العفنة لنخب ثقافية عالقة في عالم ولّى، مع ترّهاتها عن الهزيمة والمقاومة، الغرب والشرق، المحور والمحور الآخر، لتحاول قول ما «عليها» أن تقوله. من جهة، هناك «الليبرالية العربية» التي تشمت، ولم تلاحظ أنّها لم تعد إلّا الغطاء اللفظي لتحالف العسكر والتقنية، لا يجمعها بالليبرالية إلّا الإسم. ومن جهة أخرى، هناك ممانعة، برّرت الدماء على مدار السنوات، حتى باتت جثّة فكرية، لم تعد تستحق حتى الدفن. ندخل هذا العالم الجديد غير مهيّإين حتى لفهمه، متمسكين بخطاب وثنائيات لا تصلح إلّا للتراشق الإعلامي الرخيص.
وعلى هامش هذا العالم الجديد، تتساءل هذه البلاد، في لحظة تدميرها، ما إذا كان من الخطأ الدخول في جبهة الإسناد أم لا. يبدو سياسيّو هذا البلد خارج اللحظة، من حزب الله الذي يعاند في لحظة تدميره وتدمير البلد إلى معارضته التي تستعجل تكرار لحظات الماضي مع أخطائها. لم يدركوا بعد أنّ لبنان اليوم بات بلدًا للبيع بجيشه وشعبه ومقاومته ومعارضته، وثمنه رخيص جدًا في هذا العالم الجديد. وليس هناك ما يمكن فعله لتحصيل ثمن أفضل إلّا بعض الوفاق، وفاق قد يجنّبنا لبعض الوقت الحرب الأهلية القادمة.