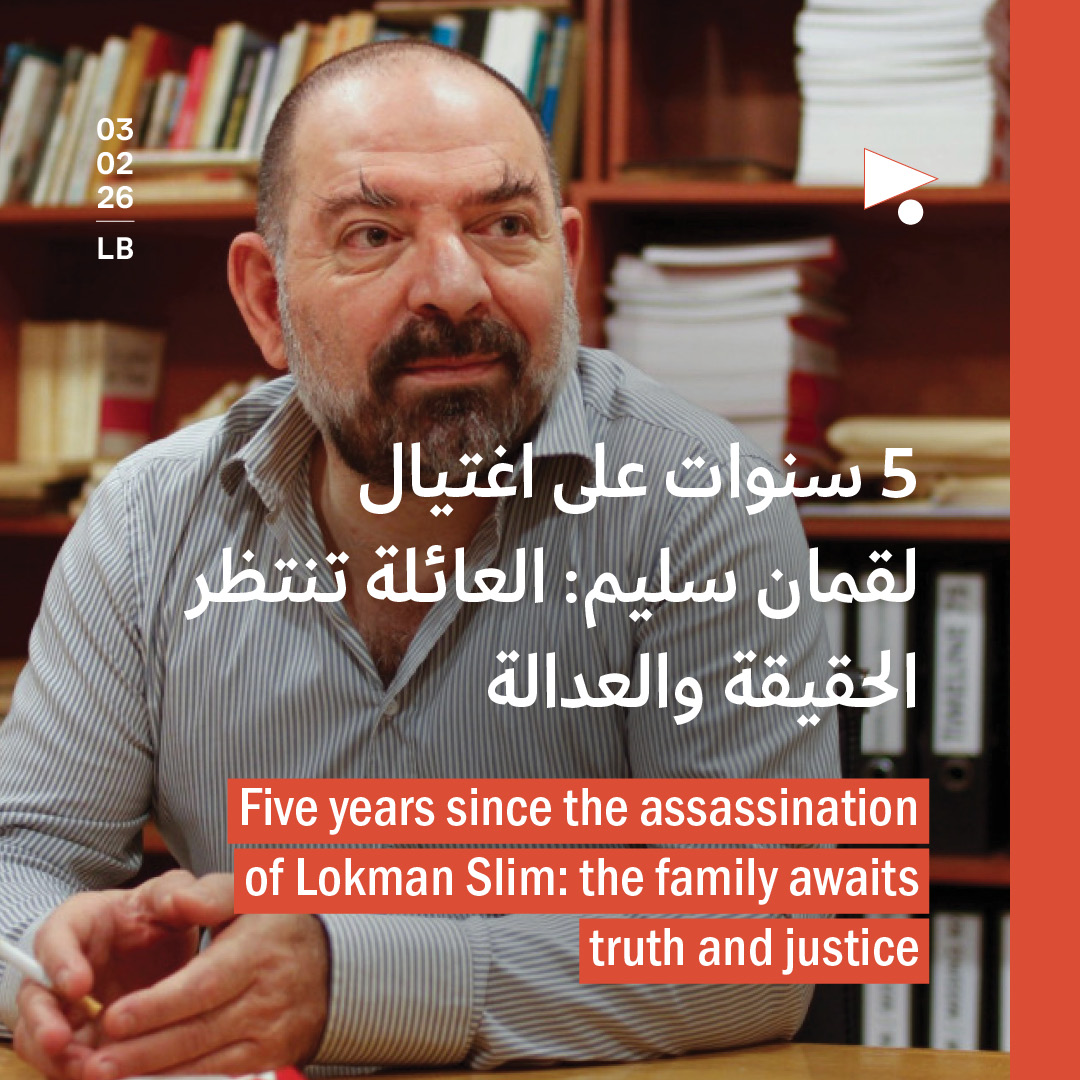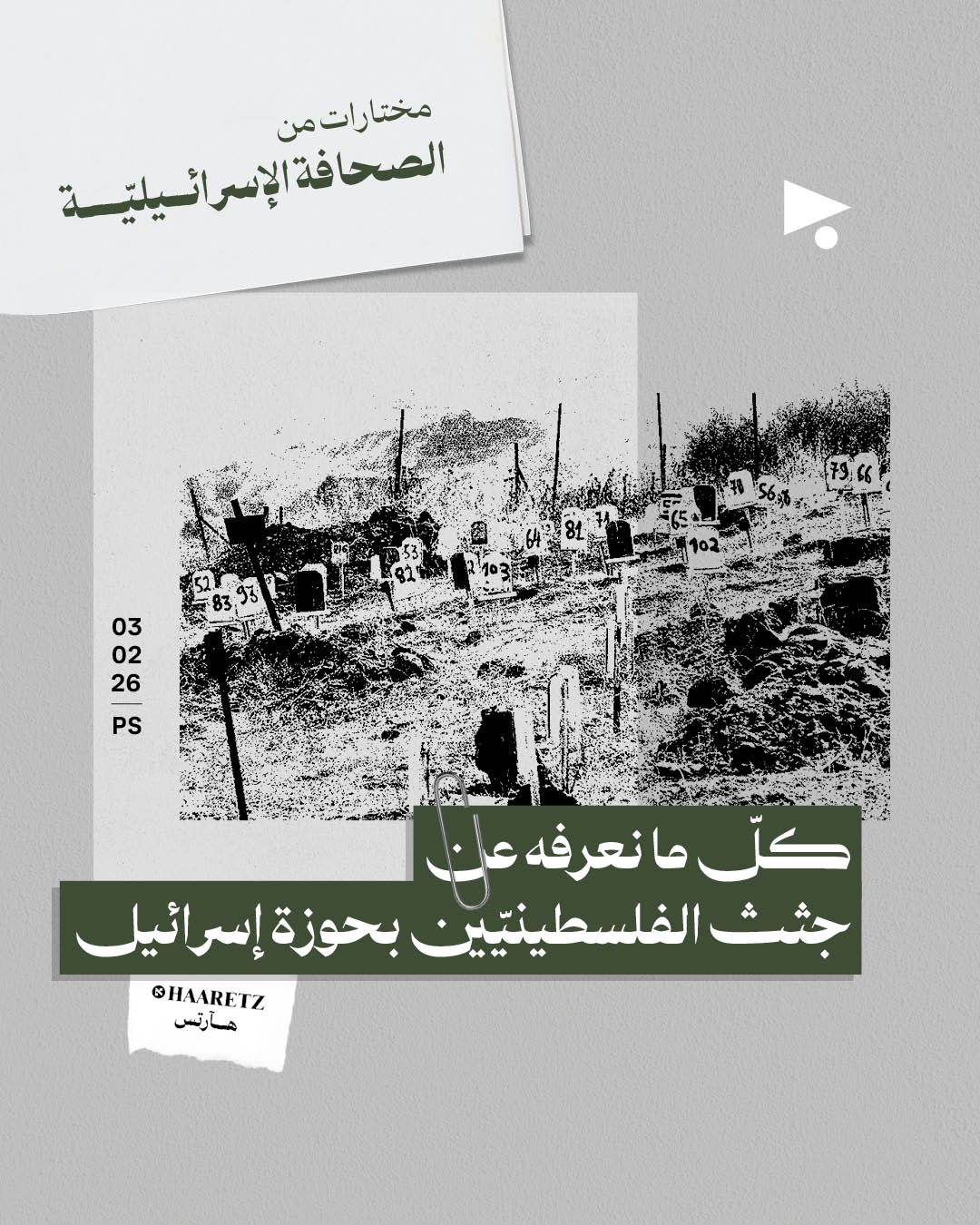في بلد يبحث عن أي إشارة لوحدته، هناك شبح يبدو وكأنّه يوحّد اللبنانيين: الشهابيّة. فيه يرى دعاة الدولة أبًا لهم، وفيه يرى الرؤساء القادمون من العسكر النموذج الأول، وفيه يرى المعارضون فرصتهم الضائعة، وفيه نجد لحظة التأسيس المجهض لمؤسسات الدولة اللبنانية. هو الخارج المنقذ، ضحية الداخل الفاسد. لكنّ تجربة فؤاد شهاب، كما يرويها فادي بردويل، ليست الاستثناء لأمّة قيد الإنشاء، دائمًا قيد الإنشاء، لكنّها أحد تجليّات هذه الأمّة.
كُتب هذا النصّ في آب 2023 لملفّ لم يُتَح نشرُه عن تجربة الرئيس فؤاد شهاب في الحكم، بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاته (1973). نستعيده الآن، في سياق الحديث الحاليّ عن نيو شهابية، وبلا أي تعديل، حفاظاً على الأمانة التاريخية، بالرغم من الفرق الشاسع بين لحظة كتابته وأجوائها التي تظهر بوضوح في سوداويّة خلاصته، ويومنا هذا.
يتناول النصّ ركائز بناء أسطورة الرئيس المُنقذ، التي لم يمثّلها أحد كما فعل الرئيس شهاب، ويضيء على المعضلات البنيوية التي تلازم أصحاب فكرة الخلاص الآتي من خارج «السياسة التقليدية»، سواء كانوا من العسكر أو التكنوقراط. لم يكن اللواء شهاب مجرّد رئيس جمهوريّة بين آخرين، بل تحوّل مع الزمن إلى رمز الجمهوريّة الأسمى الذي سعى كُثُرٌ من بعده إلى التمثّل به. فاستعاروا أدبيّات الشهابيّة وادّعوا، كلٌّ على طريقته، استئناف مسيرته الإصلاحيّة.
ليس هدف تلك الاستعادة التاريخية التكهّن بما ستحمله الأيّام الآتية، من خلال التلميح، مثلاً، إلى أنّ المستقبل لن يكون إلا تكراراً حتميّاً للماضي. فالعقود الخمسة التي تفصلنا عن وفاة الرئيس شهاب، شهدت حروباً ومجازر واحتلالات وديوناً وانهيارات وتلاحماً أعمق بين الممارسة السياسية والعصبية الطائفية، وشبه انقراض للمصلحة العامة مقابل انتفاخ بلا حدود للمنفعة الخاصة، وتسيُّد الميليشيات على الدولة وتجويف هائل للعدل والأجسام الرقابية. ولكن أيضاًَ، وفي مقابل كلّ ذلك، لأن الاقتناع بأن مصيرنا هو تكرار الحاضر للماضي، ينفي إمكانية السياسة ويغفل عن مكر التاريخ ومفاجآته.
النهاية
ليلة متوتّرة
لم يتوقّف الرجل السبعيني عن مجّ سيجارته بإلحاح في ذلك المساء من نيسان 1973.
المعلومات الواردة عن الرئيس شهاب في الجزء الأوّل من النصّ (أوّل ثلاث فقرات)، تستند إلى ما نقله مساعده العميد الركن المتقاعد ميشال ناصيف في «الرئيس فؤاد شهاب كما عرفته»، مجلّة الصيّاد، 23 نيسان 2003.
لم ينعكس على مزاجه جوّ جونية الربيعي آنذاك، في زمن تتالي الفصول الأربعة الذي ذهب إلى غير رجعة. كما أنّه لم يقُم بأيّ جهد يذكر لإخفاء توتّره أمام من أتى لزيارته في منزله المتواضع، خاصّة إذا ما قارنّاه ببذخ وفحش أزلام النظام اليوم.
لم تكن تلك الليلة استثنائية… أو ربما…
لكن من المؤكّد أنّ انفعاله ذلك المساء لم يكن ردّ فعل على حادث عرضيّ. وهذا ما أكّدت عليه زوجة الجنرال الفرنسيّة. فعند حضورها اللقاء مع الزائر المقرّب جدّاً من زوجها، رجت زوجها بأن يهدّئ من روعه وانفعاله sinon tu vas claquer- وإلّا رح تطقّ. ثمّ توجّهت إلى الضابط الزائر الذي كان قد عُيّن مرافقاً لزوجها خلال عهده في أوّل الستينات، قائلةً: أنظر، منذ مدّة وهو على هذه الحال، لا سكينة ولا راحة له. واليوم بالذات أحرق بيديه أوراقاً ومستندات هامّة… أظنّها كانت معدّة لتدوين بعض المذكّرات أو ما شابه.
مشهدية حرق المذكرات من قِبل صاحبها، أيّاً يكن، هي سينما خالصة. درامية. كثيفة الدلالات. فكيف بالأحرى عندما يكون الحارق مؤسس الجيش اللبناني ورئيس جمهورية سابق؟ فلماذا أراد الرئيس الوحيد الذي تحوّلت كنيتُه إلى نهج من العمل السياسي، أن يقطع الصلة مع ماضيه؟
حدس الجنرال بالنهايات
هل حدس الجنرال المضطرب باقتراب النهاية، فأقدم على حرق أوراقه الخاصّة؟ لماذا لم يضع عليها إشارة للتلف ويسلّمها لمعاونه؟ هل كان يريد التخلّص من ماضيه بيدَيْه؟ أم أراد التأكّد من تحوّل الآثار المدوّنة إلى رماد، لشكّه بامتثال مساعده لأمر التلف؟ هل فعل ذلك ببرودة، بعد تخطيط؟ أم أنّ الحرق أتى في لحظة انفعال عالية؟
لا نعرف.
ولكن عن أي نهاية نتحدّث بالأصل؟ رحيله هو؟ اندثار أحلامه ومشاريعه؟ خراب الجمهوريّة؟ ربما أراد الجنرال الإشارة إلى أنّ الآتي من الأيّام لن يشبه ما اختبره. لا فائدة في هذه الحالة من الاحتفاظ بمدوّنات يتفحّصها مؤرّخون، وينتقدها خصوم، ويقدّسها مريدون. الحرق فعل قطيعة مع الماضي ومع الأجيال الآتية.
لا يمكننا الجزم.
لكننا الآن، بعد نصف قرن على حرق المذكّرات، وموت الجنرال المفاجئ بنوبة قلبية حادّة بعده بثلاثة أيّام، نستدلّ من كلام محدّثنا، زائره الليلي آنذاك، أنّ الرجل في أيّامه الأخيرة كان يشعر بمرارة عميقة. سألزم الصمت نهائياً، قال المعلّم، وهو اللقب الذي كان يستخدمه مريدوه للإشارة إليه، تعليقاً على نقل زوجته حادثة الحرق، وأطلب إليكم من جديد أن تلزموا بدوركم الصمت عنّي. من حظّنا أنّ زائره، ومرافقه السابق، علّق وصيّة المعلّم للحظةٍ بعد ثلاثة عقود، فنقل لنا أنّه في تلك الليلة المتوتّرة، توقّع أمامي، بأن الدولة ستنهار، والجيش سينقسم، والطائفية ستهدم كلّ شيء، وستسيل الدماء بغزارة: ويا ويلنا إن أتت سلطة خارجية تتحكّم بالبلاد وبرقاب العباد… ورأيت دمعة تترقرق في عينيه.
ربيع الحروب الآتية
لم تأتِ توقّعات الجنرال من عدم. ففي العاشر من نيسان، أي قبل وفاته بأسبوعين (25 نيسان 1973)، أقدمت وحدة إسرائيليّة بقيادة إيهود باراك على اغتيال قياديّين من فتح- أبو يوسف النجار وكمال عدوان- والشاعر والناطق باسم منظمة التحرير الفلسطينية كمال ناصر، في شارع فردان. زادت العمليّة من حدّة الاستقطاب الأيديولوجي والطائفي حول المقاومة الفلسطينية بعد أكثر من ثلاث سنوات على تشريع عملها في لبنان (اتفاق القاهرة، 1969) وبدايات الانقسام حول مسألة الثورة أو السيادة.
نزل الألوف لتوديع القادة الفلسطينيّين في مسيرة قيل إنّها ضمّت ربع مليون مشيّع. في هذه الأثناء، شقّت الاغتيالات السلطة إبّان مطالبة رئيس الوزراء بإقالة قائد الجيش العماد اسكندر غانم لمسؤوليّته عن عدم الردّ. تمسّك الرئيس سليمان فرنجية بالدفاع عن الجيش، ممّا دفع صائب سلام إلى الاستقالة.
اغتيالات. آلاف في الشارع. استقالة رئيس حكومة. ومن بعدها… معارك عسكرية:
وفي اليوم الأخير من تقبّل التعازي، وأنا في منزل الرئيس شهاب في جونيه، وردني اتّصال من قيادة الجيش بأنّ الطريق في نهر الكلب قد قُطعت، وتنشب معركة مسلّحة بين الجيش ومسلّحي مخيّم ضبيه… وعليّ أن أبقي المعزّين في جونيه ريثما يتوقف القتال…
لم يمض أسبوع على وفاة اللواء الرئيس حتّى بدأت اشتباكات عنيفة بين الجيش والمقاومة الفلسطينية (2 أيّار 1973) تخلّلها قصف المخيّمات من الأرض والجوّ.
نعرف الآن، بعد نصف قرن على ربيع 1973… التتمّة.
النهج والأسطورة
أسطورة حديثة

تستعاد مراراً، بصيغة أو أخرى، عبارات، نقلها زوّار الرئيس فؤاد شهاب عنه في أيّامه الأخيرة، تغذّي هالته الأسطورية. كلمات تضيف إلى صفاته الخاصّة وإنجازاته العامّة القدرة على استشراف الحرب الآتية. فها هو أب الدولة اللبنانيّة وباني مؤسساتها يتوقّع أيّام الخراب العظيم الآتية وينسحب مباشرة بعد نبوءته.
ما لا يُلتفَت إليه عادة في التناول الأسطوري الذي يعاد إنتاجه وتدويره لسيرة الجنرال، هو إقراره الضمنيّ بهزيمة مشروعه السياسي بعد خمس عشرة سنة على بداية عهده الرئاسي واثنتي عشرة سنة من الحكم الشهابي الذي تخللته رئاسته (1958-1964) ورئاسة شارل حلو (1964-1970). فما نقله عنه العميد الركن ميشال ناصيف- انهيار الدولة، انقسام الجيش، تضخّم الطائفية، سيلان الدماء، فقدان الاستقلال- هو نقيض مباشر لكّل ما سعى إليه.
لكن الأسطورة ليست غريبة عن الشهابية. رافقتها منذ بداياتها. بل هي مفارقتها المؤسسة. فالنهج السياسي الذي قام على مواجهة التخلّف والخرافة والزعامة التقليديّة بإسم التقدّم والإنماء والعلم والمؤسسات الحديثة لم يستعِن بتلك المفاهيم «الحديثة» عند تناول مؤسّسه. على العكس، حاك روايته من عناصر النبوّة، عن رجل العناية الإلهية، المعلّم الآتي من خارج الحلبة السياسية والمترفّع عن دناءتها. فحدّثنا عن ذلك الرجل المتواضع والمنعزل الذي لبّى، بالرغم من أهوائه الشخصية بالابتعاد عن الأضواء، نداء التاريخ لإنقاذ الأمّة. بلور جورج نقاش، الصحافي والوزير الشهابي، كامل عناصر الأسطورة التي يعاد حتّى يومنا هذا إعادة تدوير عناصرها عند تناول شهاب، في نصّ ساحر (الشهابيّة: أسلوب جديد) ألقي بالفرنسية في الندوة اللبنانية في تشرين الثاني 1960، وأعطى الشهابية اسمها.
نبيٌّ مُنقذ رغماً عنه
يبني جورج نقاش نصّه على مجموعة مفارقات وأضداد تجتمع بشخص النبيّ- المنقذ، تميّزه عن غيره من مياومي السياسة وزعمائها التقليديّين، وتجعل منه تجسيداً حيّاً للأمّة:
ففي الحقيقة لم يكن من شيء يهيّئ هذا الجندي الهادئ، الذي أوشك على التقاعد، اللامبالي بالأمجاد، والأكثر ابتعاداً عن جميع ألاعيب السياسة- لم يكن من شيء يهيّئه للدور الذي جعل منه الحكم الأعلى على مصائر الأمّة. لأنه إذا كان هناك من قائد نقيض القائد الذي يستهويه العصيان، فهو هذا. أجل، وفي مقدورنا جميعاً اليوم أن نشهد بذلك: فليس هو الذي سعى إلى التاريخ، وإنما التاريخ سعى إليه: لقد سعى إليه مرّتين، المرّة الأولى في أيلول من عام 1952، وقد تملّص من إجابة النداء… كان من المستلزم أن تقع، بعد ستّ سنوات، هذه المأساة الرهيبة (الاحتراب الأهلي سنة 1958)، التي ما زالت آثارها عالقة بنا، وأن يوشك لبنان على التردّي في مهاوي النكبة بفعل الفظائع المجرمة التي ارتكبها العصاة، ليتمّ الأمر. في ذلك الحين، لم يبقَ ممكناً له أن يهرب من مصيره… نصفا لبنان يقبعان وراء المتاريس، وهذا الجندي وحده، في الوسط، يحتفظ برباطة جأشه وسط الجنون العام، ليس له من خطة غير منع المجزرة الطائفية؟
نقع هنا على كلّ علامات النبوّة. الغريب الخارج عن أطوار أهله وممارساتهم، ألاعيب الكبار وطائفيّة الصغار. المصطفى الذي يختاره التاريخ ويتمنّع في البدء عن تقمّص دور كُتب له ولم يسعَ إليه. المزدوج الشخصيّة الذي تناقض أهواؤه الخاصّة حسّ الواجب العام لديه. صوت العقل المنعزل وسط جنون الجماعات. وأخيراً وليس آخراً، تجسيد ما تبقّى من وحدة الأمّة في لحظة انقسامها الطائفي الحادّ. فهو نبيّ الأمّة الآتي من خارج اللعبة الديمقراطية ووحول السياسة: لستُ أنا من انتخب اللبنانيون: فإنني لا أمثّل غير استحالة اتفاقهم على شخص آخر.
يتابع نقّاش، من ثمّ، بلورة المفارقات التأسيسية للشهابية، فيستخلص أنّ ولايته هي ولاية يأسنا. فلقد مثّل إرادة الأمّة في متابعة الحياة. وإن هذا الميثاق المعقود على عتبة الموت منذ سنتين هو الذي سيستمر. هذا الذي لا يؤمن بإنقاذ أمّة رغماً عنها، ها هو قد أصبح، برغمه، رجل العناية. يرسم لنا نقّاش صورة المخلّص رغما عنه، الجنرال الذي لا يشبه باقي الجنرالات. لبّى النداء لأنّ غرق لبنان السياسي، استوجب تنصيب رجل غير سياسي على رأس السياسة في لبنان.
خارج السياسة وفوقها
قوّة اللواء الرئيس في ضعفه. فهو في آن واحد لا يدين لأيّ طرف سياسي بوصوله للحكم، وكلّ المتخاصمين بحاجة إليه. العسكري المدني المعارض للانقلابات العسكرية، منقذ الديمقراطية بالسلطة العسكرية، من خارج اللعبة السياسية ومن فوقها. فالجيش، الذي على رأسه الجنرال المؤسّس، منع انفجار البلاد في أزمة أيلول 1952، حيث تسلّم فؤاد شهاب مهامّ حكومة انتقالية لبضعة أيّام، أمّنت انتقال السلطة سلمياً من بشارة الخوري إلى كميل شمعون. أمّا أزمة أيار 1958 حيث كادت فتنة مزدوجة أن تتحوّل إلى حرب طائفية، فانتهت بانتخابه رئيساً للجمهوريّة:
وبإمكاننا القول إنّه [أي الجيش] أنقذ لبنان مرّتين على الأقلّ في خلال ستّ سنوات. فبين المؤسسات المتهاوية- عندما كان كلّ شيء يترنّح ويسقط، والأمّة بكاملها تتدحرج في انحدار مستقيم- ظلّ وحده سليماً، ووحده صلباً في الساحة. لقد كان النقطة الثابتة التي تعلّقت بها البلاد- وحولها انتهت بأن كوّنت لنفسها من جديد وجداناً وشرعية.
جسدٌ واحدٌ لطوائف متقاتلة وطبقات متصارعة
الجنرال، أيضاً، هو الساحر الذي لا كاريزما جماهيرية له. موحِّد الأمّة بلا زعامة، وبلا أيّ سند شعبي. وهو أيضاًَ الأمير بفضائل برجوازية: حكمته، ودأبه وبُعد نظره. تواضعه، وحياة أهل الضواحي التي يعيشها على بعد 25 كيلومتراً من عاصمته، يميّزانه عن سلفَيْه [بشارة الخوري وكميل شمعون] اللذين لم يكونا من الأمراء، إنما عُرفا بالبذخ المُذهل. كما إنّه أيضاً السيّد الفلّاح الذي يشعر شعوراً عميقاً بالتفاوت الاجتماعي. أكثر الرؤساء يساريةً من دون أن يميل إلى الأحمر وإلى الماديّة التاريخيّة التي لا يمكن طبعًا لإيمانه الديني أن يرضى بها.
وفي النهاية، وربّما كان هذا الركنَ الأساسي للأسطورة اللبنانية التي نسجها نقّاش بحِرَفيّة عالية، وما زالت تتردّد حتى اليوم: قائد الجيش- الرئيس هو تجسيد الأمّة اللبنانية. فهو في آن واحد غريب عن طباع اللبنانيين، بعيد عن انقساماتهم الطائفية التي تلامس حدود المجازر، معزول عن أوساط السياسيين التقليديين وصفاتهم (المصالح الخاصّة، الفساد، البذخ)، وأفضل تجسيد للطوائف مجتمعة:
ليس هناك كثير من الموارنة يجري في عروقهم دمٌ في مثل صفاء دمه العربي. فهذا الأمير الذي يحكمنا، الذي يُدعى والده عبدالله وجدُّه حسن، والذي هو في الوقت نفسه شيخ كسرواني أصيل، يجمع الظرف إلى العقل، ألا يتحقّق في شخصه الانصهار المسلم- المسيحي الكامل؟ ألا يمثّل دمجاً جسمانياً للطوائف اللبنانية التي هي في أساس مشكلة لبنان؟
فإن كانت الطائفية علّة وجود لبنان وعلّته في آن واحد، كما كتب فؤاد بطرس، بطريرك الشهابية المدنيّة، في مذكراته، فالرئيس فؤاد عبدالله حسن شهاب هو اللبناني الأوّل. فؤاد بطرس، المذكرّات، إعداد أنطوان سعد، دار النهار (2009)، ص. 44. هو الأمّة اللبنانية وقد تجسّدت، والمواطن الذي لا يشبه أيّاً من اللبنانيين القائمين فعلياً على أرض الواقع.
بيّ الكلّ (الأصلي)
ما هو الأسلوب السياسي الجديد للمنقذ؟ إنّه ببساطة أسلوب الأب-المعلّم العاقل، المتأنّي، الحازم. يرتكز جورج نقّاش إلى نظرية سياسيّة لأموري دو ريينكور، عن ازدياد شخصنة السلطة في الديمقراطيّات إثر دخولها عصر الجماهير وتخلّي النخب السياسيّة عن مسؤولياتها، كالقيام بدور الوسيط بين الرئيس والشعب. يرتكز نقّاش إلى كتاب المؤرخ الفرنسي-الأميركي اموري دو ريينكور «قياصرة الغد» (The Coming Caesars, 1957).
ولكن ما حاجة الجماهير إلى أب إثر خيانة النخب لدورها؟ لأنها ببساطة لا قدرة لها على حكم نفسها. لماذا؟ ينطلق نقّاش من نظرة دو ريينكور البطريركيّة التي تقصي كل ما هو «مؤنّث» عن العقلانية، جاعلة الأخيرة ملكاً حصرياً للذكور. لقد دخلنا في عصر الجماهير، يكتب نقّاش متابعاً نقله لدو ريينكور، والجماهير مؤنثة:
تقاد بالردّات العاطفية أكثر بكثير منها بالحكم العقلي. وهذا البحث عن القيصر، عن العظيم، عن الرجل القوي الذي يضطلع بمصير الأمّة، هو ما يسمّيه ريينكور «مركّب الأب». ومن يعني بهذا الأب؟ الأب هو ايزنهاور، هو اديناور، هو ديغول. أوليس هو أيضاً الشهابي؟ هي هذه السلطة الحازمة، هذه القدرة الكليّة المطمئنة لرجل تنازلت له الأمّة، في تمزّق الفئات وعجز المجالس، عن مسؤولية قيادة نفسها. وهكذا ينتهي المجتمع بأن ينعكس في رجل… وهكذا يحصل هذا التوحّد شبه المطلق بين كيان الأمّة والشخص الذي اختارت أن ترى نفسها فيه، والذي يصبح، بنوع من التجرّد والتسامي، رمز الجماعة بالذات وطوطم العشيرة الكبرى.
الأب، صوت العقل وسلطة الرجولة الحازمة، هو حبل النجاة الوحيد لأمّة تمزّقها مصالح نخبها الخاصّة وعواطف جماهيرها.
السياسة فعل تربية
السياسة الشهابية، بأحد وجوهها، فرعٌ من علوم التربية، بما هي فعل لجم وسيطرة يتولّاه الأب بهدف تهذيب البلاد وإخراجها من فوضاها «البريّة». فيكتب نقّاش بعد عودة الرئيس عن استقالته سنة١٩٦٠ قويّاً بتجديد تفويضه:
ها هو إذن من جديد. لقد عاد المروِّض إلى قفص الضواري. وهو سيواصل عمله الصامت الذي يطغى عليه زئيرها. أمامه بعد أربعة أعوام لكي يجعل من هذه المجموعة العشائرية التي هي لبنان دولة، ولكي يجعل منها أولاً دولة إنسانيّة، دولة إجتماعيّة.
إن كان الترويض أسلوب التعامل مع الكبار المفترسين، فالأصغر منهم يواجهون بعدّة شغل مختلفة: وعرف له الناس أيضاً إدخاله أدب السلوك إلى مقام الذروة وتطهيره أروقة الحكم من غدوات الرعاع وروحاتهم، وأخيراً تلقينه الاحترام للّبنانييّن.
راديكاليّة الشهابيّة تكمن هنا، في مشروعها التربوي الذي يسعى إلى السيطرة على الفوضى والانقسام الناتجين عن مصالح الكبار وغرائز الصغار. بإمكاننا النظر إلى ذراعي الشهابيّة: اليساريّة (دولة الرعاية: الإنماء، بناء المؤسسات، دمج المناطق) واليمينيّة (القبضة الأمنيّة: تدخّلات المكتب الثاني في الانتخابات، تفريخ زعامات محليّة بوجه الأقطاب، التنصّت) كجزء من المشروع التربوي الراديكالي الذي يقوم به الأب-المنقذ من فوق، رغم إرادته، ورغم إرادة أولاده المتحاربين.
التكتيك: لفّ سجائر
تخفّف دولة المؤسسات والرعاية من غرائز الجماهير الطائفية من خلال إنشاء رابطة مواطنة تتخطّى الزعامات السياسيّة، الحلقات الوسيطة التي تربط المجتمع بالدولة وتستتبعها. أمّا القبضة الأمنية، فتعمل على قصقصة جوانح الكبار للحدّ من نفوذهم ومن سطوة مصالحهم الخاصّة. فما يبدو في سياسته تأرجحاً، كتب جورج نقّاش هو تأرجح في المادّة البشريّة التي يعالج والتي يسعى لتذليل مقاومتها. يستعير نقّاش صورة من بول فاليري ليعبّر عن تكتيك عمل الرئيس الإصلاحي البطيء والمتأرجح، الذي أدّى إلى نفاد صبر الشباب الذي يستعجل تطهير الميدان السياسي. انظر كيف تلف السيجارة باليد يقول فاليري، فإنّ إتقان صنعها يتمّ بسلسلة من إلغاء ما صنعت وإعادته من جديد.
جيش مزدوج: خارج السياسة، داخل الأمّة
تشترك صورتا نقّاش عن الرئيس شهاب، النبي-المنقذ-رجل العناية (الشخص) والأب-المعلّم-المروِّض (أسلوب العمل)، بأنهما تأتيان من خارج يتعالى على اللعبة السياسيّة الديمقراطيّة اليوميّة. والخارج في هذه الحالة يرتبط بشخصيّة الرئيس- النزيه، المتواضع، البسيط، الحازم، المترفّع عن المصلحة الشخصيّة- التي تمثّل نقيض الزعامات السياسيّة التقليديّة والرئيسَيْن اللذين سبقاه، كما يرتبط أيضاً بكونه عسكرياً. فالمؤسسة العسكرية هي التي أنقذت الجمهوريّة من أزمتيها الكبيرتين، في نهاية أوّل عهدين رئاسيين بعد الاستقلال (1952 و1958).
إن كان الانقسام والاحتراب الأهلي هما من صنع السياسيين المنتخبين ديمقراطيّاً ومناصريهم، فالمؤسسة العسكرية، التي لا صفة تمثيليّة لها، هي ضمانة الوحدة الوطنية. وكان الرئيس شهاب مدركاً لذلك. فنظّر للدور المزدوج للجيش، بما هو حامي الحدود كباقي جيوش العالم، وفي الحالة اللبنانية الاستثنائية المدرسة المثلى لوحدة بنيه. خطاب الرئيس شهاب في حفل تخريج الضبّاط في المدرسة الحربيّة في الفيّاضيّة، 16 أيلول 1960.
ملاكي الخلاص والخراب
لا تتجسّد نظرية «الخلاص يأتي من الخارج» في المؤسسة العسكرية وحسب، رغم أنّ رصيدها أقوى من غيرها لأنّ هامش مناورتها أوسع بصفتها تستطيع اللعب على مفارقة أنها خارج السياسة وقلب الأمّة في آن واحد. مجيء الرئيس المغدور رفيق الحريري إلى الحكم سنة 1992 صُوِّر كفعل إنقاذ وإعادة بناء، يحمله رجل أعمال مقيم خارج لبنان، من خارج العائلات السياسية التقليديّة وبعيد عن أمراء الحرب.
أمّا اليسار الجديد اللبناني، فنظر إلى المقاومة الفلسطينيّة، بُعَيد بداية عمليّاتها من جنوب لبنان بعد هزيمة حزيران 1967، كرافعة للعمل الثوري وصاعق يفجّر تناقضات النظام الطائفي من خارجه. استعاد الراحل محسن ابراهيم، أمين عام منظمة العمل الشيوعي، في أربعين الشهيد جورج حاوي (آب 2005) الفكرة نفسها، لكن من باب النقد الذاتي لليسار الذي أباح لبنان للمقاومة الفلسطينية، محمّلاً البلد الصغير فوق طاقته. في زمن الموت السريري الحالي، ينتظر النظام بأجنحته كافّة الإنعاش السياسي والاقتصادي من الخارج. وليست «شخطة القلم» المرتجاة من الخليج لإعادة البناء إلّا هذيان المحموم وسط نوباته.
أمّا المقابل الاقتصادي للجيش، بما هو خارج وداخل في آن واحد، والذي يُتّكَل عليه في عمليّة الإنقاذ المالي، فليس سوى المغترب. يطرد النظام مواطنيه المقيمين إلى الخارج، ليعتاش بعد ذلك على تحويلاتهم وزياراتهم الموسميّة. ذلّ يطرد مواطنين، وحنين يعيد دولاراتهم.
يقف الغريب، ملاك الخراب، مقابل الخارج، ملاك الخلاص المنقذ. الاتّكال على الخارج هو إقرار بأنّ تركيبة النظام السياسيّة غير قادرة على إنتاج أيّ حلول للانقسام الأهلي والانهيار الاقتصادي (أو حتّى إنتاج أيّ حالة ثوريّة). بمعنى آخر، الخارج هو الذي يساعد على تجاوز الانقسام والانهيار الداخليّين نحو وحدة ما مرتجاة. مهمّة الخارج هي جعل الكثرة المتقاتلة، والدولة المنهارة، جسماً واحداً.
الغريب عكس الخارج. هو الذي يهدّد الوحدة. يفترض قدومه أمّة لبنانيّة موحّدة تقوَّض من خارجها. يهدّد «عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وأسرنا اللبنانيّة». التقويض، الاستنزاف، التهديد، كلّها من اختصاص الغريب. قد يكون الغريب/ة «فلسطيني»، «فيليبينيّة»، «سوري»، «إثيوبيّة»، يواجَه بعنصريّة لبنانيّة عابرة للجماعات الطائفية المتقاتلة. شكّلت الحالة الخاصّة للمقاومة الفلسطينية في آن واحد خارجاً يساهم بتفجير تناقضات النظام الطائفي، بالنسبة لليسار اللبناني، وغريباً يهدّد وحدة البلاد وسيادتها بالنسبة للأحزاب القوميّة المسيحيّة. كما قد يكون الغريب أرمنياً لبنانياً، يشكَّك أحياناً في انتمائه الحقيقي إلى الأمّة بإرجاعه إلى أصوله. تتجلّى هذه العصبيّة اللبنانيّة أيضاً في معاملة أجهزة الدولة لغير اللبنانيين من «الغرباء»، وفي ابتزاز أجهزتها الأمنيّة لبعض مواطنيها المعارضين:
يروي الدكتور توفيق الهندي، المستشار السياسي السابق لقائد القوّات اللبنانيّة، أن المحققين العسكريين الذين استجوبوه إبّان اعتقاله في 7 آب 2001 بتهمة «الاتصال مع العدو الاسرائيلي»، قالوا له في أوّل جلسة إنّه ليس من «العرق» اللبناني، بإشارة إلى أصول عائلته الحلبيّة. أمّا الشهيد سمير قصير، فسحب الأمن العام جواز سفره بعيد عودته من السفر ضمن آليّات مراقبته والتضييق عليه. وبرّر المسؤول عن الأمر آنذاك، اللواء جميل السيّد، ذلك الإجراء قائلاً: «مشكلتنا معه في العام 2001 أننا تسلمنا جواز سفره عند دخوله إلى لبنان وأعطاه أمن عام المطار إيصالاً بالمراجعة والتدقيق في جذور الجواز باعتبار أن الصحافي قصير فلسطيني الأصل من والده المجنّس لبنانيّاً ومن والدة سورية الجنسيّة، وقد أعيد له الجواز بعد التدقيق. (غسان شربل، ذاكرة المخابرات، 125-126)
وقد يكون الغريب أيضاً موسيقى الهيفي ميتال، تأتي من الخارج فتخرب «شبابنا» و«شاباتنا» وتدفعهم إلى الانتحار. فيمنعها وزير الداخليّة في تسعينات القرن الماضي… وبعد ذلك بثلاثة عقود، يتنطّح وزير الثقافة لمهمّة الانقضاض على… «باربي» الغريبة.
أمّا في زمن الانهيار الكامل، فيتوّحد المنقسمون، المتقاتلون الموسميّون، على معاداة المثليين الذين ينخرون جسد الأمّة بقيمهم الغريبة عن «تقاليدنا»، فيما يبيح مرشد الجمهوريّة قتل أفراد مجتمع الميم-عين.
في غياب رابطة المواطنة، يصبح الجيش في الفكر والممارسة الشهابية مختبر الوحدة الوطنية البعيد عن فساد «أكلة الجبنة»، كما كان يسمّي شهاب السياسيين بازدراء. فشجّع الجنرال تشكيل سلك عسكري، ارستقراطي الطابع، ليضطلع بمهمة طليعيّة: تكوين النواة الأولى للأمّة. يروي باسم الجسر، الشهابي، في مذكراته عن لقائه الأوّل مع قائد الجيش سنة 1953، والذي قال له:
لا بدّ من قواعد لبناء هذا الجيش الوطني الذي قد يكون دوره في لبنان أساسياً في بناء الوطن وتدعيم الاستقلال والوحدة الوطنية. ومن هذه القواعد تخريج طاقم من الضباط الأكفاء ممن يمثلون كلّ الطوائف والمناطق والعائلات اللبنانية. الكفاية والجدارة واجتياز الامتحانات هي الأساس لدخول المدرسة الحربية وللتقدّم في الرتبة. لكننا نرحب بدخول أبناء الضباط إلى المدرسة الحربية تماشياً مع مبدأ استمرارية التقاليد العسكرية. من الآباء إلى الأبناء. كما نرحب أيضاً بـ«أبناء العائلات» اللبنانية المعروفة التي تشكل «عقد» البناء اللبناني في انتظار ولادة «المواطن» أو «الشعب» اللبناني، كما في الدول العريقة العهد بالاستقلال. باسم الجسر، «في ذكرى غيابه الثامنة والعشرين، فؤاد شهاب: إضاءات جديدة»، جريدة النهار، 25 نيسان 2001.
هذا الدور المزدوج للجيش الذي يضعه الجسر نظرياً، كما فعل شهاب نفسه، خارج اللعبة السياسيّة وفوقها، هو ما يتيح إمكانيّة الصراع على تمثيل الأمّة من خارج السياسة الديمقراطيّة. فيسمح بإعادة إنتاج نفس الأسطورة عن الأب المنقذ العسكري الآتي، في وقت واحد، من خارج فساد السياسيين، الممثّلين الشرعيّين للمجتمع المنقسم، ومن داخل الداخل بما أنه يستمدّ شرعيته من كونه جسد الوحدة الوطنية ومدرستها.

لحظة الحقيقة
أمد السيادة المعدود وزمن الإصلاح المديد
هل الجيش فعلياًَ فوق الانقسامات المجتمعيّة التي تمثّلها السياسة؟ هل نجح بتكوين وحدة وطنية غير خاضعة لانقسامات التكتّلات الطائفية للمجتمع كما تمنّى اللواء الرئيس؟ ما لم يقله الرئيس شهاب علناً عن موقفه خلال معارك 1958، أسرّ به إلى فؤاد بطرس. فلنستمع إليه:
أمّا السؤال الذي شغل بالي ثلاث سنوات، والجواب عليه يشغلني منذ ستة وأربعين عاماً، فكان: لماذا لم يُنزل اللواء فؤاد شهاب الجيش في العام 1958 ليضع حدّا للاقتتال الداخلي ويثبت هيبة الدولة ويوطّد الاستقرار والأمن؟ وقد طرحته على صاحب العلاقة سنة 1960 بعدما توثّقت علاقتي به. وكان الجواب ألماً مخزياً باح لي به الرئيس فؤاد شهاب كمن يبوح لصديق له عن مرض عضال أصيب به ابنه: «لو أنزلت الجيش، في ذلك الحين، لمواجهة الانقسام الطائفي، لكان في استطاعتي أن أضمن وحدته سبعة أيّام، أما في اليوم الثامن… فلا أعرف». فؤاد بطرس، المذكرّات، ص 48.
أثبتت الحروب الأهليّة والإقليمية اللاحقة حدس اللواء. واستعاد جوني عبده، رئيس الشعبة الثانية في عهد الياس سركيس، نفس الملاحظة قبل بضع سنوات محوّلاً إيّاها إلى قاعدة عامّة خلال المواجهات الأهلية. يشير شهاب في تبريره عدم التدخّل في العام 1958 إلى أن السيادة في لبنان ليست فقط جغرافيّة- بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانيّة، تجفيف البؤر الأمنية، القضاء على السلاح المتفلّت، إنشاء المؤسسات العامّة في المناطق النائية- بل هي زمنيّة أيضاً. انقسامات المجتمع التي تستوطن كلّ مؤسسات الدولة تجعلها في الأزمات الحادّة عرضة للانقسامات بعد أيّام معدودة فقط من الأزمات الأهليّة الحادّة.
بهذا المعنى، فإنّ سرعة وتيرة الأحداث السياسية والأزمات عدوّة للشهابيّة. فزمن المشروع الشهابي الذي سعى إلى مدّ جذور الدولة إلى قلب المجتمع، وإرساء السيطرة السياسية على حصون وخنادق المجتمع الأهلي الشهيرة التي يتحدث عنها غرامشي، وضاح شرارة، السلم الأهلي البارد: لبنان المجتمع والدولة 1964-1967، معهد الإنماء العربي (1980)، ص 28. عمل تربوي بطيء، متأرجح كلفّ السجائر. زمنه يعاكس سرعة إيقاعات الانقلابات العسكرية والتوتّرات الطائفية، والحروب الخاطفة (حزيران 1967) والعمليّات الفدائية، وحتّى مناوشات السياسة اليوميّة وانفعالات زعمائها. أبويّة «ناسك صربا»، الذي يعمل ببطء ومن فوق، مع فريق من الإداريين والأمنيين، في صومعته البعيدة عن الناس، تتعارض أيضاً مع ذكورية الزعيم وقبضاياته وحركة شدّ عصب الجماعات الأهلية وصيانة مشاعرها من الخدش.
عسكريتاريا أو دوام الإنقاذ وانحطاطه
رغم اختلاف السياقات التاريخية والدستورية بين عهود الشهابية وماضينا القريب، لم تنفكّ هذه المفارقة التأسيسيّة عن المنقذ الآتي من المؤسسة العسكرية، كخارج أكثر داخلية/ داخل أكثر خارجية، عن إعادة إنتاج نفسها من قبل أطياف سياسيّة مختلفة. خلال انتفاضة 17 تشرين، كان يظهر علينا كلّ فترة على الهواء التلفزيوني المفتوح «مواطن عادي» يدعو قائد الجيش إلى تنظيف البلد وتطهيره من السياسيين الفاسدين وضبّهم في السجون.
كما أن الجنرال ميشال عون لم يتوقّف يوماً عن ترداد أنّه خارج المنظومة السياسية، بعيدٌ عن فسادها وإقطاعها، وأنه لا يعرف الطائفية بدليل خدمة المسيحي والمسلم تحت أمرته العسكرية. ليست العبارة-النكتة «ما خلّونا» لنخب التيّار العون-باسيلي إلّا ترجمة لإصرارهم على أنّهم خارج نظيف، حتّم عليهم حظّهم السيّئ الاصطدام الدائم بداخل فاسد. لكنّ الفروقات بين ممارسات عون المنقذ والمورِّث وشهاب كثيرة. أوّلها عدم دعوته المجلس النيابي للانعقاد لانتخاب رئيس بعد تعيينه رئيس حكومة انتقالية من قبل الرئيس الجميّل (1988) الذي بنى قراره على السابقة الشهابية (تعيين فؤاد شهاب من قبل الرئيس بشارة الخوري رئيس حكومة انتقالية سنة 1952). غسان تويني، مقدّمة ”عسكر على مين؟ لبنان الجمهوريّة المفقودة“ لسمير قصير، دار النهار (2004)، ص 9.
أمّا اللواء جميل السيّد، منظّر اللحوديّة الذي لم ينفِ أنه كاتب خطاب قسمها، فيقول:
عندما جاء العماد لحود قائداً للجيش، لم يطرح مقولة أن الجيش هو الحلّ. طرحنا أنّ الجيش هو النموذج لا الحلّ. الجيش نموذج لما يمكن أن تبنى عليه المؤسسات من خارج منطق التقاسم والتأثير الطائفي والسياسي. هذا ما جعل العماد لحود يستفيد من هذه السمعة ويجعله مرشحاً قوياً لرئاسة الجمهورية لأنه في ظل الطائف- الذي كله سياسة تقاسم- استطاع قائد للجيش بمعاونة أركانه برعاية سورية مباشرة لخطّة توحيد الجيش، أن يجعله مؤسّسة فعّالة وبعيدة عن التقاسم ولجميع الناس، مما حوّل الجيش نموذجاً ومثالاً لما يمكن أن تكون عليه بقية مؤسسات الدولة. غسان شربل، ذاكرة الاستخبارات، رياض الريّس للنشر والكتب (2007) ص 67-68.
الرئيس لحوّد الذي جمع حوله طاقم حكم مدني من الحقبة الشهابية كالرئيس سليم الحصّ والوزيرين جورج قرم وشارل رزق، هو أيضاً سليل الشهابيّة مرّتين. مرّة بصفته متحدّراً من سلك العائلات العسكرية التي سعى شهاب إلى بنائه، ومرّة ثانية لأنه ابن اللواء جميل لحود الشهابي الهوى. أمّا شعاراته السياسية، فاستعانت هي الأخرى بثيمات شهابية مبسّطة:
لا أطلب شيئاً لنفسي (الترفّع عن المصالح الخاصّة)
إيد وحدها ما بتزقف (الوحدة الوطنية المنشودة دوماً والمفقودة أبداً)
لكنّ الاستعانة بالشعارات الشهابية الإنقاذية وبعض نخبها المدنيّة لم تقدر على حجب واقع فقدان السيادة، ركن الشهابية الأساسي، في فترة الإدارة السياسية والاحتلال العسكري الأسدي للجمهورية. وعلى الأرجح، هذه الحالة هي التي دفعت بغسّان تويني، بعدما كانت النهار قد عارضت الشهابيّة الأصيلة، إلى دحض أيّ صلة بين عهدَيْ شهاب ولحوّد. فكتب في تقديمه لـ«عسكر على مين؟ لبنان الجمهورية المفقودة»، كتاب الشهيد سمير قصير، الذي صدر في صيف 2004 المحموم، قبيل التمديد للحود:
فوراً، حتى لا تلتبس المقارنات، لا بدّ من العودة إلى التاريخ لنقول إنّ الفرق بين «عسكرة» فؤاد شهاب، وعهده، وبين العهد الذي تناولته مقالات الكتاب الحالي هو أن الشهابية- التي لم تشتد وطأة «مخابراتيّها» إلا في الستينات، أي في سنتها الثالثة- حملت إلى الحكم نظرة إصلاحية تقدمية، بينما العهد الحاضر جاء إلى الحكم باسم حياده العسكري وصفاته الانضباطية المترفّعة التي تجلّت خلال الحرب المسماة «أهلية». ونكاد نفصح، ولا نزايد على سمير قصير، فنقول إنّ لعلّ «فراغ» عهد لحود من أي مشروع حكم متكامل يذهب إلى الجذور الاجتماعية والمدنية هو الأمر الذي جعل هذا الحكم «يتجوهر» بالمخابراتية منذ السنة الأولى، خصوصاً لأنه وجد مخابراتية مستوردة «بفضل الحرب» تحتل الساحة، استدرجت هذه عسكر العهد إلى السباق معها حيناً والتناغم معها، بل عزف أنغامها أحياناً. غسان تويني، المقدمة، ص 13.
لكن لماذا لم ينجح أي من المنقذين بتحقيق معجزة الإنقاذ الذي ندروا أنفسهم لها، بعد خمس وستّين سنة من مجيء المنقذ الأوّل إلى الرئاسة؟ لا جدّة في الأجوبة الدفاعيّة، من نوع «ما خلّونا»، التي تنزّه النفس وتضع كلّ اللوم على الآخر. ولا طائل من التحسّر على الإنقاذ المجهض، «لو عاش»، التي تترحّم على ما كان يمكن إنجازه لو لم يُغتَل، (بشير الجميّل، رفيق الحريري)، أو «لو رجع عالرئاسة» بحالة الرئيس شهاب سنة 1970. الجواب الفعلي هو صعوبة أي جزء ادّعاء تمثيل وقيادة الكلّ، بناء هيمنة، في مجتمع منقسم جماعات أهلية.
لبنانان… لا لبنان واحد
استئناف الإنقاذ هو زوج (دوبل) بنيتيّ النظام: الانقسام/الحرب الأهلية والفساد/الانهيار. الإنقاذ من الانقسام والفساد، نتيجة افتراض أمّة موجودة (يا شعب لبنان العظيم) وأمّة دائماً قيد الإنشاء تسعى إلى إرساء وحدتها الوطنية وتعزيزها. فلبنان دائماً لبنانان، عكس الشعار الذي رفعه الرئيس صائب سلام- لبنان واحد… لا لبنانان- إبّان تسلّمه رئاسة الحكومة بعيد انتخابات صيف 1960 النيابية.
رفع الرئيس شهاب عدد المقاعد النيابيّة في انتخابات 1960 من ستة وستين مقعداً إلى تسعة وتسعين لضمان تمثيل سياسي واسع داخل المؤسسة التشريعية بعد اقتتال 1958. فعلّق الشاعر والمغنّي البيروتي عمر الزعنّي قائلاً:
النواب كانوا عشرين
عملوهم خمسة وخمسين
زادوهم سبعة وسبعين ورجعو ام أربعة وأربعين
وصلو للستة وستين
زادوهم تسعة وتسعين
ودربكهم للميّة
الحالة هيه هيه.
من مقال لمحمود الزيباوي، «لبنان واحد…لا لبنانان»، المدن، 20 أيار 2022
ليس مثنّىً لأنّه مكوّن من جناحيه المسيحي والمسلم، بل لأنّ نظامه مبنيّ على فكرة الأمّة الواحدة المنبثقة عن جماعات طائفيّة متعدّدة ومتخاصمة، كانت تسمّى «عائلات روحيّة» في الزمن الشهابي وأصبحت الآن تستتر بكنية «المكوّنات». ودوام افتراض الوحدة اللبنانيّة وسط الانقسام الطائفي، يجعل من كلّ شيء مزدوجاً. فنحن في الوقت نفسه: أمّة مكوّنة وأمّة تسعى دائماً إلى إرساء وحدتها الوطنية. جمهوريّة مؤسسة وبحاجة إلى إعادة تأسيس دائمة. دولة موجودة وبحاجة دائمة إلى استئناف بنائها. جمهورية لها دستورها وبحاجة دائمة إلى الشروع بتطبيق الدستور، أو بتعديله قبل البدء في تطبيقه. وهذا الازدواج هو الذي يجعل المنقذين على أنواعهم- الشهابيّين، وميشال عون ورفيق الحريري- يبدأون حياتهم السياسيّة بمشاريع تدّعي التحدّث باسم الأمّة اللبنانيّة وينهونها كممثّلين جزئيّين لطوائفهم.
دروس التجربة الشهابيّة
الفاعل والزمن
تتلخّص معضلتا الشهابية الأساسيّتان، والمترابطتان، بسؤال الفاعل السياسي للإصلاح: من يقوم ببناء الوحدة الوطنية، والقيام ببناء مجتمع جديد، عندما يكون ممثّلو الشعب هم ممثّلي انقساماته الطائفية التي هي بدورها ممثَّلة داخل المؤسسات العامّة؟ أو من هي القوّة السياسيّة التي ستقوم بإصلاح من لا يريدون إصلاح أنفسهم؟
أمّا السؤال الثاني، فمتعلّق بكيفيّة تأمين الزمن الضروري للقيام بعمليّة الإصلاح. فمن يأتي بالزمن المؤاتي لفعل الإنشاء وعمليّة التراكم وانتقال الخبرات في بلاد تعيش على إيقاع النكبات والانقلابات والحروب المجاورة والصراعات الناتجة عن تضارب مصالح الكبار وانقسامات التكتلّات الطائفية؟
هل كانت طفرة إنجازات شهاب المؤسساتية في فترة قصيرة نسبيّاً، والتي استفاد منها الكثيرون لعقود، ناتجة عن إحساس بأنه يسابق الزمن داخلياً وخارجياً؟ هل كان بإمكانه فعل كلّ ذلك لولا الهدنة الخارجية-الداخلية المتأتية عن علاقته بالناصرية؟ وهو نوع من العلاقات تبيّن لاحقاً، لعدّة عهود رئاسيّة، أنه مستحيل مع حافظ الأسد ووريث جمهوريته.
آباء مُنقذون لأولاد دائمي القصور
اعتمدت الشهابيّة الإصلاحيّة على صلاحيّات دستوريّة للرئيس بإصدار مراسيم اشتراعية، وعلى جهاز تنفيذي قوامه تكنوقراط وعسكر. أبويّتها مرتبطة بآليّة عملها من فوق، ومن خارج النزاع السياسي العلني (العمل بصمت). كما تظهر بوضوح في فكرة «عدم نضوج» اللبنانيين، شعباً وزعماء. ففي مراجعته للفترة الشهابية، يقارن فؤاد بطرس بين خريطة بناء الدولة الحديثة الشهابية وواقع الأمر، مستذكراً استمرار التباين في المواقف بين اللبنانيين بعد حرب 1958 ووفاقهم الوطني الذي بقي سطحياً:
حاول الرئيس شهاب دائماً أن يراعي هذا الوضع بانتظار أن تترسّخ روح المواطنية عند اللبنانيين ويتعزز الشعور بالانتماء إلى الوطن. كانت هناك رؤية ورغبة عند الحكم في كل ذلك، لكن الشعب لم يكن ناضجاً لهذا الأمر، فيما الطبقة السياسية، بوجه عام، التي كان يسميها «بأكلة الجبنة» لم تكن ناضجة وطنياً ولم تكن مستعدّة للتضحية بالمصالح الشخصية والحزبية الضيّقة في سبيل الخير العام ومستقبل البلاد. فؤاد بطرس، المذكرّات، ص 104.
إن اتفقنا مع خلاصة بطرس عن عدم نضج الشعب وزعمائه، أم لم نتّفق، نحن أمام معضلة عوّيصة. فالأبويّة في السياسة التي تنظر إلى الناس كقاصرين «يجب فعل مصلحتهم رغماً عنهم»- والقول منسوب للرئيس شهاب عن المسيحيين- قد تنتهي بنسختها المبتذلة عند درر الخطابة الميثاقية اللبنانيّة… «شو هالشعب الطزّ هيدا» و«إذا ما في عندن أوادم بهالدولة يروحوا يهاجروا» (ميشال عون).
من بناة المجتمع الجديد إلى مجرّد فريق وسط آخرين
نقد السياسات الأبوية الفوقية- التكنوقراط والعسكر- لا ينفي أن المعضلة لا تكمن في ارتباط الفعل السياسي بالبنى الطائفية والمناطقية والعائلية (وزعمائها بالطبع) التي تعيق ولادة المواطن المجرّد. هي كذلك. لكنه، أي النقد، يشير إلى أنّ موقعها الفوقي، غير المستند إلى حركة شعبية «من تحت» يجعلها أكثر سلطويّة، حتّى ولو كانت تعمل باسم الصالح العام وضدّ المصالح الخاصّة لكبار الزعماء. غياب الحركة الشعبيّة التي تسعى إلى كسب الناس إلى مشروعها، وإرساء هيمنة ما، يسهّل النظر إلى أجهزة الدولة الأمنيّة والإداريّة كفريق سياسي خاص يتستّر بشرعية الدولة وعموميتها، ليعتدي على فرقاء آخرين.
النهاية التي آلت إليها الشهابية التي انتقلت من مرحلة مشروع إعادة اللحمة الوطنية إلى الإصلاح ثم النهضة المجتمعية، ترجح تلك الخلاصة. فهي في نهاية المطاف تحوّلت من مشروع بناء مجتمع جديد يعيد صياغة قواعد اللعبة السياسية إلى مجرّد لاعب بين لاعبين آخرين:
والجليّ أن إدارة شهاب رمت من وراء عدد من إجراءاتها إلى عزل أجهزة الموظفين عن نفوذ الطاقم السياسي، ولو إلى حد، واستخدام استقلال هذه الأجهزة في بناء دولة تستطيع الاضطلاع في إدارة المجتمع كله، فلا تحول رواسبه وانتماءاته دونها ودون الحياد والفاعلية المطلوبين. لكنها لم تفلح سوى في إضافة تكتّل جديد أو فئة جديدة إلى مجموع التكتلات والفئات القائمة. ولم تضف الإجراءات البوليسية التي اتخذت في أواخر ولاية شهاب نفسه… لم تضف إلى التكتّل إلّا صفة العنف والقمع. وضاح شرارة، السلم الأهلي البارد، ص 34.
استحالة التغيير من فوق السياسة ومن خارجها
تحمل تجربة الشهابية المهزومة دروساً كثيرة. فتذكّر دعاة التغيير النخبوي (خبير، تكنوقراطي، مجاهد ضدّ الفساد، جنرال، أستاذ، نقيب، نظيف الكفّ، حكيم…) بحدود التغيير من فوق ومن خارج. كما أنّها تذكّر بعض اليسار الذي يتبنّى نظرة الرئيس شهاب الجدلية حول الوحدة الوطنية والمسألة الاجتماعية- أيها اللبنانيون، إن بناء المجتمع لا يقوم إلا ببناء الوحدة الوطنية. وبناء الوحدة الوطنية لا يتم إلا ببناء المجتمع رسالة إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى الاستقلال، في يوم 21 تشرين الثاني 1961. - إنّ فعل البناء هذا ليس فقط محدود الفعالية عندما يأتي من فوق، بل قد يساهم بتقوية عصبية أحزاب الجماعات الأهلية من خلال إحساسها بأنها في موقع دفاعي عن امتيازاتها.
فلو نظرنا إلى الطائفية من منظار مادّي- امتيازات وعلاقات زبائنية وشبكة أمان اجتماعية خاصّة- واتفقنا أن بناء الدولة العادلة يساهم بتجفيف أنهر الطائفية الهادرة، يبقى السؤال الأساسي من هو الفاعل السياسي القادر على القيام بهذه المهمّة؟ عمل الرئيس الشهاب في ظروف سياسية خارجية وداخلية مؤاتية، وفي زمن كانت بنية الاجتماع السياسي اللبناني أكثر ليناً، ومع ذلك...
ما بعد: الحرب الأهلية، دولة الرعاية وأسطورة التحديث
أمّا مرحلة ما بعد الحرب الأهليّة، فقلّصت من صلاحيّات الرئاسة وشهدت تبلور (crystallization) الطوائف- العبارة للمؤرخ أحمد بيضون- وأضافت إلى المحاصصة اللبنانية التقليدية أعرافاً جديدة واغتيالات سياسية دورية مصحوبة بغزوات وتخوين دائم، جعلت كلّها من حزب الله جناح النظام المسيطر. كما ناقضت فترة ما بعد الحرب اهتمام الشهابية بالمصلحة العامّة، فأضافت إلى مصالح الزعماء الخاصّة، مصالح رأس المال التوّاق إلى الخصخصة. فالمؤسسات العامّة التي لم تخصخص، كالجامعة اللبنانية، تمّ الاستيلاء السياسي عليها وتفريخ جامعات خاصّة مرخصّة حواليها، عددها أكثر من تلك الموجودة في ألمانيا.
يشيع في لبنان منذ التسعينات فتح الجامعات الخاصة فروعاً لها هنا وهناك. وفي الجامعة اللبنانية، يشيع فتح الفروع والشُعب في المناطق، حتى أصبح عددها اليوم 68 فرعاً وشعبة. وفي ذلك فكرة «خدمة الجمهور» المعاكسة لمعنى الجامعة. تبحث الجامعات الخاصة التي تفتح فروعاً عن زبائن (بالمعنى الاقتصادي للكلمة)، وتبحث الجامعة اللبنانية عن زبائن (بالمعنى السياسي للكلمة).
في القطاع الخاص، تلحق الجامعة زبائنها المحتملين إلى قراهم وبلداتهم. وتوفّر لهم تعليماً «من حواضر البيت» و«بأسعار متهاودة». أما وزارة التربية والتعليم العالي، فتمعن في منح التراخيص، وفي تجنّب الرقابة إكراماً لعيون طالبي الخدمة من النافذين. طالبو الخدمة من النافذين إمّا يستعملون الجامعة لأغراض تجارية، وإمّا يستعملونها من أجل خدمة الجماعة. وفي جامعات الجماعات، يتمّ «تسهيل» تعليم الطلاب من أجل تأمين الحراك الاجتماعي لهم، إذا ما توفّر، من «داخل الطائفة»، أو تأمين إعادة إنتاج نخب الطائفة.
مقتطف من «الاختلاط الاجتماعي في التعليم العالي»، د.عدنان الأمين، 27 أيّار 2019.
كلّ ذلك يبرهن شبه استحالة مشروع الرئيس شهاب الذي وصفه جورج نقّاش بـ«إقامة دولة حديثة فوق الهيكل الطائفي الهرم». فبعد ستّة عقود، تبيّن أنّ مفهوم الدولة الحديثة هو الذي انقرض، بينما الطائفية نضرة، دائمة التجدّد، لا علاقة لها بالهرم، لا من قريب ولا من بعيد. ومن يخرج عليها، كما حصل في 17 تشرين، ينتهي بهم الأمر إمّا خارج الحدود، أو داخل فقاعات صغيرة هامشيّة تعيد أحياناً إنتاج عصبيّات شلليّة وعلاقات حادّة تذكّر بالمتن الطائفي الذي هجروه.
ذوى اليوم كلّ ما بإمكانه تشكيل مساحة عامّة للمواطنين خارج سياجيّ الجماعة الطائفيّة والملكيّة الخاصّة. فلبنان، بالرغم من إعادة إنتاج الطائفية السياسية لنفسها منذ القرن التاسع عشر، ليس جزيرة معزولة عن العالم. فمن الممكن مقارنة الشهابية بسياسات دول الرعاية بعد الحرب العالمية الثانية، وبزمن الجنرال ديغول الذي كان اللواء الرئيس معجباً به. ويمكن مقارنة رفيق الحريري بعصر رونالد ريغان ومارغريت تاتشر النيوليبرالي، وأخيراً وليس آخراً، جبران باسيل بفكتور أوربان وجاير بولسونارو ودونالد ترامب. ربّما تحمل هذه المقارنات القليل من التعسّف، لكنّها مفيدة للدلالة على مرونة الطائفيّة، الثابت-المتحوّل، التي تتغيّر وتتأقلم مع تغيّرات اقتصاديّة وسياسيّة جذريّة، من مرحلة بداية الرأسمالية في بلدان الأطراف إلى شعبويّة القوميّات العنصريّة في عصر الارتداد على عولمة التسعينات المزهوّة بنفسها.
وجها المواطنة: تحرّرٌ وإقصاء
لم تكن المواطنة يوماً قيمة تحرّرية وحسب. فهي تحمل وجهاً آخر إقصائياً، يُسقط حقوقاً مدنيّة وسياسيّة كثيرة عن كلّ من لا يشترك فيها. يبرز وجهها الإقصائي أكثر فأكثر اليوم في عالم تشكّل مسألة اللاجئين إحدى سماته المشتركة. فبعدما خلخلت العولمة الأسس الاقتصاديّة للدولة- الأمّة من خلال تدويل الإنتاج، تكشف مسألة اللاجئين قصور المواطنة- كرابطة سياسيّة- عن الإحاطة بالتغيّرات الاجتماعيّة العميقة، وتظهر بوضوح العنف الذي يضمره مفهوم السيادة الوطنية.
مآلات الجمهوريّة اللبنانيّة المحتضرة، التي تزامن استقلالها تقريباً مع النكبة الفلسطينيّة، مثال على تداخل «بؤسنا الما بعد استعماري» (بارثا شاترجي) مع دوام المسألة الاستعمارية في فلسطين. فهي، منذ بداياتها، جمهوريّة تطمح لقيام رابطة المواطنة المجرّدة بين مواطنيها المنقسمين على بعضهم بعضاً والمتحاربين المتحالفين مع أطراف خارجيّة، ودولة تقصي ثلاثة أجيال من الفلسطينيّين المولودين في لبنان عن أبسط الحقوق. الغريب واللاجئ يعرفان جيّداً القبضة الأمنيّة للدولة، ولا يسألان مع اللبنانيين «وينيه الدولة؟».
كذلك لم تُثمِر محاولاتُ بعض اللبنانيّين تغيير النظام وتجاوز إطاره الطائفي بالتحالف مع المقاومة الفلسطينيّة إلّا المزيد من التمزّق والعنف الأهلي والارتكاز إلى العنف ما بين الطوائف وداخلها. فعالمنا المركّب، المنقسم والبعيد عن أي تجانس، يحوي جماعات أهليّة تبيّن أن محاولات تجاوزها المختلفة من فوقها ومن خارجها (فؤاد شهاب، اليسار اللبناني بالتحالف مع المقاومة الفلسطينيّة) تنمّي عصبيّاتها وتقوقعها على نفسها. كلّ ذلك بينما يزداد ارتباط الولاءات الما دون وطنيّة بمشاريع ما بعد وطنيّة (حزب الله والنظام الإيراني). وتتداخل كلّ هذه الولاءات الأهليّة والارتباطات الخارجيّة مع عصبيّة لبنانيّة، تجاورها ولا تتجاوزها، تتبلور بوجه اللاجئ وتجعل من الغريب كبش محرقة.
طيفٌ ملحّ
طوطم النظام الغائب الحاضر
طوّب النظام الرئيس شهاب، بعد رحيله، رمز الجمهوريّة المقدّس: أب الجمهورية وباني الدولة. تلازمه مفارقة اللبناني الأوّل والوحيد حتى الآن. فكلّ استعادة له تتأرجح بين حدّين متناقضين: فرادة شخصيّته وإنجازاته واستئناف تجربته. فهو في آن واحد الأب المؤسس الذي لا يتكرّر ومصدر شرعيّة إعادة التأسيس المستمرّة. فباستثناء الوطنيين الأحرار المنقرضين والسوريين القوميين الاجتماعيين المنقسمين على انقساماتهم، من الصعب العثور على من لا يريد استئناف مسيرة الرئيس شهاب. يكفي أن نذكر مثلَيْن غير عسكريّين من أواخر القرن الماضي:
قال الرئيس رفيق الحريري للواء الركن أحمد الحاج، الرئيس السابق لمؤسسة فؤاد شهاب:
اسمع يا أحمد، إن ما ذكرته في خطابي جاء عن إيماني الراسخ بالخط الوطني السليم الذي رسمه الرئيس الكبير فؤاد شهاب لوطنه لبنانياً وعربياً ودولياً وكلّ ما أرجوه أن أتمكّن من إكمال مسيرته الوطنية التي اختطّها للبنان (1994). السفير اللواء الركن أحمد الحاج، مقدّمة كتاب فؤاد شهاب: باني دولة الاستقلال - شهادات، مؤسسة فؤاد شهاب (2005).
أمّا الرئيس الحصّ الذي خلف الحريري، فتوجّه إلى الرئيس الغائب الحاضر قائلاً:
إننا عازمون على المضي في مسيرة الدولة الدولة، دولة المؤسسات التي حلمت بها ذات يوم، علماً أن بناء دولة القانون والمؤسسات هو الهدف الذي يسعى العهد الحالي، عهد الرئيس العماد اميل لحوّد، جاهداً إلى تحقيقه (1999). كلمة ممثل رئيس الجمهورية، الرئيس سليم الحصّ، في احتفال إزاحة الستارة عن تمثال الرئيس فؤاد شهاب، جونيه، الأحد 7 تشرين الثاني 1999، في كتاب فؤاد شهاب- شهادات.
يُجمِع الكلّ على استئناف مسيرة الرئيس شهاب، مستمدّين شرعيّة حكمهم منه، لأنه في منطق النظام مجسّد إنقاذ الوحدة الوطنية وإصلاح الدولة. هو الأب، الذي كما في رواية فرويد، قدّسه كلّ أبنائه وجعلوا منه رمزاً لهم، بعدما تواطأوا على قتله. فطالما بقي نظام الوحدة الوطنية التي تنهار موسمياً ليعيد المنقذ ترميمها وإصلاح ما تبقّى، سيبقى الرئيس شهاب أب الدولة، لا بل أب المنقِذين جميعاً.
حنينان اثنان… لا حنين واحد
كيف يُبعَد شبح الحنين من خارج النظام إلى فؤاد شهاب؟ فها نحن بعد ستة عقود على تأسيسه للمصرف المركزي (1963)، نشهد الخروج السريالي للمطلوب بمذكرات إنتربول رياض سلامة من المصرف الذي أداره لثلاثة عقود، محاطاً بأمنه الخاص، مزفوفاً على إيقاع الطبول من موظّفيه المتدافعين لأخذ صور تذكاريّة معه؟ كيف لا؟ ونحن لا نشهد سوى تدمير المؤسسات العامّة والاستيلاء عليها. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنشئ أيضاً في السنة الأخيرة من ولاية شهاب (1963)، وشكّل لأكثر من جيل شبكة أمان خارج سياجي الجماعة الطائفية والملكيّة الخاصّة. أمّا الآن، فلا مال في المصرف، ولا ورق في دوائر الدولة. استُبدلت الودائع بتحويلات المهاجرين، وتعويض نهاية الخدمة بكرتونة إعاشة.
قد تكون صوامع أهراءات القمح في مرفأ بيروت، التي شيّدت في أواخر عهد الرئيس شارل حلو، الشاهد البصري الأبرز على أعمال الإنشاء الشهابية لمصلحة الخير العام. من الصعب عدم النظر إلى تلك الأهراءات وإلى تلغيمها بالنيترات، وتفجيرها، وانهياراتها البطيئة، ورفض تدعيمها، كاستعارات متتالية لما آلت إليه المؤسسات العامّة.
في حالة الاحتضار الطويلة هذه، ليس غريباً أن يظهر حنين لما تمثّله الشهابية من إعلاء للمصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة التي قضت على إمكانية الحياة وإعادة إنتاجها. أضف إلى ذلك، أننا نشهد منذ بضع سنوات انتشاراً أوسع للدعوات الانفصاليّة وازدياداً للاحتقان الطائفي وحدّته، ممّا يدلّ على جهوزيّة قاعديّة لجولات اقتتال أهلي جديدة، بعد أكثر من ثلاثة عقود على إعادة الإعمار وعقدين تقريباً من التخوين والاغتيالات السياسيّة المتواصلين نسف حزب الله خلالهما أي إمكانية لقيام سياسات الوحدة الوطنية التقليدية.
ولأننا في بلاد الازدواج الدائم، يأتي الحنين أيضاً مثنّىً. فهناك الحنين الخرافي الذي ينظر إلى الماضي كعصر ذهبي. شعاره تحنيط الماضي لعبادته. وإذا ابتعد عن التحنيط الكامل، تراه يفتّش عن شهاب يومنا، ممثّل الماضي في الحاضر. المنقذ الذي يستأنف عملية التأسيس الأبدية، ليعيد اللحمة الوطنية ويمضي في مسيرة الإصلاح الشهابي. حنين لا يأبه لأي من المتغيرات التاريخية لأنه مبني على تكرار بنيتيّ استعادة الوحدة الوطنية (الانقسام/الوحدة) واستئناف بناء الدولة (الفساد/الإصلاح). فلا يعير أيّ انتباه لوقائع جوهرية مثل أننا لسنا في زمن دولة الرعاية، ولا في زمن عبد الناصر وديغول، ولا في زمن الزعامات التقليدية والأحزاب العقائدية الفتيّة.
بالرغم من كلّ ذلك، هناك حنين من نوع آخر، خافت الصوت، بخلاف شعارات الأوّل البرّاقة، لكنّة موجود.
حنين نقدي، يسترجع الماضي وعينه على الكارثة في الحاضر. أستعير التمييز ما بين الحنين الخرافي والحنين النقدي من المؤرخة الأميركيّة پيني فون اشين.
حنين يستعيد ما أنشأته الشهابية لا لتقديسها واستنساخها، إنما لإلقاء ضوء كاشف على انهيار بلا قعر وحاضر بلا أفق.
رسوم: جاد أبو زكي