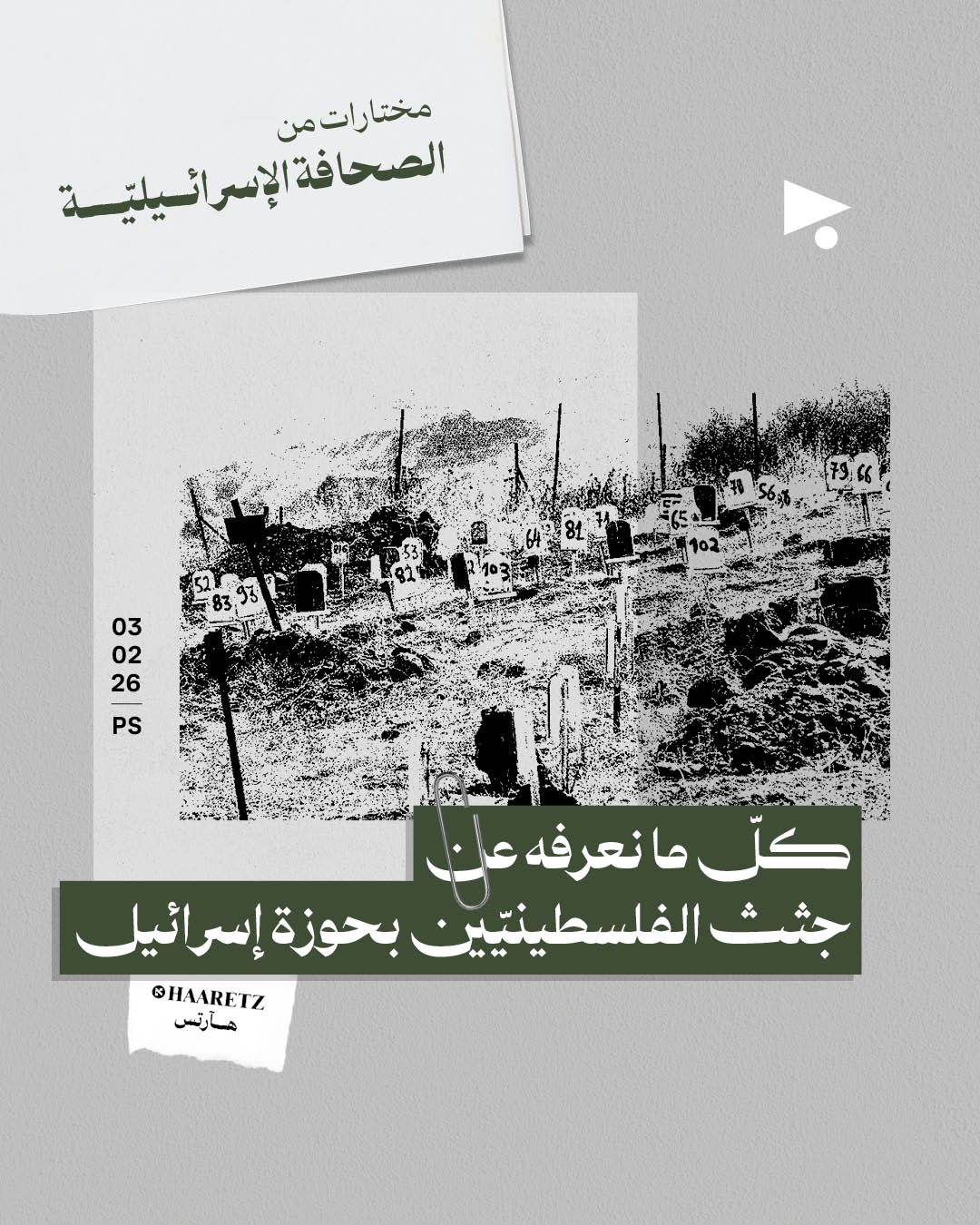نصرالله الثابت في لبنانه المتحوّل
لكل من دخل السياسة خلال العقدين الأخيرين من الزمن، كانت صورة حسن نصرالله من ثوابت الحياة السياسية، أو الثابت الوحيد في ساحة سياسية شهدت تحوّلات عنيفة وانهياراً بنيوياً وحروباً متكررة. رغم كلّ هذه التحوّلات التي صنع نصرالله العديد منها، بقيت صورته ثابتة، تُبثّ علينا دوريًا بخطاباته المدروسة التي كانت تضبط إيقاع الحياة في البلاد. في هذا اللبنان الذي صنعه «سيّد المقاومة»، كان نصرالله أقرب رمز للأبدية في بلد عاند الأبدية، رغم شهدائه الكثيرين وطوائفه المشبّعة بالتاريخ. لبنان الذي يودّع نصرالله اليوم هو لبنان صنعه نصرالله، على الأقلّ منذ عقدين من الزمن.
لكن لمن عايش صعود حزب الله، من مجموعة مقاتلين على هامش النسيج اللبناني وحتى الشيعي، إلى أول إطلالات نصرالله وتكريسه رمزًا للمقاومة، لبنانيًا وعربيًا، وصولًا إلى سيطرته على البلاد، تبدو الصورة مختلفة بعض الشيء، وكأنّ ثبات هذه الصورة ليس إلّا وهماً بصرياً ناتجاً عن مرحلة قصيرة في تاريخ البلاد الدموي وتاريخ حروبه المتكرّرة. نصرالله ليس إلّا صنيعة هذا البلد وتاريخه، بلد يصنع الأيقونات قبل أن يغتالها.
ما من تناقض بين هاتين الصورتين. أو إذا كان هناك تناقض، فهو ناتج عن رغبة البعض بتبسيط التاريخ، بين رغبة لأسطرته وأخرى لشيطنته. وربّما الواقع لا يقع بينهما في رغبة تصالحية، بل بجمعهما غير المكتمل، وقبول هذه الصورتين كجزأَيْن مكوِّنَيْن لواقعنا. ما من تصالح ممكن هنا، بل مجرّد قبول بهذا الانفصام الذي شكّلنا وما زال يشكّل وعينا السياسي.
الأيقونة
لا داعي لتكرار مسيرة حسن نصرالله التي باتت معروفة عند الجميع، من البداية في حي الكرنتينا في الستينات إلى انضمامه إلى «حركة المحرومين» مع اندلاع الحرب الأهلية، مرورًا بمشاركته في تأسيس حزب الله بعد عودته من العراق، وصولًا إلى ترؤّسه هذا الحزب بعد اغتيال عباس الموسوي في عام 1992. بعد هذا التاريخ، تواريخ الحروب مع إسرائيل، 1996 وعناقيد الغضب، سنة من بعدها استشهاد ابنه هادي، قبل انتصار التحرير في عام 2000. لكنّ الأيقونة لم تكن قد اكتملت بعد، وسوف تحتاج إلى خطاب «أنظر إليها تحترق» و«النصر الإلهي» في حرب تموز لكي تكتمل. من بعد هذه اللحظة، خرج نصرالله من عالم السياسة ليدخل عالم الأيقونات، رمزاً لمقاومة إسرائيل والانتصار عليها، بعد تاريخ عربي طويل من الهزائم.
ربّما كان حسن نصرالله من آخر جيل من السياسيين اللبنانيين الذين باتت حياتهم ممزوجة بأحداث البلد إلى حدّ الذوبان. وفي هذا الذوبان، قدّم للعديد ممّن عايشوا مسيرته شعوراً، إن لم يكن ثقةً، بأنّ الهزيمة ليست قدرًا، وأن الحرب مع إسرائيل ليست مجرّد انهيارات وهزائم، بل أيضًا تحرير وردع. بعد نصرالله، ولّى زمن الهزائم، وصعد جيل جديد بات يرى بإسرائيل خصمًا تربطنا به علاقة ردع متوازنة… «تل أبيب مقابل بيروت»، جيل اعتبر أن حرب تموز هي المعيار، وليس هزائم 1982 أو 1967. وإلى جانب الانتصار على العدو، قدّم نصرالله للبنان سياسيًا من طراز آخر. لم يكن حزب الله أكبر من الدولة فحسب، بل إنّ نصرالله كان أيضًا أكبر من لبنان المعتاد على شخصيات أكثر تواضعًا، يخاطب العالم من وراء شاشاته. والعالم كان يسمع.
وكما مع أبطال التراجيديا اليونانية، يأتي الانهيار على يد الغطرسة، هذه الثقة الزائدة بالنفس التي تدفع البطل إلى الوقوع بالفخ. اعتقد نصرالله أنّه ما زال يردع، رغم كل الانتكاسات، أنّه ما زال محميّاً من الخطوط الحمراء التي نسجها بدقّة على مدار السنوات. فقرّر الدخول بحربه الأخيرة ليستشهد على مذبح فلسطين.
صناعة الأيقونة
لكنّ السياسة لا تخضع للمنطق الأدبي للأيقونات وتراجيديّتهم. هي تصنعهم قبل أن تقتلهم.
من أجل بناء هذه الأسطورة، سقط العديد وقبِل العديد بسقوطهم مقابل التمسّك بوعد أن زمن الهزائم قد ولّى. بدايةً مع الشيوعيين ومقاومتهم المتهاوية وسنة استهدافهم، 1987، واحداً تلو الآخر. ومن بعدهم، الاعتراض الشيعي الذي تمّ قمعه لعقود، بينما كانت مؤسسات الحزب تعيد تشكيل أسس الطائفة. كان هذا ليمرّ في لبنان لكون هذا العنف محصوراً ضمن الحدود الطائفية، لكن مع اغتيال الحريري ومن ثم عدد من المثقفين والسياسيين، بدأ ثمن هذه الأيقونة يظهر، ليخرج المكبوت العنفي إلى العلن في أحداث 7 أيار، هذا «اليوم المجيد» كما سمّاه نصرالله.
كان من الممكن القبول بكل هذا على طريق تحرير فلسطين، وقبل كثيرون به فعلاً. ثمّ جاءت الحرب السورية، ودخول حزب الله فيها حماية للنظام البعثي والمشاركة بما يشبه الإبادة هناك. حصار، تجويع، تعذيب، قتل. وفي كل هذه المحطات، كان نصرالله هو الذي يبرّر: «تكفيريين»، «خطوط إمداد المقاومة»، هذا إن لم يكن يتهكّم: «ما في شي بحمص». الأيقونة لا تتهكّم، الغطرسة تتهكّم. بدءاً من هذه اللحظة، بدأت الصورة تتفتّت إلّا عند البيئة القريبة. فبات نصرالله حامي النظام السياسي والاقتصادي المنهار في لبنان، يخطب بفنّ الاقتصاد المنزلي أو يحذّر من «الشذوذ».
كان السابع من أكتوبر تاريخ عودته إلى ملعبه المفضّل. ولسنة كاملة، عاد إلى دوره كأيقونة المقاومة، وإن كان متعبًا ومنهكًا من سنوات الغطرسة. لسنة كاملة، أدرك هذا المقاوم العقلاني أنّ الفخ بات يضيق عليه، والمحاور تفاوض من حوله، ومكتسبات الـ2000 والـ2006 باتت مهدّدة. لكنّه استمرّ. وفي خطابه الأخير، ظهر كمَن يدرك أن أيامه باتت معدودة، وأنّ الزمن الذي صنع الأيقونات يمكن أن يتخلّص منها أيضًا.
الأيقونة وصناعتها في آن
يمكن فصل هاتين الروايتين عن هذه الشخصية، كما نشهد اليوم، والتمسّك بواحدة على حساب الأخرى. ولمحبّي التبسيط، ليس هناك إلّا رواية واحدة. هو الأيقونة التي لم تخطئ، أو هو الخاطئ الذي سرق فلسطين لصالح إيران. وربّما كانت لحظة الاغتيال مناسبةً لتبسيط أسطوري على حساب التعقيد الإنساني. وقد شهدنا نماذج من هذه الأسطرة بعد كل اغتيال، فتحوّل بشير جميل إلى الرئيس اللبناني الذي أغضب الإسرائيليين بلبنانيته، أو رفيق الحريري الذي تحوّل إلى المدافع الأول عن سيادة لبنان. وفي أدبيّات الطوائف، الأسطرة هي المساحة المتاحة لطائفة الشهيد لبناء رواية عن نفسها، بعدما تأكّدت الطوائف الأخرى من زوال الخطر.
لكن إذا تمسّكنا بهاتين الصورتين، لن نصل إلى أجوبة، بل إلى المزيد من الأسئلة، أسئلة ستبقى معنا حتى بعد اغتياله. وقد يكون سؤال نصرالله عن هذا الترابط بين الروايتين، بين الدفاع عن قضية كفلسطين والعنف الذي تمّت ممارسته من أجلها، عن إسناد قضية محقة من بلد لا يحتمل أي خضّة، عن هذا التناقض الذي ميّز العالم العربي منذ حرب العراق الأولى بين خيار معاندة الاحتلالات الخارجية وخيار مقاومة القمع الداخلي، عن المحاور التي تحيط بنا والفراغ السياسي خارجها، عن عنف هذه المحاور بإسم فلسطين.
مثّل نصرالله هذه المعادلة، وصولًا إلى لحظة استشهاده في سبيل إسناد غزة. لكنّه لم يخرج منها. ربّما كان شخصيتها الأبرز، لكنّه لم يستطع الخروج منها. فثبّتها انتصاراً تلو الآخر، واغتيالًا تلو الآخر، حتى بات العنف هو المعادلة.
القاتل ولحظة قتله
لم تغتَل إسرائيل نصرالله في لحظة فراغ سياسي. قتلته في لحظة إبادة في غزّة واجتياح في لبنان وبوادر حرب إقليمية. قتلته في لحظة إعادة تشكيل للشرق الأوسط بالدم والقتل والذبح، مدعومة من تحالف دول مطبّعة، يتضح يومًا بعد يوم، أنّها تتشارك مع إسرائيل هذا الشرق الأوسط الجديد. لحظة القتل لا تغيّر تقييم مسيرة الضحية، لكنّها تفرض قراءة سياسية مختلفة، كما مع الاغتيالات التي سبقتها. لحظة اغتيال نصرالله هي لحظة الحرب علينا، حرب من الواضح أنّها ستدوم، وستصبح هي صانعة مستقبلنا، مهما كان سبب إطلاقها. هناك آلة قتل انطلقت، ولا يمكن تجاهلها بعد اليوم.
كذلك لا يمكن تجاهل أنّ الاغتيال جاء في لحظة توترات طائفية، مدعومة من انهيار اقتصادي، تشكّل بيئة حاضنة لاقتتال طائفي. هنا أيضًا، لحظة القتل لا تغيّر تقييم مسيرة الضحية التي شاركت في هذا التوتر الطائفي، إن لم تكن قد فجّرته أحياناً. هنا أيضًا، اللحظة لا تغيّر التقييم، لكنّها تفرض علينا قراءة سياسية مختلفة، تبدأ من هذا الواقع الطائفي للاعتراف بحدود الممكن في هذا البلد. فالسياسة عندنا ليست سياسة أحلام، هي مجرّد سياسة تفادي الكوابيس وتكرارها.
وهذا يبدأ بمقاربة مسيرة نصرالله بمنطق مختلف عن التبسيط الذي اعتدنا عليه في العقود الأخيرة.