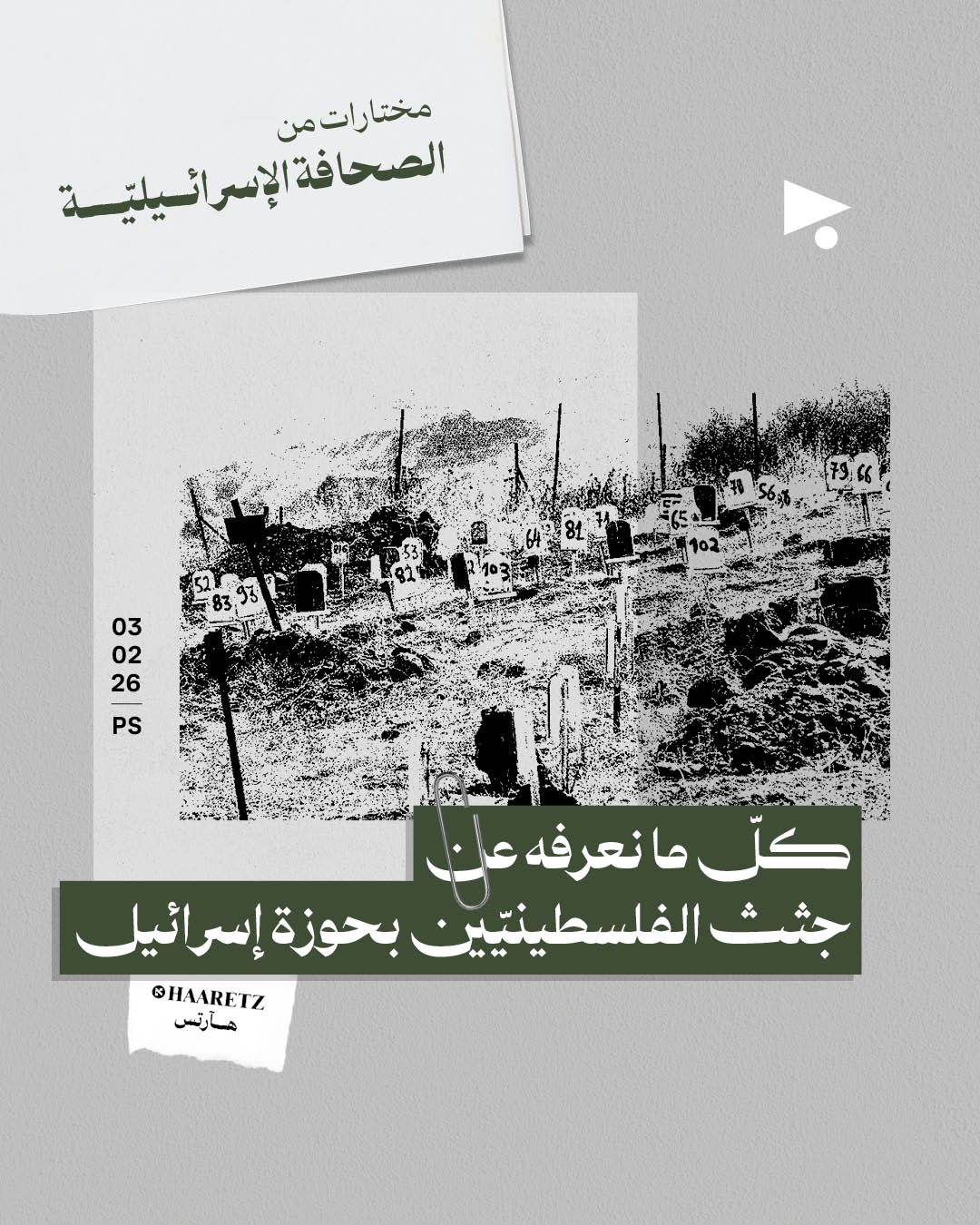مُتغيِّر جديد بعد زمن المحاصصة
أظهرت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة مدى قوّة كل من القوى التقليدية ضمن الخريطة الجغرافية السياسية للطوائف. لكنها أظهرت أيضاً محدودية كل طرف على المستوى الوطني الشامل. هذه النتيجة ليست جديدة. فغالباً ما كانت القوى التقليدية متفوّقة في بيئتها، لكنها ذات محدودية وطنية لا يمكن إنكارها داخل نظام قائم على تشارك السلطة بين الطوائف أو نظام ما يسمى بالديمقراطية التوافقية.
كانت هذه المعادلة في السابق تقود إمّا الى حكومة وحدة وطنية، أي حكومة محاصصة وتقاسم مغانم الدولة، أو إلى تعطيل مؤسّساتي ودستوري. وفي الحالتين، كانت الأضرار جسيمة، أو بالأحرى كارثية مع الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي الحالي.
بيد أنّه مع انتخابات 2022، فرض متغيّر جديد نفسه على القوى التقليدية الفائزة، وهو دخول قوى جديدة إلى المجلس، منبثقة من الحركة الاحتجاجية. ستمتلئ ساحة النجمة من الآن فصاعداً ببضعة نواب ثوريين فعلاً، وليس ثوريين مزعومين كأولئك الذين تمّت فبركتهم في أروقة أجهزة الاستخبارات البعثية، في زمن الاحتلال السوري. ومن شأن هذا المتغيّر أن يخلط الأوراق داخل السلطة السياسية. فوجودهم ككتلة أو كعدّة كتل، سوف يلقي بثقله على الأجندة السياسية العامة والبرلمانية، ويشكّل عامل ضغط على القوى التقليدية.
إحراج مستمرّ للقوى التقليديّة
قد لا يتمكّن النوّاب المتحدّرون من الحركة الاحتجاجية، من تحقيق أهداف مأمولة في مجال الإصلاحات مثلًا أو في مجال تحفيز منطق دولة القانون، أو تحقيق العدالة الاجتماعية أو تكريس السيادة الوطنية أو المحاسبة… لكن مجرّد تمكُّنهم من إحراج القوى التقليدية، من داخل البرلمان هذه المرة، يشكّل بحدّ ذاته إنجازاً من المفترض أن يعزّز لاحقاً وضعية وشرعية القوى الجديدة.
إنْ أمعنت الأحزاب التقليدية بالتعطيل، فهذا سيؤدي إلى المزيد من النقمة الشعبية. وإن توافقت على حلول معادية للطبقات الشعبية، مثل بيع أصول الدولة أو التهرّب من محاسبة المتسببين بالانهيار، فسوف تجد نفسها أمام تجدّد ضغط الشارع والحركة الاحتجاجية، المعززة هذه المرة بانتصارها البرلماني والسياسي.
قد تضطر القوى التقليدية إلى تسهيل العملية الإصلاحية، ربّما لتفريغها من معانيها. لكنّ ذلك لن يرضي المواطنين الذين لن يقبلوا إلّا بوضع حدّ للغنائمية والزبائنية والنفعية ومحاباة الأقارب والفساد في الدولة اللبنانية. فالأمر لا يتعلّق بإصلاحات سطحية، بل بتحديث للسلطة، وتحويلها من دولة هشة إلى دولة قوية، أي دولة قادرة على ضمان الأمن والإستقرار واحتكار قرار الحرب والسلم، وقادرة على بناء اقتصاد قوي وتوفير الرعاية الاجتماعية للسكان.
لا يتنافى ذلك مع طبيعة تكوين الأحزاب والزعامات التقليدية بوصفها قوى سلطوية فحسب، بل يؤدّي أيضاً إلى الحدّ من قدرتها على استغلال مغانم الدولة لبناء شبكاتها الزبائنية التي تتيح لها إعادة إنتاج هيمنتها وتجديد شيء من شرعيتها. تواجه القوى التقليدية إذاً معادلة سياسية غير ملائمة، فرضتها الحركة الاحتجاجية، وهي معادلة «خاسر-خاسر».
هذا إن لم تذهب القوى التقليدية إلى خطاب شد العصب الطائفي والتحريض الغرائزي للخروج من مأزقها، أي إشعال حرب أهلية لعرقلة ما يشهده البلد من عملية ولادة البديل.
معركة ترتيب الأولويّات
يبقى الرهان على الشارع، وكذلك على السياسة الاتّصالية والإعلامية التي أثبتت فعاليتها في الحرب ضد تحالف المافيات المصرفية والقوى الميليشياوية والبيوتات السياسية ورجال الأعمال الفاسدين. ستكون السياسة الاتصالية للقوى الاحتجاجية محكومة هذه المرة بصورة جديدة مركّبة. فأي حوار بنّاء مع ممثلي القوى التقليدية في البرلمان ليس من المحرمات، بشرط أن ينجح نواب الحركة الاحتجاجية في فرض أولوياتهم الإصلاحية على الخصوم وليس العكس. وكلما ساهمت السياسة الاتصالية للقوى الاحتجاجية في ترتيب الأولويات في الحياة السياسية اللبنانية من الآن وحتى عام 2026، سيتقلّص حتماً الهامش المتاح أمام القوى التقليدية لفرض الفتنة ومشروع الحرب الأهلية.
فالأولوية كانت وستبقى للقدرة الشرائية والخدمات العامة، الصحية والتعليمية، وتأمين الدولة للمياه والكهرباء، وحل مشكلة النفايات والنقل العام، وحماية البيئة من كل أشكال التلوث. الأولوية للمحاسبة والمساءلة ومنع لصوص الجمهورية من الإفلات من العقاب. والأولوية لاستعادة سيادة الدولة ليس بطريقة جزئية، كما تريد قوى 8 و14 آذار «نصف-السيادية» على حد سواء. بل بطريقة كاملة، فلا يكون لبنان مرتهناً لإيران، ولا خاضعاً للسعودية وفرنسا وأميركا، أو متنازلاً عن حقوقه في الغاز والنفط لإسرائيل.