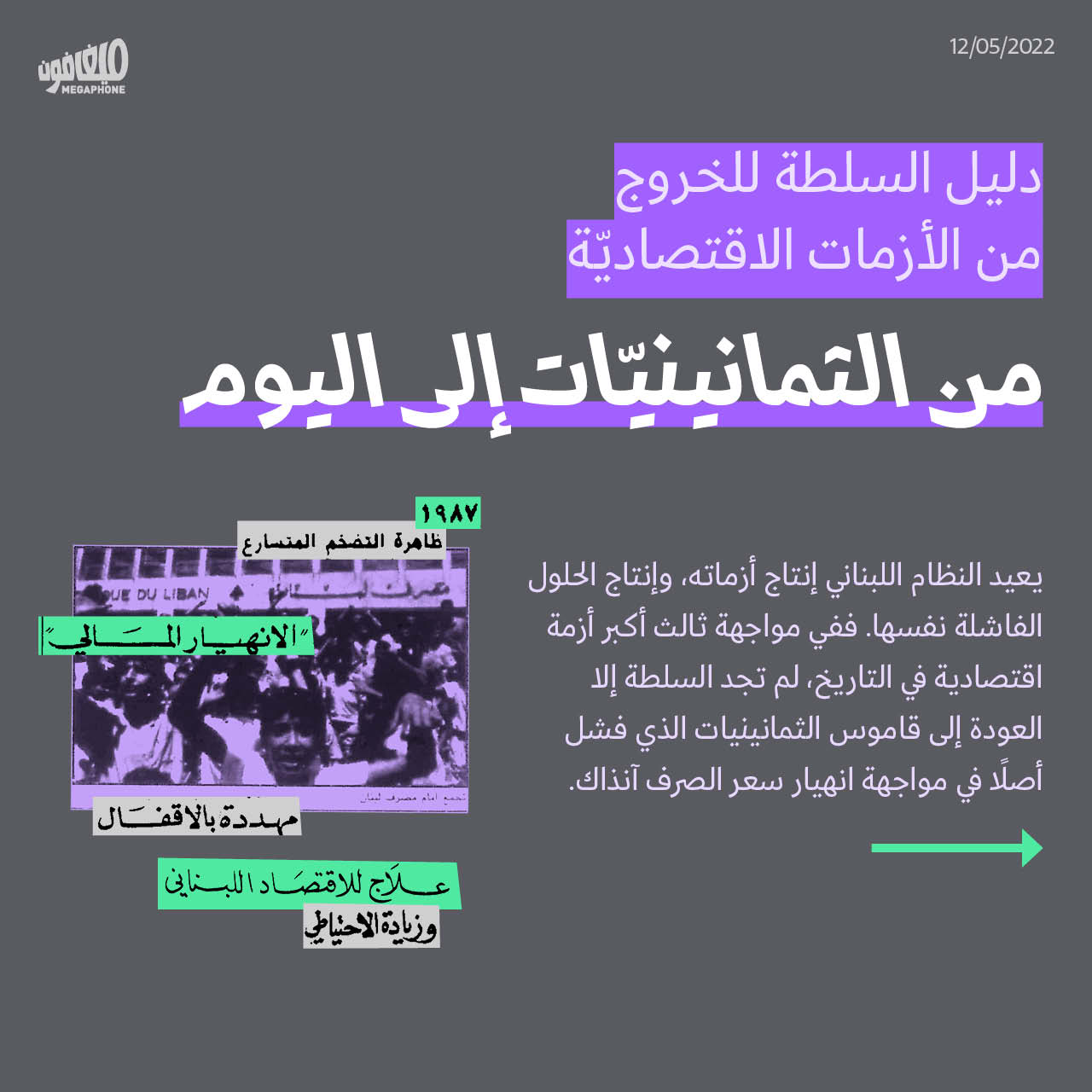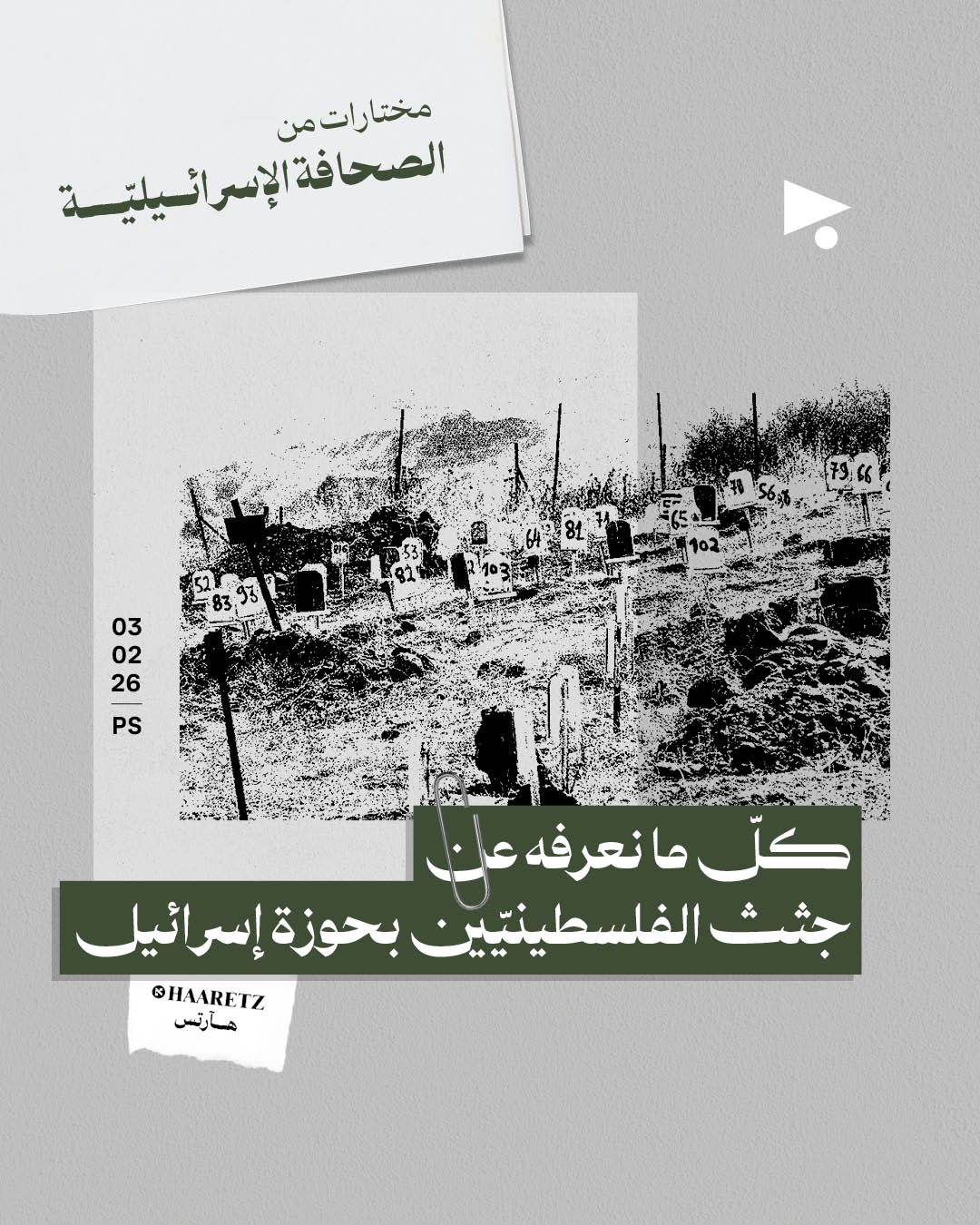من يعود لأرشيف الثمانينيّات قد يعتقد أنّه يتابع أحداث السنوات الأخيرة، سواء في شكل الأزمة أو الحلول المقترحة من قبل السلطة السياسية. فرغم الاختلاف بين الأزمتين، تعود الاقتراحات نفسها لتؤكد أنّ النظام اللبناني يؤسس للأزمات من خلال تكرار حلول «الترقيع» التي لا تنجح إلّا بتأسيس لجولة جديدة من الانهيارات.
أزمات عديدة، حلّ واحد
قد تبدو الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية شبيهة بالأزمة التي عرفها لبنان في منتصف ثمانينيّات القرن الماضي. لكنها في الواقع تختلف من حيث الأسباب وحجم التداعيات. فلبنان الثمانينيّات شهد تدهوراً لسعر الصرف رافقه تضخّم هائل انعكس على معيشة اللبنانيين، فيما لبنان اليوم يعاني من إفلاس المصرف المركزي والمصارف وانهيار سعر الصرف.
لكن رغم الاختلاف بين الأزمتين، هناك أوجه شبه، تكمن في الأساليب والطروحات التي يبتدعها النظام بهدف الهروب من تحمّل المسؤولية وتطبيق إصلاحات جذرية. ففي الحالتين، كانت السمة الرئيسية لسياسات النظام «الترقيع» الذي يسعى لشراء الوقت وتمييع المطالب. فالنظام اللبناني يواجه اليوم ثالث أكبر أزمة اقتصادية في التاريخ، حسب تقرير للبنك الدولي، بالسياسات نفسها التي واجه فيها انهيار سعر الصرف في الثمانينيّات، من أزمة الدواء إلى رفع الدعم وصولاً إلى البطاقة التموينية.
لا تسعى هذه المقالة إلى المقارنة بين أزمة الثمانينيّات والأزمة الحالية من حيث الأسباب والانعكاسات المباشرة على الاقتصاد والمجتمع. بل تحاول الإضاءة على طريقة تعاطي السلطة مع أزماتها الاقتصادية البنيوية، وبالتالي على طابع النظام كنظام إعادة إنتاج الأزمات، أي نظام يواجه أزمة راهنة من خلال التأسيس لأزمة جديدة. فالمجتمع بالنسبة لهذا النظام ليس أولوية وهو ما يدفعه لوضع سياسات تحمي أركانه ومصالحه ليس إلّا.
إنّه نظام يكرّس الأزمة بدلاً من معالجتها، ولعلّ سياسات الدعم التي اعتمدها منذ ما قبل الحرب الأهلية (1975-1990) هي أبرز مثال على ذلك.

دوّامة الدعم ورفعه
لم تعتمد حكومات لبنان تاريخيًا أي سياسة دعم تساهم في حماية وتعزيز الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها، رغم الوعود بالتدخّل من قبل بعض الحكومات.[1] فحتى عند اشتداد الأزمات، كحال أزمة الثمانينيّات أو الأزمة الحالية، رفضت السلطات اللبنانية التدخّل بحجّة عدم المسّ بالاقتصاد الحر الذي يعتبر من أسس النظام اللبناني. فبدل أن تدعم الدولة اللبنانية الحق في الصحة من خلال تأمين تغطية صحية شاملة، وفي التعليم من خلال تأمينه لجميع السكان، وفي حماية الأجور وتعويض البطالة والسكن والغذاء والتنقّل، اتّجهت، لمواجهة الأزمات الاجتماعية، نحو سياسات دعم السلع والمحروقات والدواء، وهو ما استفاد منه المحتكرون وقلّة من اللبنانيين.
وهذا ما يُدخِل الاقتصاد في دوّامة الدعم ورفعه، غالبًا بعد مراحل من الابتزاز الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي. فالسلطة عمدت عن سابق تصّور وتصميم إلى اعتماد خيار دعم السلع بدل وضع سياسات دعم مستدامة لقطاعي النقل والصحة وللغذاء. وهي بالتالي سعت إلى إبقاء الاقتصاد مأزوماً، يخرج من كارثة ليدخل أخرى، وذلك بهدف حماية نظام الاحتكارات والحفاظ على نظام الزبائنية.
ولعلّ أبرز الأمثلة على فشل الدولة في حماية المجتمع تكمن في مسألتَيْ رفع الدعم عن البنزين والدواء.

1. رفع الدعم مقابل تأمين البنزين
كلّما واجهت أزمة مالية، تعمد الحكومات إلى رفع الدعم عن المحروقات، باعتباره الحلّ الأسرع والأنسب لها وللمحتكرين، بغض النظر عن تبعاته الاجتماعية والاقتصادية. فقد رفعت الحكومة الدعم 11 مرة عن المحروقات منذ العام 1976 وحتى حزيران 1987.[2] وبلغت نسبة ارتفاع أسعار المحروقات منذ 1984 حتى 1987 حوالي 300%. وسبق رفع الدعم عام 1987 رفع تدريجي لأسعار المشتقات النفطية بعد افتعال أزمة محروقات وإجبار اللبنانيين على الانتظار ساعات في الطوابير للحصول على البنزين،[3] فيما لجأ البعض إلى شراء الغالونات في السوق السوداء بعد إقفال المحطات عمداً وتوقّفها عن التوزيع.[4] وعمد وزيرا المال كميل شمعون ومن ثمّ جوزيف الهاشم والصناعة والنفط فيكتور قصير إلى قيادة حملة رفع الدعم، مبرّرين ذلك بتخفيف الضغط عن الليرة وسد العجز في صندوق المحروقات ووقف التهريب إلى الدول المجاورة والتخزين والتجارة في السوق السوداء.[5]

مقابل رفع الدعم، وعدت الحكومة بالعمل على زيادة الأجور وتأمين النقل المشترك والاستشفاء المجاني ودعم التعليم وإعادة إحياء البطاقة التموينية.[6] فأعلن وزير العدل والموارد آنذاك نبيه بري أنه يؤيد رفع الدعم عن البنزين شرط أن يتأمنّ أولاً التأمين الصحي الكامل والكتب ومجانية المدارس.[7] لم يتمّ تنفيذ أي من هذه المشاريع، واكتفت السلطة بإطلاق الوعود بإنجاز مشروع البطاقة التموينية الذي طال انتظاره، وبوضع بعض الباصات في الخدمة، والسماح لصندوق الضمان الاجتماعي باستيراد الأدوية. خرجت أصوات حينها أبرزها لرئيس الاتحاد العمالي العام أنطوان بشارة تهاجم سياسة الدعم التي اعتمدتها الدولة، معتبرةً أنها تخدم الأغنياء والمحتكرين على حساب الفقراء[8]، وتستنزف أموال الخزينة التي من المفترض توظيفها لتحفيز الاقتصاد.[9]
وكما في عام 1987، بدأت حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب بتهيئة الأرضية لرفع الدعم عن المحروقات مع نهاية العام 2020 بعد رفعها عن المواد الغذائية تباعاً. ارتفعت أسعار المحروقات تدريجياً بحجة وقف التهريب إلى سوريا والتخزين في الشركات ولدى أصحاب المحطات منتصف عام 2021. أوكلت إلى الجيش مهمة مداهمة المستودعات والإفراج عن المواد المخزّنة. لم تعرف حتى اليوم حصيلة تلك المداهمات من توقيفات وأحكام، كما لم يتمّ تحديد كيفية توزيع الكميات المصادرة اكتفت بيانات قيادة الجيش بالإشارة إلى أنه سيتمّ توزيع المواد المصادرة إلى مستشفيات وأفران المنطقة. ازدادت في هذه الأثناء أحجام الطوابير، حيث اضطر المواطنون إلى الانتظار نهاراً كاملاُ أحياناً للحصول على البنزين. وإزاء هذا المشهد، والضغط المتواصل على الناس للوصول إلى المحروقات، بدأت تعلو الأصوات المطالبة برفع الدعم نهائياً؛ منها أصوات رسمية على لسان وزير المال غازي وزني الذي أقرّ بأنّه لم يعد بإمكان لبنان الاستمرار بوتيرة الدعم نفسها، ومنها حزبية حيث أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى ضرورة رفع الدعم عن المحروقات لأنه يذهب إلى سوريا، ومنها شعبية إذ ظنّ الناس أن مأساتهم أمام المحطات سوف تنتهي مع رفع الدعم.
وبالفعل، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 11 آب 2021 رفع الدعم عن المحروقات دون أي إنذار مسبق، في الوقت الذي كانت تَعِد به حكومة تصريف الأعمال بترشيد الدعم وبعدم اتخاذ أي إجراء قبل تأمين بديل للبنانيين، سواء عبر البطاقة التموينية أو عبر السعي إلى تفعيل النقل المشترك. حاول الجميع التبرّؤ من القرار وتحميل سلامة وحده المسؤولية خوفاً من ردّة الفعل الشعبية، في حين لم يحرّكوا ساكناً للرجوع عنه. وأكد الرئيس نجيب ميقاتي بعيد تشكيل حكومة جديدة في 10 أيلول 2021 الإسراع في إقرار البطاقة التموينية وتأمين باصات للنقل. لكنّ البطاقة ما زالت في انتظار التمويل، بينما تمكّنت وزارة الأشغال من الحصول على 50 باصاُ بهبةٍ فرنسية تنتظر شحنها إلى لبنان. لم يحلّ رفع الدعم معضلة تأمين المحروقات تماماً، إذ تطلّ أزمة جديدة كل فترة، تارةً تحت عنوان عدم إعطاء مصرف لبنان الدولارات المطلوبة للمستوردين، وتارة أخرى بحجة عدم تمكّن المحطات من الدفع بالدولار للشركات المستوردة.
يتّجه مصرف لبنان إلى وقف إعطاء الدولار للمستوردين بعد انتهاء الانتخابات النيابية، وبالتالي سيدفع إلى بيع البنزين بالدولار على المحطات، ما سيؤدّي إلى أزمة محروقات خطيرة. فالدوامة مستمرة، والمستفيدون منها أصحاب مصالح ونفوذ.
يُظهر ذلك كيف اختارت حكومات ما بعد الحرب العودة إلى سياسات الدعم العبثية وغير العادلة مكرّسةً الدولة الريعية على حساب دولة الرعاية. تصبح الصورة أوضح عندما يتبيّن أنّ 13 شركة تسيطر على استيراد المشتقات النفطية، وهي تمتلك أكثر من نصف المحطات في لبنان، ومعظمها مملوك أو مدعوم من قبل السلطة السياسية.
وكما في المحروقات، كذلك في الدواء.
2. الأدوية مفقودة والقطاع الصحي في العناية الفائقة
يحتكر خمسة مستوردين أكثر من نصف سوق الدواء في لبنان. وتُعدّ فاتورة الأدوية في لبنان من الأعلى في العالم، وتشكّل 44% من مجمل الانفاق الصحي. جرت عدة محاولات لكسر سيطرة المحتكرين، أبرزها تجربة وزير الصحة في حكومة صائب سلام إميل بيطار (1970-1972). حاول هذا الأخير استيراد الدواء عبر صندوق الضمان الاجتماعي والدولة. وقف المستوردون في وجهه، فقطعوا الأدوية من الصيدليات، ونجحوا في دفعه إلى الاستقالة. ولاحتواء النقمة، أعلنت الحكومة إنشاء المكتب الوطني للدواء عام 1972 والتي كانت مهمته استيراد الأدوية لصالح الجهات الضامنة وبيعها مباشرة إلى المرضى، أو اللجوء إلى استيراد الأدوية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انسجاماً مع الصلاحيّات الممنوحة له قانوناً. بقيَ المشروع حبراً على ورق رغم الوعود المتكرّرة بتفعليه، وكان آخرها خلال أزمة الثمانينيّات ثمّ خلال الأزمة الحالية.

عام 1986، أعلنت نقابة مستوردي الأدوية تجميد أسعار الأدوية حتى نهاية العام، مقابل وقف الملاحقات بحق المستوردين والوكلاء والصيادلة، بتهمة مخالفة الأسعار الموضوعة من قبل وزارة الصحة.[10] نقلت جريدة «السفير» أنّ ضغوطاً سياسية ورسمية عدّة مورست تجاه القضاة لمنعهم من الاستمرار في التحقيق ولإطلاق سراح الموقوفين. [11] نتيجة ذلك، اختفت معظم الأدوية من الصيدليات [12] بحجة صعوبة استيرادها وتوزيعها بسبب الأوضاع الأمنية وتخزين المواطنين لها خوفاً من انقطاعها.[13] جرت بموازاة ذلك عدّة محاولات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدعوماً من قبل الاتحاد العمالي العام والاتحاد الوطني للنقابات للسماح للصندوق باستيراد الأدوية ولإعادة تفعيل المكتب الوطني للدواء. إلا أنها باءت جميعها بالفشل بعد تصدّي المستوردين والوكلاء لها.
في بداية عام 1987، رُفِع قرار تجميد الأسعار، فعادت الأدوية لتظهر في الصيدليات بارتفاعات في أسعارها فاقت الـ400% [14]. وانعكست الأزمة أيضاً على المستشفيات الخاصة والحكومية على حد سواء، وأعلن عددٌ منها اضطراره للإقفال في حال عدم تدارك الوضع. وكانت أبرز المشاكل التي عانت منها المستشفيات، حسب نقيب أصحاب المستشفيات آنذاك فوزي عضيمي: عدم قيام وزارة الصحة بدفع المستحقات المتوجبة عليها؛ الشكوى من فقدان المحروقات وتقنين الكهرباء والمياه؛ هجرة الأطباء؛ ازدياد عدد المرضى العاجزين عن تسديد فواتيرهم؛ غياب الدعم الخارجي وعدم القدرة على شراء الآلات المتطورة. اعتبر عضيمي أن استمرار الأزمة يعني أننا سنقفل مستشفى لنفتح جبّانة[15].
وبالانتقال إلى العام 2021، كشفت الإحصاءات أنّ 40% من الأسرّة في المستشفيات باتت فارغة بسبب عدم قدرة اللبنانيين على تحمّل تكاليف الاستشفاء، فيما تعاني المستشفيات لتأمين الكهرباء بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار المحروقات وفي ظلّ انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي. وقد انعكست الهجرة على القطاع بعد مغادرة 40% من الأطباء و30% من الممرّضات والممرّضين حسب منظمة الصحة العالمية. فيما يزداد النقص في المعدات الطبية بعد رفع الدعم عنها. وقد حذّر نقيب أصحاب المستشفيات الحالي سليمان هارون بأنّ الاستشفاء سيصبح «متوفّراً للأغنياء فقط».
في مقابل ذلك، يعاني اللبنانيون من أزمة دواء هي الأصعب في تاريخ لبنان. فُقِدَت الأدوية من الصيدليات خلال عام 2020 وعزا المستوردون ذلك إلى عدم تمكنهم من استيراد الأدوية بالدولار مع انهيار سعر الصرف، وإلى تخزين اللبنانيين للأدوية في منازلهم. تحرّك وزير الصحة في حكومة حسان دياب حمد حسن واعداً بالاقتصاص من كل مستورد محتكر. بدأ مسلسل المداهمات المنقولة مباشرة على الهواء. تمّ توقيف بعض أصحاب الصيدليات والمخازن. أُفرِجَ عنهم واحداً تلو الآخر، وآخرهم محتكر مقربّ من حزب الله، الذي عيّن حسن في الحكومة.
ثمّ راحت ترتفع الأصوات المطالبة برفع الدعم عن بعض أصناف الأدوية. مع اشتداد الأزمة وعجز الحكومة في مواجهة المحتكرين، رُفِع الدعم عن الدواء في 9 تشرين الثاني 2021 باستثناء أدوية الأمراض المستعصية وبعض أدوية الأمراض المزمنة. وعلى الرغم من ذلك، ما زالت الأدوية مفقودة في الصيدليات، فيما يعجز مرضى السرطان عن تأمين علاجاتهم منذ أشهر. والسبب هذه المرة عدم تحويل الأموال اللازمة من مصرف لبنان وعدم دفع هذا الأخير المستحقات المترتبة عليه للمستوردين. يتحكّم هؤلاء بالسوق فيما تتفرّج الدولة على معاناة الناس، إذ يعترف وزير الصحة الحالي فراس أبيض أن على الدولة إعادة النظر في السياسات الصحية المتّبعة، لكنه في المقابل ينصاع لضغوط المحتكرين، فيقف شاهداً على الموت البطيء للبنانيين دون اتخاذ أي إجراء فعلي يجبر الشركات على تأمين الأدوية، أو ينهي سيطرتها على السوق من خلال تدخل الدولة، إن عبر الضمان الاجتماعي أو المكتب الوطني للدواء.
البطاقة التموينيّة: مشروع قَدَره الأدراج

وأمام اشتداد الأزمة، ومنعاً لتعاظم التحرّكات في الشارع، عمدت السلطة إلى طرح سلسلة من الإجراءات زعمت أنها بداية للحلّ، لكنّها كانت مجرّد وسيلة أخرى لشراء الوقت.
عندما تمّ طرح البطاقة التموينية للمرة الأولى من قبل حكومة الرئيس حسان دياب ثمّ إطلاقها رسمياً بعد تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اعتقد اللبنانيون أنّ المشروع مستحدث خصيصاً لحمايتهم من تداعيات رفع الدعم على المحروقات والدواء. لكن في الواقع، أبصرت البطاقة النور للمرة الأولى قبيل بداية الحرب الأهلية عام 1975، ليبدو هذا «الحلّ» أقرب إلى «ترقيعة»، ترمى إلى الرأي العام لتبرير رفع الدعم.
ارتفعت آنذاك أسعار السكر الذي كان من السلع المدعومة، بشكل كبير بسبب تهريبه،[16] ما أدّى إلى احتجاجات شعبية ونقابية في بيروت والمناطق. على إثرها، قررت وزارة الاقتصاد استحداث ملاك مؤقت في الوزارة لتنفيذ مشروع أطلقت عليه اسم «البطاقة التموينية» لمدة 3 سنوات بهدف تأمين السلع التي اعتبرتها «استراتيجية» كالأرزّ والسكر والحليب وغيرها بالسعر الذي تحدده الوزارة منعاً لتلاعب المستوردين والتجار. واجه المشروع عرقلات عدّة بعدما تصدّى له المحتكرون بحجة مسّه بالاقتصاد الحر من جهة، والطوائف المسيحية، من جهة أخرى، كونه يحتاج بغية تنفيذه إلى إجراء تعداد للسكان.[17] دُفِن المشروع عام 1979 لكن بَقِيَ جهازه الذي ضمّ حوالي 100 موظف قائماً.
مع بداية الأزمة منتصف الثمانينيّات، طالب الاتحاد العمالي العام وبعض النواب بإعادة إحياء نظام البطاقة التموينية، لكنها أُسقطت مجدداً بحجة نقص التمويل وعدم وجود إحصاء لعدد السكان واستحالة إجرائه بسبب الحرب.
أمّا في الأزمة الحالية، فبعد مماطلة استمرت لأكثر من سنة، أطلق وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الرئيس ميقاتي هيكتور حجار مشروع البطاقة التموينية أو التمويلية (يُعتَمَد الاسمين للتعريف عنها). وجاءت البطاقة ضمن سلسلة مشاريع تحت برنامج «دعم» الذي يتضمّن مشروعين: «أمان» الذي أمنّت تمويله الدولة اللبنانية، و«البطاقة التمويلية» أو ما يعرف بمشروع «حياة». ما زالت البطاقة تنتظر التمويل من قبل البنك الدولي الذي ينتظر بدوره سلسلة من الإصلاحات من قبل الحكومة اللبنانية.
حلول شراء الوقت

في انتظار الإصلاحات والتمويل والتسويات السياسية المحلية والإقليمية، تكرّر السلطة الحلول نفسها التي تعلم أنها لن تُطبَّق في دولة اللا-رعاية، من الدولار الطالبي إلى الدولار الجمركي.
عام 1985، تقدّم النائبان ميشال معلولي ويوسف حمود باقتراح قانون لدعم الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم خارج لبنان بسبب الصعوبات التي باتت تواجههم بعد انهيار سعر صرف الليرة. عُرف الاقتراح آنذاك باسم «الدولار الطالبي»[18] وبقي نائماً في أدراج لجنة التربية النيابية رغم المناشدات المتكررة للطلاب في الخارج،[19] شأنه شأن «الدولار الطالبي» المستحدث عام 2021 بعد تمنّع المصارف عن تحويل أموال أولياء الطلاب في الخارج لدفع أقساط أولادهم.
أقرّ مجلس النواب قانون الدولار الطالبي عام 2021، ولكنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ردّه إلى اللجان مع عدة ملاحظات. عاد المجلس وأقرّه في 29 آذار 2022 مع بند يمنع ملاحقة المصارف بجرم إساءة الأمانة. وما زال أهالي الطلاب ينتظرون تنفيذ القانون بينما تنتظر السلطة الانتخابات لإقرار الموازنة مع مجلس نيابي جديد على جدول أعماله «الدولار الجمركي».

بدوره، ليس «الدولار الجمركي» إنجازاً فريداً لوزير المال في حكومة ميقاتي يوسف الخليل. فعام 1985، اتخذت الحكومة قراراً بخلق «الدولار الجمركي»[20] عبر احتساب الرسوم الجمركية على أساس 6 ليرات لبنانية بهدف التخفيف من سرعة ارتفاع الأسعار والحد من انعكاسات تقلّب سعر الصرف على أسعار المواد الغذائية بشكل خاص. لكنّ المستوردين الذين استفادوا من سعر «الدولار الجمركي» لم يلتزموا بالتسعيرة المفروضة عليهم، بل عمدوا إلى رفع الأسعار بأكثر من 50% بفعل غياب الرقابة، ما أدّى إلى زيادة أرباح التجار وفشل الإجراء وتفريغه من مضمونه.
بعد 37 عاماً على طرح الدولار الجمركي للمرّة الأولى، أعادت الحكومة الحالية في مشروع الموازنة رفع سعر الرسوم الجمركية من سعر الصرف الرسمي السابق 1515 إلى السعر الذي تحدده منصة «صيرفة»، أي أكثر من 20 ألف ليرة. وقد أجّل المجلس النيابي البتّ به إلى ما بعد الانتخابات النيابية خوفاً من تداعياته وتأثيره على خيارات الناخبين.
نجحت تلك الاقتراحات في إيهام الناس بأن السلطة تسعى جاهدةً إلى التخفيف من وطأة الأزمة عليهم. لكنها في الواقع، لم تتقن إلا شراء الوقت، مهما طال، في انتظار انتهاء الآثار الاجتماعية للأزمات، بصرف النظر عن نتائجها.
نظام إعادة إنتاج الأزمات
تختلف الأسباب بين أزمة الثمانينيّات والأزمة الحالية، لكنّ النظام وطريقة تعامله مع الأزمات هو نفسه. يعتمد سياسة الترقيع عينها، ويطرح «مشاريع» فاشلة يعجز أركانه حتى عن تطبيقها. وفي الوقت المستقطع، يستنجد هؤلاء بالغرب والشرق للمساعدة.
لعلّ القاسم المشترك الأوضح بين أزمتي الثمانينيّات والأزمة الحالية هو طبيعة هذا النظام الذي يستمرّ بإنتاج الأزمات عينها، وباعتماد السياسات الترقيعية عينها، وبابتزاز الناس بالوسائل عينها، ليثبت مرّةً تلو الأخرى أنّه وُجِد لخدمة وحماية مصالح المحتكرين وأصحاب المصارف وغيرهم.
يتنصّل أركان هذا النظام دائماً من مسؤولية حتفنا. في الحرب، كان المتّهمون هم الميليشيات وسوريا واسرائيل. في السلم، بات المتهمون إيران والخليج والغرب. اللافت أنّ الخارج المتهم في افتعال الأزمات هو نفسه الخارج الذي يستنجد به هذا النظام في الاقتصاد كما في السياسة. أمّا الواقع، فيبقى هو هو: إنه نظام مجرم يحاصر اللبنانيين، يفجّرهم وينهبهم ويتمكّن في كلّ مرة من الإفلات من العقاب.

يعاني هذا النظام من مأزق منذ نهاية الحرب. فأركانه الذين قاتلوا بعضهم بعضاً خلال الحرب ثمّ عادوا واجتمعوا لحكمه في زمن السلم، يثبتون يوماً بعد يوم عجزهم عن اجتراح الحلول. وعندما تفشل كل الحلول لإصلاح هذا النظام، تعود إلى الواجهة الحلول السحرية، إمّا من خلال الرهان الأزلي على احتياطي الذهب، أو من خلال الرهان الساذج على المغتربين الذين باتوا مطالبين «بتبنّي عائلة لبنانية»، كما اقترح سمير جعجع مرّتين، في 1987 [21] وفي 2020.

* يُنشَر هذا المقال بالتعاون مع مركز الدراسات اللبناني
- باستثناء المحاولة المحدودة لرئيس الجمهورية فؤاد شهاب (1958-1964)
- تجارب رفع الدعم في غياب المعالجة، جريدة السفير، 10 آب 1987
- الضغط المعيشي يفشل في تحريك الوضع الحكومي، جريدة السفير، 17 آب 1987
- نقص البنزين إلى تفاقم وعودة التخزين والبيع بـ«الغالون»، جريدة السفير، 1 آب 1987
- عدنان الحاج، تجارب رفع الدعم في غياب المعالجة، جريدة السفير، 10 آب 1987
- عدنان الحاج، الدولة رفعت الدعم 8 مرات منذ العام 1980، جريدة السفير، 3 آب 1987
- بري: لن نخضع لمحاولات استخدام لقمة العيش لتجاوز الوفاق وإعادة إحياء صيغة 43، جريدة السفير، 23 آب 1987
- الاتحاد العمالي العام يدعو «المتضررين من الحرب» إلى قول كلمتهم في مؤتمر وطني أوائل شباط، جريدة النهار، 15 كانون الثاني 1987
- عدنان الحاج، لمن سياسة الدعم؟ جريدة السفير، 15 شباط 1987
- عدنان الحاج، حتى لا يتشابه اليوم بالأمس، جريدة السفير، 19 تموز 1987
- عدنان الحاج، كارثة الدواء: الأسعار ترتفع 542% منذ بداية العام، جريدة السفير، 25 أيار 1987
- رئيس نقابة الصيادلة يؤكد إقدام المستوردين على إخفاء أدوية، جريدة السفير، 11 كانون الثاني 1987
- رئيس نقابة مستوردي الأدوية يعلن رفع الأسعار وتأمين الأدوية المفقودة، جريدة السفير، 4 كانون الثاني 1987
- عدنان الحاج، وكلاء يرفعون أسعار أصناف الأدوية الرئيسية، جريدة السفير، 19 كانون الثاني 1987
- المستشفيات الخاصة...إلى غرفة العناية الفائقة، جريدة السفير، 24 آب 1987
- هل تفرض الأزمة المعيشية إحياء نظام البطاقة التموينية؟ جريدة السفير، 17 آب 1987
- عدنان الحاج، سياسة الدعم والبطاقة التموينية، جريدة السفير، 25 تموز 1987
- يتيم يطالب بادراج مشروع الدولار الطالبي على جلسة مجلس الوزراء، جريدة السفير، 12 تشرين الأول 1985
- الطلاب اللبنانيون في رومانيا يناشدون المسؤولين إنقاذ مستقبلهم، جريدة السفير، 5 آب 1986
- الدولار الجمركي والإجراءات الموازية، جريدة السفير، 12 نيسان 1985
- جعجع أعلن خطوات إجتماعية لتخطي المرحلة الانتقالية، جريدة النهار، 3 تشرين الأول 1987